خلال تواجدي اليوم في وقفة احتجاجية، سألني أحد الصحافيين سؤالًا يتكرّر كثيرًا في هذه الأيام:
لماذا يعزف الناس عن المشاركة في الوقفات الاحتجاجية؟ وهل فقدوا إيمانهم بالمظاهرات كوسيلة نضالية؟
كان جوابي عفويًا وصادقًا: لسنا في رفاهية الاختيار.
هذا الجواب دفعني للتفكير أكثر. هل بات الاحتجاج عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي هو الشكل الأجدى للتعبير عن الغضب والمطالبة بالحقوق في واقعنا اليوم؟ لا شكّ أنّ أدوات التواصل الاجتماعي، والحملات الرقمية، والوسائل الإلكترونية، أصبحت ذات أهمية في إيصال الصوت، ورفع الوعي، وكسر التعتيم الإعلامي. لكنها، مهما بلغت أهميتها، لا يمكن أن تكون بديلًا عن الحركة الأساسية: الاحتجاج الميداني والتحرّك في الشارع.
في حالتنا، يتحوّل الاحتجاج الإلكتروني مع الوقت إلى نوع من التراخي. نشارك منشورًا، نضع تعليقًا، نضغط “إعجاب”، ونشعر أننا قمنا بالواجب. لكن حين لا يتغيّر شيء في الواقع، يبدأ الإحباط بالتسلّل، ويضعف الإيمان بالقدرة على التغيير. نصل إلى قناعة خاطئة مفادها أنّ لا جدوى من أي تحرّك، لا ميداني ولا سياسي. وهكذا، من حيث لا نشعر، نكون قد بدأنا بالتطبيع مع العجز.
غير أنّ ما نغفله في خضم هذا الإحباط، هو حقيقة أساسية: أهمّ أشكال النضال هو الاحتجاج الميداني. هو الاحتجاج الذي لا نملك رفاهية الاستغناء عنه. وجودنا في الشارع ليس فعلًا رمزيًا فقط، بل فعل توعوي تراكمي، يبني وعيًا جمعيًا، ويؤسّس للحشد، ومن ثمّ للضغط، ومن ثمّ – ولو على المدى الطويل – للتغيير. وهذا أمر أثبتته تجارب الشعوب عبر التاريخ، حيث لم تُنتزع الحقوق من خلف الشاشات، بل فُرضت بفعل الحضور الجماعي، والتنظيم، والاستمرارية في الميدان.
في ظلّ تصاعد الجريمة والعنف في المجتمع العربي، يبرز سؤال مركزي لا يمكن تجاهله:
هل نعيش فعلًا في رفاهية تمكّننا من اختيار آليات الضغط على سلطة نتنياهو–بن غفير، أم أنّ الواقع المفروض علينا يدفعنا إلى حافة الخطر الوجودي؟
نحن لا نواجه سلطة عادية مقصّرة في أداء واجباتها، بل سلطة يمينية متطرّفة، ترى في وجودنا “خطأً تاريخيًا”، وفي بقائنا “عائقًا ديمغرافيًا”، وفي اغتنام الأرض – كلّ الأرض – وهذا التقصير المتعمد وسيلة مشروعة مهما كانت الكلفة. سلطة كهذه لا تنظر إلى الجريمة المستفحلة في مجتمعنا كظاهرة يجب مكافحتها، بل كأداة تخدم أهدافها: تفكيك المجتمع، كسر نسيجه الداخلي، ودفعه إلى الانهيار الذاتي.
العنف والجريمة ليسا قدرًا، بل سياسة. سياسة تقوم على غضّ الطرف، وأحيانًا على التواطؤ، من خلال تقاعس الشرطة، وانتشار السلاح، وغياب المحاسبة. في هذا السياق، يصبح السؤال عن “الآلية الأنسب للضغط” سؤالًا أخلاقيًا وسياسيًا في آنٍ واحد:
هل يكفي الاحتجاج الميداني بصيغته التقليدية، أم أنّ المرحلة تتطلّب احتجاجًا شعبيًا منظمًا، واعيًا، طويل النفس، يربط بين مواجهة الجريمة ومواجهة المشروع العنصري برمّته؟
الخطر الحقيقي لا يكمن فقط في عدد الضحايا، بل في ما تقودنا إليه هذه الحالة: ترانسفير بإرادتنا الذاتية. حين يفقد الناس الأمان، وحين تتحوّل أصوات الرصاص والقتل إلى مشهد يومي مألوف، وحين يصبح الخوف جزءًا من الروتين، يتحوّل الرحيل إلى خيار “منطقي” لدى كثيرين. وهنا تحقق السلطة ما عجزت عن تحقيقه بالقوة المباشرة: إفراغ الأرض من أصحابها، دون أن تطلق رصاصة واحدة!
من هنا، لا يمكن للاحتجاج الميداني أن يكون معزولًا عن الوعي السياسي. ولا يمكننا التطبيع مع مشهد الجريمة، ولا مع العنف، ولا مع الاعتياد على الدم، ولا مع الاكتفاء بمنشور احتجاجي كبديل عن الفعل الجماعي. فالتطبيع مع هذه الحالة، سواء عبر الصمت، أو الاعتياد، أو الاكتفاء بالاحتجاج الافتراضي، هو مشاركة غير مباشرة في إدامتها.
المطلوب اليوم ليس البحث عن راحة أو بدائل سهلة، بل إعادة الاعتبار للاحتجاج الميداني كفعل مقاوم، جذري، منظم، طويل النفس، يربط بين الأمن الشخصي والكرامة الجماعية، بين الحق في الحياة والحق في الأرض، وبين مواجهة الجريمة ومواجهة مشروع الإقصاء.
لسنا أمام خيارٍ بين وسائل متعدّدة، ولا أمام ترفٍ يسمح لنا بالتجريب أو التراجع. الاحتجاج الميداني ليس شعارًا، بل ضرورة وجودية. هو الحدّ الأدنى للدفاع عن حقّنا في الحياة، في الأمان، وفي البقاء على هذه الأرض. كلّ تراجع عن الشارع، وكلّ اعتياد على مشهد الدم، وكلّ اكتفاء بمنشور احتجاجي، هو خطوة إضافية في طريق تفريغ مجتمعنا من قوّته، ومن قدرته على المواجهة.
التطبيع مع الجريمة ليس فقط في الصمت عنها، بل في التعايش معها، وفي قبولها كأمرٍ واقع، وفي تحويل الخوف إلى نمط حياة. والتطبيع مع العنف يبدأ حين نعتاد صوت الرصاص، وحين نبرّر الغياب عن الميدان، وحين نقنع أنفسنا بأنّ “لا شيء يتغيّر”. هذا بالضبط ما تُراهن عليه السلطة: مجتمع مُنهك، خائف، ومفكّك، ينسحب تدريجيًا من الفضاء العام.
لسنا في موقع المتفرّج، ولا في موقع المعلّق من بعيد. نحن بحاجة لأن نكون أكثر وعيًا، أكثر تنظيمًا، وأكثر حضورًا. أن نكون مبادرين لا متلقّين، فاعلين لا مفعولًا بهم.
فإمّا أن نحوّل احتجاجنا الميداني إلى قوة تفرض نفسها على أجندة السلطة، أو نُترك لمصير يُراد له أن يبدو “طبيعيًا”، بينما هو في جوهره أخطر أشكال العنف.
من هنا، فإنّ مسؤوليتنا ليست فقط في الاحتجاج، بل في الاستمرار، والتنظيم، وتوسيع دائرة المشاركة. أن نكون في الشارع رغم التعب، ورغم الإحباط، ورغم القمع. أن نحوّل الغضب إلى فعل جماعي واعٍ، وإلى حضور لا يمكن تجاهله. فالحقوق لا تُستجدى، ولا تُمنح، بل تُنتزع بفعل الإرادة الجماعية.
إمّا أن نكون جزءًا من حركة تقود نحو التغيير، أو نترك الفراغ ليملأه العنف، والجريمة، ومشاريع الإقصاء.
والشارع، اليوم، ليس خيارًا… بل واجبًا.
.png)


.png)






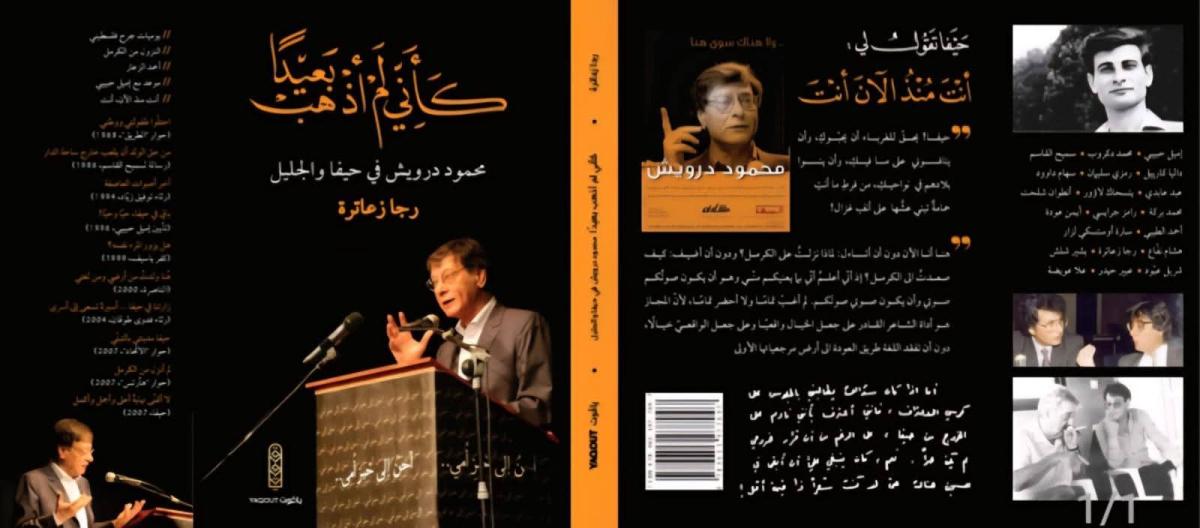
.png)


