قصَّة
كنتُ وعرار جالسين نحتسي البيرة ونستمع إلى صوت فيروز في باحة فندق فيلادلفيا بالقرب من المدرَّج الرومانيّ في عمَّان. ومرَّ إبراهيم طوقان من الرَّصيف الواقع أعلى الباحة، فصاح به عرار:
«أتشرب يا فتى الفتيان كأساً
من البيراء مصفرّ الحواشي»
توقَّف طوقان ونظر إليه وقال باسماً:
«أتدعوني إلى كأسٍ وأنأى
إذاً لا كنتُ شيخاً للعطاشِ»
ثمَّ هبط الدَّرج الصَّغير، وسلَّم وجلس. وبعد ذلك، شرع، هو وعرار، في حديثٍ طويل عن الشِّعر وفلسطين والانتداب البريطانيّ وعصابات الاستيطان الصَّهيونيَّة، بينما كنتُ أنا أنظر ساهماً إلى الجهة المقابلة. وبدا لي أنَّني لم أكن أفكِّر في شيءٍ محدَّد.. سوى أنَّ صوت فيروز كان يأتيني مِنْ مكانٍ قريب: «أنا عندي حنين ما بعرف لمين.. ليليَّة بيخطفني من بين السَّهرانين»، وكنتُ أستمع إليه مسترخياً مع الكلمات المرهفة واللحن المحلِّق. ثمَّ رحتُ أفكِّر بأنَّني حزينٌ جدّاً، ولكنَّني لا أعرف سبباً محدَّداً لحزني.
وجاءت روزا لكسمبورغ، وجلسَتْ تحتسي البيرة معنا وهي تنظر مبهورة إلى الأعلى، وأنا أحدِّق فيها محاولاً أنْ أعرف ما الَّذي كانت تنظر إليه بكلّ هذا الاستغراق وتبدو مبهورة به إلى هذا الحدّ؛ لكنَّني أحببتُ الحيويَّة الَّتي راحتْ تشعّ مِنْ عينيها، وبدا لي كما لو أنَّها أصابتني بعدواها، وما لبِثَتْ أن نظرتْ إليَّ وقالت: إنَّني مبهورة وفرحة، إلى حدٍّ لا يمكنني تصوُّره، بزرقة السماء!
ورحت أنظر معها إلى السَّماء؛ فقالت: يا إلهي! ألا يكفي، لأكون ممتنَّة وفرحة، أن تلمع الشَّمس وأن تغنِّي العصافير أغنيتها القديمة الَّتي أعرف جيِّداً معناها؟!
ثمَّ وجَّهتْ حديثها لثلاثتنا؛ أعني: عرار وطوقان وأنا، وهي تفيض غبطةً ومَرَحَاً؛ قالت: آه أرجوكم، تأمَّلوا هذا النَّهار الجميل. لا تنسوا، وأنتم تجلسون في هذه الباحة، وحتَّى وأنتم مشغولون بهمومكم اليوميَّة، أن ترفعوا رؤوسكم بسرعة وأن تُلقوا، ولو نظرة، على هذه الغيوم الفضيَّة الهائلة وعلى المحيط الأزرق الهادئ الَّذي تسبح فيه.
بدا لي حماسها الزَّائد لزرقة السَّماء غريباً بعض الشَّيء، وفسَّرته لنفسي بأنَّه راجع إلى كونها تعيش في ألمانيا وسط طقسٍ غائم وبارد غالباً. وهبط عبد الرَّحمن منيف مِنْ سيَّارة أجرة، وسأل بدهشة: أليس هنا فندق فيلادلفيا؟!
وعندئذٍ، اختفى الفندق وعرار وإبراهيم طوقان، ووجدتني على رصيف الشَّارع وخلفي ساحةٌ واسعة، وتذكَّرتُ أنَّ فندق فيلادلفيا قد أزيل تماماً مِنْ ذلك المكان، في العام 1987 أو 1988.. لا أذكر بالضَّبط، وأقيمت بدلاً منه ساحة كبيرة مبلَّطة.
بدا الأسف واضحاً على ملامح منيف السَّمراء، عندما أخبرتُه بذلك، وقال مرتبكاً: أنا مدعو مِنْ نادي خريجي الجامعة الأردنيَّة لإلقاء بعض المحاضرات هنا في عمَّان، وقد قيل لي أنَّ إقامتي ستكون في فندق فيلادلفيا، وأنا وُلِدتُ ونشأتُ في عمَّان، وكنتُ أعرف أنَّ فندق فيلادلفيا يقعُ هنا.
وصفن قليلاً، ثمَّ أضاف قائلاً: هذا مؤسف حقّاً؛ فتغييب هذا المكان، غيَّبَ ذاكرة إنسانيَّة ووطنيّة مشرقة. في باحة الفندق الَّذي غُيِّبَ، أتذكَّرُ أنَّ حكومة سليمان النَّابلسيّ أعلنتْ للعالم إلغاء المعاهدة البريطانيّة الأردنيّة الجائرة.
قلت له: لا بأس؛ فهناك فندق جديد يحمل الاسم نفسه، ولا بدَّ أنَّه هو الَّذي ستكون إقامتك فيه.
وأثناء ذلك كنتُ أنظر إلى وجهه مليّاً.
فنظر إليَّ بدوره مليّاً وقال متردِّداً: أرجو المعذرة؛ هل التقينا مِنْ قبل؟
قلتُ: لقد التقينا كثيراً قبل زمنٍ طويل؛ لكنَّني أتذكَّر بشكلٍ خاصّ أنَّنا التقينا ذات مرَّة في «سجن المحطَّة»، وكنتُ آنذاك قد اقتربتُ مِنْ إنهاء نصف مدَّة محكوميَّتي؛ فقلتَ لي مشجِّعاً بأنَّ «النِّصف الثَّاني مِنْ كلّ شيء يمضي بسرعة». لقد بعث ذلك في نفسي الكثير من العزاء والعزم، رغم أنَّه كان قد تبقَّى لي سنوات أخرى يجب أن أمضيها في السِّجن. وبَقِيتْ تلك الكلمات البليغة مطبوعةً في أعماق نفسي حتَّى الآن.
ابتسم لي وبدا مسروراً بكلامي، ثمَّ أوقفتُ له سيَّارة أجرة، وطلبتُ مِنْ سائقها أن يأخذه إلى فندق فيلادلفيا الجديد. شدَّ على يدي وشكرني وصعد إلى السَّيَّارة.
ورحتُ أتمشَّى، أنا وروزا، ومررنا مِنْ أمام مكتبة أمانة العاصمة، ثمَّ قطعنا الشَّارع مِنْ هناك إلى الرَّصيف المقابل. كان الطَّقس ربيعيّاً لطيفاً والشَّارع مزدحماً بالنَّاس الَّذين بدا لي أنَّهم يتعاملون معه باعتباره مجرَّد ممرٍّ فقط؛ إلى مكان العمل، أو إلى البيت، أو إلى موعدٍ ما.. أمَّا روزا وأنا، فكنَّا منشغلين بتأمُّل هؤلاء جميعاً، محاولين أن نتخيَّل بأيَّة أمور هم منشغلون، أو لأيِّ مقصدٍ هم ذاهبون، ومررنا بقرب رجلٍ كان يتحدَّث بهاتفه الخلويّ: نعم؟ كيف؟ نعم! سآتي في الخامسة.. إلى اللقاء.. وداعاً.
وقالت روزا وهي جذلة: ما ألطف هذه المحادثة السَّخيفة! كم يسرُّني أن يصل هذا السَّيِّد إلى مكانٍ ما في الخامسة!
وصاحت بتهوُّرٍ قائلةً للرَّجل: انقلْ تحيَّاتي أرجوك.
نظر الرَّجل إليها مبهوتاً، ثمَّ مضى في طريقه مِنْ دون أن يقول شيئاً. وقلتُ متصنِّعاً البلاهة: إلى مَنْ تريدينه أن ينقل تحيَّاتك؟
قالت متجاهلةً سخريتي المبطَّنة: إلى مَنْ يشاء؛ وخصوصاً إلى مَنْ سيقابله في السَّاعة الخامسة.
ومررنا قرب امرأتين كانتا تحملان أكياساً مليئة بمشترياتهما وتثرثران بينما هما تسيران متمهِّلتين. فقالت روزا: أُنْظرْ؛ إنَّ على وجهيهما تعابير تآمريَّة مألوفة وغامضة.. ومع ذلك فإنَّني أجدهما رائعتين.
وابتسمت امرأةٌ أخرى، كانت تمرُّ بقربنا، لروزا، وراحت تحيّيها بمودّة. ابتسمتْ لها روزا، بدورها، بسعادة طافحة، وحيَّتها بحرارة.
قلتُ لها: أتعرفينها؟
قالت: لا.
وبدا لي عندئذٍ أنَّ غرابة هيئة روزا، بوجهها المشعّ بالسَّعادة ويديها الغارقتين في جيبيها، هي ما شدَّ انتباه المرأة الغريبة إليها وجعلها تحيِّيها كما لو كانت إحدى معارفها.
وقالت روزا: أتوجد سعادة أكبر مِنْ التَّسكُّع هكذا في الشَّارع؛ اليدان في الجيبين، ووردة صغيرة في عروة السّترة؟
وفطنتُ، عندئذٍ، لأوَّل مرَّة منذ لقائنا في باحة فندق فيلادلفيا، إلى الوردة الحمراء الجميلة المثبَّتة في عروة سترة روزا. كانت بسيطة ومنسجمة مع ملامح وجهها المشرقة.
قلتُ لها: أنتِ تفكِّرين وتشعرين وتتصرَّفين هكذا لأنَّكِ قادمة مباشرة مِنْ سجنك في قلعة فرونكه في ألمانيا. لقد ذكَّرتِنِي بما كنتُ أشعر به عندما كنتُ سجينا في سجن المحطَّة في عمَّان؛ كنتُ آنذاك أحلم دائماً بتحقيق رغبات بسيطة؛ مثل أن يُتاح لي السَّير بخطٍّ مستقيم لمسافةٍ طويلة مِنْ دون أن يعترض طريقي جدار؛ ومثل أن أركب سيَّارة أجرة مع أشخاص لا أعرفهم، فأستمعُ إليهم بكسل وهم يتحدَّثون بأمور لا تهمُّني؛ ومثل أن أمشي في شارعٍ مكتظٍّ بالنَّاس بلا هدف ولا مقصد؛ أو أن أجلس مع أسرتي في الأمسيات ونتحدَّث في مواضيع عاديَّة جدّاً.. وأشياء أخرى كثيرة مِنْ هذا القبيل.
قالت: ربَّما يفسِّرُ هذا طريقتي في التَّصرّف؛ فالإنسان في السِّجن يفتقد الحياة العاديَّة الأليفة والرَّتيبة.
قلت: قد يبدو هذا غريباً، لكنَّني، حقيقةً، تعلَّمت أن أتذوَّق الحياة بطريقةٍ عميقة، ومِنْ دون تعقيدٍ، عندما كنتُ في السِّجن. لقد اكتشفتُ آنذاك أنَّ الحياة الحقيقيَّة هي هذه التَّفاصيل البسيطة الَّتي تعودَّنا أن نهملها ونضحِّي بها لصالح ما نتوهَّم أنَّه هو الحياة.. الحياة الَّتي نسعى إلى بلوغها ولكنَّنا لا نبلغها مطلقاً. لذلك، تعلَّمتُ، منذ ذاك، أن أهتمّ بهذه التَّفاصيل، وأمضغها وألوكها على مهل، وأستمتع بمذاقها جيِّداً. فما مِنْ حياة غيرها.
كنَّا آنذاك قد تجاوزنا مكتبة الشَّباب وحلويّات حبيبة، وانعطفنا مِنْ عند الإشارة الضَّوئيَّة الَّتي تليهما إلى اليمين، ودخلنا شارع نيفسكي في سان بطرسبورغ، وما إن سرنا فيه قليلاً حتَّى رأينا فيدور دستويفسكي يسير متمهّلاً وهو يتأمَّل شخوص رواياته المنتشرين في ذلك الشَّارع، ويتفحَّص الأماكن الَّتي يتردَّدون عليها، وحركاتهم، وتصرّفاتهم، وانفعالاتهم. وكان نهر النّيفا بفروعه المتعدِّدة يخترق المدينة مثل متاهة معقَّدة فيقسمها إلى جزر يرتبط بعضها بالبعض الآخر بوساطة جسور كبيرة تنفتح أواخر الليل لتمرّ منها السّفن القادمة عبر خليج البلطيق المحاذي للمدينة.
ثمَّ رأينا ألكسندر بوشكين يجلس في المقهى الَّذي اعتاد أن يجلس فيه وإلى الطَّاولة الَّتي اعتاد أن يجلس إليها. كان مهموماً، وقد انحنى على الطَّاولة، ويده تسند جبهته؛ إذ أنَّه غداً في الفجر سيتبارز مع ضابط فرنسيّ ما مِنْ أجل امرأة ما.
قلت لروزا: أريد أن انصحه بالعدول عن هذه الفكرة السَّيئة؛ فالأمر على العموم لا يستحقّ أن يضحِّي إنسانٌ بحياته مِنْ أجله؛ وخصوصاً إذا كان شخصاً مبدعاً بأهميَّة بوشكين.
قالت روزا: لو كنتُ مكانه لقلتُ لك عندئذٍ:
«نصيحتك يا صديقي رائعة
عليَّ إنْ رغبتُ بالعيش
أن أتخلَّى عن الحياة».
عندئذٍ صرفتُ النَّظر عن هذه الفكرة وتابعتُ سيري.
وعندما وصلنا المحطَّة الفنلنديَّة في بتروغراد* كان فلاديمير إيليتش إليانوف (لينين) قد هبط مِنْ قاطرةٍ مخصَّصة لصيانة السِّكَّة الحديديَّة، ثمَّ سار باتِّجاه السَّاحة الخارجيَّة المحاذية للنَّهر، ووقف هناك يخطب في جموع العمَّال والجنود، داعياً إيَّاهم للثَّورة على حكومة كيرنسكي المؤقَّتة الَّتي تواطأتْ مع بقايا رجالات القيصريَّة.
قالت روزا بانفعال: يمكنك تصوُّر مدى تأثُّري بأحداث روسيا هذه! كلّ هؤلاء الأصدقاء القدامى، الَّذين كانوا منذ سنوات منزوين في السّجون؛ في موسكو وسان بطرسبورغ وأوريل أو ريغا، يتنزَّهون اليوم بحريَّة. لكم يساعدني هذا على تحمُّل مشاقّ اعتقالي! تبدُّلُ مواقعٍ عجيب؛ أليس كذلك؟ إنَّني سعيدة للأمر، وأبارك لهم حريَّتهم، ولو أنَّ «حظوظي» الخاصَّة بالحرّيَّة قد انخفضت بسبب ذلك.
قلت مستغرباً: تتحدَّثين كما لو أنَّكِ لا تزالين في السِّجن!
تلفَّتتْ حواليها وقالت مستغربة هي الأخرى: إنَّني لا أزال في سجن قلعة فرونكه؛ ألستَ ترى ذلك؟!
لم أقل شيئاً، لكنَّني للحقّ حرت في أمرها؛ فهي في السِّجن تتصرَّف بتلقائيَّة كبيرة كما لو أنَّها في بيتها؛ بل إنَّها كثيراً ما استخدمتْ كلمة البيت أو بيتي لتعني بها السِّجن.. وها هي الآن، ونحن نسير معاً في بتروغراد، تتحدَّث وتتصرَّف كما لو أنَّها لا تزال في السِّجن!
واصلنا سيرنا بجوار النّيفا، ومررنا بقرب مدمِّرةٍ بحريَّة كبيرة كانت ترسو في النَّهر، ومن الكلمات المدوَّنة على هيكلها الضَّخم عرفنا أنَّ اسمها «ورورا». وكانت أورورا في تلك اللحظة قد صوَّبتْ مدافعها باتِّجاه قصر الشِّتاء وراحت تطلق نيرانها عليه.
ولم نتوقَّف طويلاً هناك، بل واصلنا سيرنا باتِّجاه قصر الشِّتاء نفسه، وعندما وصلنا إليه، اتَّجهنا إلى ساحته الدَّاخليَّة الواسعة؛ فرأينا عندئذٍ جموع العمَّال والجنود تتدفَّق عبر البوَّابة القوسيَّة الكبيرة والفخمة الَّتي تتوسَّط مبنى الحكومة الضَّخم في الجهة المقابلة، فتملأ السَّاحة، ثمَّ تنطلق باتِّجاه بوَّابة القصر فتفتحها. كانت الحكومة المؤقَّتة مجتمعة هناك، كما علمنا لاحقاً، في قاعة مُطلَّة على النَّهر، وحين بدأ الرَّصاص ينهمر على القصر، انتقلتْ إلى قاعة أخرى داخليَّة، واجتمعت حول طاولة مربَّعة بيضاء صغيرة.
وقالت روزا: دعنا نواصل سيرنا بمحاذاة النَّهر.
فعدنا نسير بمحاذاة النَّهر، وظللنا نتسكَّع على غير هدى في شوارع بتروغراد، إلى أن وجدنا نفسينا في محطَّة للقطارات في موسكو. وهناك فوجئنا بجمعٍ كبير مِنْ أهالي موسكو، وفي مقدِّمتهم كبار مثقَّفيها وأدبائها ورجال الحكومة فيها، وقد احتشدوا على نحوٍ احتفاليٍّ صاخب لاستقبال شخصٍ ما.
استغربنا الأمر، فسألتُ بعض المستقبلين عن الشَّخص الَّذي حضرتْ كلّ هذه الجموع لاستقباله، شاكّاً أنَّه القيصر نفسه على الأرجح.
إلا أنَّ أحدهم قال لي: كلاّ؛ بل هو ليو نيكولايفيتش تولستوي.
عندئذٍ، تبادلنا نظراتٍ مليئةً بالدَّهشة، روزا وأنا، وبدا لنا أنَّنا، بلا شكّ، حيال حدثٍ مهمّ. فتولستوي كان قد امتنع عن زيارة العاصمتين الروسيَّتين؛ موسكو وسانبطرسبورغ، منذ مدَّة طويلة، واعتكف في اقطاعيته الكبيرة؛ ياسنايا بوليانا.
وكان خلال هذه المدَّة نفسها قد أرسل العديد من الرَّسائل الشّجاعة إلى القيصر يدعوه فيها إلى إصلاح الأوضاع الاجتماعيَّة والسِّياسيَّة المتردِّية للشَّعب الرّوسيّ. الأمر الَّذي جعل مثقَّفي النِّظام يشنُّون عليه حملةً شعواء. ومع ذلك، فقد كان هؤلاء أيضاً مِنْ ضمن الحاضرين اليوم لاستقباله. وبدا الحبور طافحاً على وجه روزا عندما عرَفَتْ أنَّ كاتبها المفضَّل قادم إلى تلك المحطَّة.
فقلتُ لها: سمعتكِ، ذات مرَّة، تقولين: من الواجب تقديم تولستوي للشَّبيبة. كما علمتُ أيضاً أنَّكِ كتبتِ عنه ثلاث مقالات، في العام 1908 والعام 1910 والعام 1913، وحاضرتِ عنه في العام 1910. لماذا لا تكتبين عنه دراسة متكاملة؟
قالت معترضة: لمَنْ؟ ولِمَ؟ يستطيع الجميع قراءة أعمال تولستوي. وإذا كان النَّاس لا يستنشقون لوحدهم نَفَسَ الحياة العظيم الَّذي يخرج منها، فأنا لن أتمكَّن من المساعدة على ذلك بوساطة بعض التَّعليقات. أيمكن تفسير موسيقى موزارت لأحدهم؟ أيمكن تفسير معنى نشوة الحياة لأحدهم إذا كان لا يحسّ بها بعفويَّة في أصغر الأشياء اليوميَّة، أو إذا كان لا يحملها أصلاً في داخله؟
لم أقل شيئاً؛ بل اكتفيت بهزِّ رأسي وأنا أفكِّر في ما قالته. وواصلتْ حديثها قائلة: خذ مثلاً ذلك الكمّ الهائل الذي كُتِبَ عن غوتة. أنا أعتبره كلّه حشواً. وأرى أنَّه قد أُنتِجَتْ كتُب أكثر ممَّا ينبغي. يكاد النَّاس، يا عزيزي، أنْ ينسوا، مِنْ كثرة الأدب، تأمّل جمال الدّنيا.
ما حدث بعد ذلك لهو أمرٌ يدعو للعجب حقّاً؛ إذ جاء ميخائيل بولغاكوف مصطحباً معه هرّاً أسودَ مرعباً، ووضع مكنسة قديمة بين ساقيَّ، فطارت بي، وراحت ترتفع وترتفع وأنا أكاد أهلك منْ شدَّة الرّعب؛ عيناي مغمضتان ويداي تتشبَّثان بعصا المكنسة، بقوَّة، وساقاي يلتفَّان حولها. غير أنَّ نفسي ما لبثتْ أنْ هدأتْ بعد قليل. واطمأننتُ، شيئاً فشيئاً، إلى ثبات وضعي فوق المكنسة. وعندئذٍ فتحتُ عينيَّ ورحتُ أنظر حولي، فوجدتني أحلِّق عالياً.. عالياً. ثمَّ تجاسرتُ، فنظرتُ إلى الأسفل، فإذا بي أطلُّ على منظرٍ بديعٍ لبحيراتٍ وأنهارٍ وغاباتٍ ممتدَّة لا تُرى نهاياتها. وبين هذه كلّها تناثرتْ بناياتٌ جميلة، رغم اختلاف طُرز بنائها وأحجامها إلا أنَّه كان يجمع بينها جميعاً ذوقٌ فنِّيٌّ رفيع. وشيئاً فشيئاً راحتْ المكنسة تخترق بي السُّحبَ الكثيفةَ؛ فأحسستُ برطوبتها على وجهي ويديّ وبقيَّة جسمي. وبدا لي منظرها مِنْ حولي كالعهن المنفوش. ثمَّ شيئاً فشيئاً اجتزتها ورحتُ أحلِّق فوقها وأحلِّق وأحلِّق إلى أن بدت تحتي مثل قطعة هائلة من الجبن الطَّازج؛ ناصعة البياض، ملساء ومتماسكة، وقد حَجَبَتْ عنِّي كلّ ما تلاها.
ـــــــــــــــ
*اسم سان بطرسبورغ خلال المدَّة الواقعة بين العامين 1914 و1924.



.png)

.png)






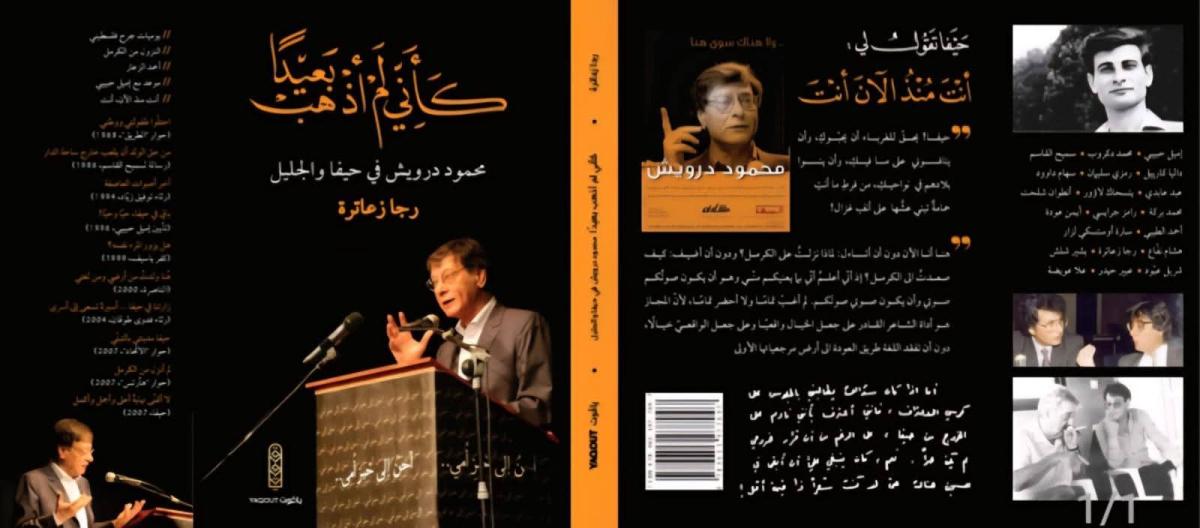
.png)

