استقطبت رواية "جوبلين بحريّ" للكاتبة دعاء زعبي خطيب، ابنة الناصرة، اهتمام عدد كبير من الدارسين والنقّاد، وتهافتوا على قراءتها وتقييمها بمقالات نقديّة جاءت راقية في آليّات التناول والبحث الأدبيّ، فجالوا وصالوا في استجلاء مقوّماتها على المستويين المضمونيّ والجماليّ، حتّى أنّهم لم يذروا أيّ مقوِّم من مقوّمات هذه الرواية إلّا تناولوه بمهنيّة بالغة، الأمر الذي يشهد من ناحية على قيمة الرواية والجهد المبذول في إنتاجها، ويُغني، من ناحية أخرى، فكر وبصيرة القرّاء على اختلافهم.
وفي اعتقادنا أنّه رغم كثرة نقّاد هذه الرواية، يبقى المجال مفتوحًا أمام قراءات أخرى، انطلاقا من المقولة الأدبيّة السائدة التي تؤكّد تعدّد القراءات بتعدّد القرّاء، فلكلٍّ آليّاتُه وطرائقُه في قراءة العمل الأدبيّ واستجلاء ما يبطّن في تضاعيفه.
اسم الرواية
حملت الرواية اسم "جوبلين بحريّ"، والجوبلين هو حيوان وهميّ بمعنى الغول، أو الجنّيّ، أو العفريت، فهل ترمز الكاتبة بهذا الاسم لشخصيّة "الكابتن طيّار" سارة فنكلشتاين؛ لما عكست من رعب ولؤم وعنصريّة تجاه الطلّاب الجامعيّين العرب، وخاصّة ميار التي كادت سارة تئد طموحها وتُقعدها عن تحقيق حلمها المستقبليّ بأن تكون صحفيّة لتوصل وجعها ومعاناة شعبها الفلسطينيّ وقضيّته إلى كلّ بقاع العالم؟ يبدو أنّ الاسم ينسجم بصورة تامّة مع شخصيّة سارة كما تصوّرها الرواية. أمّا معنى الجوبلين الذي يتماهى مع مقوّمات النصّ فهو أنّ الجوبلين أحد أنواع التطريز، وهو عبارة عن لوحات مرسومة وملوّنة يتمّ تطريزها حسب الألوان، ويبدو أنّ الكاتبة مفتونة بهذا النوع من التطريز الذي تذكره في روايتها نحو ثلاث مرّات، فتقول في معرض وصفها للصمت الذي خيّم على شقّة بطلتها "ميار" ليلة سفرها: "صمت لم يعتده هذا المكان، لم تعتده راقصات الباليه ولا عرائس البحر اللواتي تصدّرن جدرانه عبر لوحات جوبلين نسجتها أمّها بحرفيّة وبراعة تنمّ عن فنّ وذوق رفيع"(الرواية: ص14). وتعود الكاتبة في موضع آخر لحديث بطلتها عن والدتها وعزوفها عن تطريز لوحات الجوبلين بسبب ضعف عينيها وتقدّمِها في السن، لتقول: "تبًّا لرمد العيون الذي أعيا عينيها فلم تعد قادرة على القراءة أو حياكة الصوف أو نسج لوحات الجوبلين التي أحيت بها بيتنا الصغير، مالئة فراغ جدرانه بالراقصات والحوريّات، وعاشقَيْن تيّمهما الحبّ وجمعهما الموج والبحر ومغيب الشمس"(الرواية: ص35). تختتم الكاتبة روايتها لتذكّر بصديقتها حلا على لسان الراوي الذي يقول: "يعلو ضجيج البحر، يتكسّر موجه فوق رمل الحكاية القديمة، حاملًا معه حكايةً جديدة لعينين دمشقيّتين احتشدت فيهما كلّ مآذن الشام وحمائم الشام ووردها البلديّ، ولوحة جوبلين نسجتها أمّها لعاشقين قديمين جمعهما الموج والبحر وشروق الشمس"(الرواية: ص200).
حين يعود القارئ ليتأمّل مقوّمات لوحات الجوبلين المذكورة يكتشف تكرار عناصرها الرئيسة في المواضع الثلاثة المقتبسة من راقصات وحوريّات، وعاشقَيْن جمعهما الموج والبحر والشمس، لكن مع تغيير طفيف في الكلمة المضافة إلى الشمس، فمرّة يذكر الراوي "مغيب الشمس" ومرّة "شروق الشمس"، الأمر الذي ينسجم مع المشهد والحالة النفسيّة للشخصيّة، فعندما تسترجع ميار علاقتها بحبيبها نديم وانفصالها عنه، يحضر التركيب "مغيب الشمس"، وحين تلتقي به في نهاية الرواية ليجدّدا علاقتهما ويواصلا الحياة معًا يستخدم الراوي "شروق الشمس"، ممّا يبشّر بمستقبل مشرق لتلك العلاقة.
أمّا البحر فقد جعلت له الكاتبة مساحة كبيرة جدًّا من روايتها، سواءٌ في لوحات الجوبلين أو في تضاعيف الرواية، وقد عبّر الراوي بصورة جليّة عن عشق ميار للبحر وتعلّقها به، بل إنّه يستحوذ على معظم فضاء الرواية، فهي تسترجع معظم أحداث الرواية وهي مستلقية على ساحل البحر، أو خلال اختراق العبّارة للبحر في طريقها إلى مدينة طنجة، أو عبر تداعياتها عن بوسيدون، إله البحر وعلاقته بأوديسيوس، أو سرد حكاية عروس البحر والمصير الذي آلت إليه، أو وصف البحر بصورة مباشرة، وصولًا إلى استنتاجها وقولها: "البحر ثقافة منذ الأزل. سرّ من أسرار هذا الكون العظيم. كم من الحضارات انتقلت عبره، وكم من الثقافات تبادلتها شعوب وغذّتها أمم كان هذا العميق خيرَ شاهد لها. لا شكّ أنّه من الصعب فهم تطوّر جميع هذه الحضارات وتاريخ هذه الثقافات دون المرور عبر هذا الأزرق الجميل"(الرواية: 31). فكيف لا تتحدّث عن البحر، وهي ابنة البحر الذي أثار فضولَها بأسراره وتاريخه منذ بدء التكوين؟ كيف لا، وهي ابنة مدينة يافا التي أغرمت بالبحر منذ طفولتها، "أو ربّما كانت يافا وبحرُها هما السبب وراء تعلّقها وولعها به، حكايات كثيرة حدّثها بها جدّها عن يافا، عن بحرها وناسها الطيّبين، عن رحلات الصيد والصيّادين وشباكهم التي نسجت بخيوطها حكايا الزمن الجميل"(الرواية: ص30). ولمّا كانت للبحر هذه الأهمّيّةُ في نفس ميار فقد جعلت الكاتبة علاقة ميار بحبيبها نديم تبدأ على شاطئ البحر(ص 131)، وتتجدّد تلك العلاقة بعد الانقطاع على شاطئ البحر أيضًا مع نهاية الرواية(197)، وعليه جمعت الكاتبة بين الجوبلين والبحر وأسمت روايتها جوبلين بحريّ.
وبعد؛ فما هي العلاقة بين لوحة الجوبلين والرواية؟ تشمل اللوحة إطارًا يؤلّف بين جميع عناصرها، رغم ما يشاهد الرائي فيها من تباين واختلاف في مقوّماتها؛ ألوانِها، زخرفاتِها، تداخلِها مع بعضها، ونحو ذلك ممّا يجعلها لوحة فنّيّة رائعة بتآلف جميع عناصرها، وهكذا هي الرواية التي جعلت لها الكاتبة إطارًا عامًّا يحضنُ أحداثَها وعناصرَها المختلفةَ داخل ذلك الإطار، أمّا قصّة الإطار فهي قصّة ميار مع سارة فنكلشتاين التي حاولت إجهاض مشروع ميار التعليميّ لتشكّل عائقا أمام دراستها للصحافة والإعلام، إلّا أنّ كلمات سارة ما زادتها إلّا إصرارًا على تحقيق حلمها وحصولها على درجة الدكتوراة في موضوع الإعلام، ثمّ عودتها إلى يافا وتجديد علاقتها بحبيبها نديم. هذه هي قصّة الإطار التي تتولّد عنها قصص وحكايات كثيرة تؤلّف الكاتبة بينها ببراعة أخّاذة مستخدمة آليّات تيّار الوعي بصورة خاصّة أبرزها الاسترجاع، المونولوج، التداعيات، الاستغراق في الخيالات، ونحو ذلك، ولتشكّلَ روايتُها فتحًا جديدًا على مستوى الرواية الفلسطينيّة عامّة ورواية المرأة بصورة خاصّة، وهذا ما يؤكّده الكاتب السوريّ حيدر حيدر في تظهيره للرواية إذ يقول: "تبقى رواية "جوبلين بحريّ" علامة فارقة ومميّزة في سجلّ الأدب والرواية الفلسطينيّة مواصلة درب غسّان كنفاني وبقيّة الروائيّين الفلسطينيّين الذين كتبوا بالحبر والدم سِجِلَّ تاريخ فلسطين وذاكرتها التي لن تنسى أبدًا".
دلالة العنوان
يرى المفكّر الألماني هانز روبرت ياوس (1922 – 1997) صاحب نظريّة الاستقبال والتلقّي أنّ عمليّة القراءة لأيّ عمل أدبيّ تبدأ قبل ولوجنا إلى النصّ، وذلك من خلال مقوّمات خارجيّة من أبرزها الغلاف، وعليه يعنّ أمامنا السؤال التالي: ما هي المعلومات التي يمكن للقارئ أن يستنتجها من الغلاف إضافة لاسم الرواية والكاتبة؟ يتّشح غلاف الرواية في الأساس باللون الرماديّ الفاتح الذي يوحي بالحيويّة والنور، ويولّد إحساسا بالهدوء، بل هو لون النضج والمسؤوليّة تشبيهًا بلون الشَّعْر الرماديّ، والتقدّم في السنّ، وقد يعكس مشاعرَ نفسيّةً عميقة من الوحدة والحزن، وعليه يمكن للقارئ أن يتوقّع أحداثًا مثيرة وحيويّة وليدةَ الفكر الناضج، الجدّيّة، والمسؤوليّة في عرضها، أو قد يُنْبئ هذا اللون بمشاعر الوحدة والحزن التي تفرزها أحداث الرواية.
أمّا المفتاحان المختلفان المثبتان في الجزء السفليّ من الغلاف فمن شأنهما أن يذكّرا بالنكبة التي حلّت بالشعب الفلسطينيّ، ويعزّزا حلم العودة بعد أن يتزوّد الإنسان الفلسطينيّ بالعلم الذي سيمكّنه من الدفاع عن حقّه ومن ثمّ استرجاعِه، حسبما يُفهم من صورة القلم المثبت في الغلاف، ولن يشقّ على القارئ أن يهتدي للبلاد المتحدّث عنها من خلال كلمة يافا الإنجليزيّة الظاهرة في الجزء السفليّ الأيمن منه، وهي تشكّل معادلًا موضوعيًّا لكل مدن وقرى فلسطين، يدعم ذلك صورة يافا وبحرها المثبتة في الغلاف الخلفي والممتدّة على جزء من الغلاف الأمامي مع صورة طير النورس، أمّا الصور التي تظهر في الجزء الأيسر السفليّ وإلى جانبها الشجرة، فمن شأنها أن تمثّل، من ناحية، أصدق شهادة على الوجود الفلسطينيّ في هذه البلاد، وتؤكّد من ناحية أخرى حضور الذاكرة الحيّة للفلسطينيّ، تلك الذاكرة التي لن يوهنها مرّ الليالي ولا طول الأيّام.
نظرة في المضمون
تحكي الرواية قصّة ميار، طالبة فلسطينيّة من مدينة يافا، التحقت بالجامعة لدراسة موضوع الصحافة والإعلام، ورغم تفوّقها في دراستها خلال السنة الأولى تُصدَمُ بعد رسوبها في امتحان نهاية الفصل الأوّل من السنة الثانية، بقرار لجنة الجامعة التي ترأستها الدكتورة سارة فنكلشتاين، أنّها لا تصلح لدراسة الموضوع، وتقترح عليها أن تتزوّج وتبني أسرة، إلّا أنّها ترفض ذلك الاقتراح والاقتراحات الأخرى كإعادة سنتها الثانية في الجامعة، فتعمل لمدّة عامين ثمّ تسافر إلى ألمانيا، منفصلة عن حبيبها نديم حتّى لا يكون حائلًا بينها وبين تحقيق حلمها، وهناك تلتحق بجامعة برلين الحرّة، وتدرس نفس الموضوع، تحصل على اللقب الأوّل بتفوّق، وتواصل دراستها وتتميّز فيها ممّا يتيح لها العمل مراسلة لإحدى الصحف الألمانيّة، استطاعت، من خلال عملها، أن توصل رسالتها ورسالة شعبها التي عبّرت فيها عن آلامهم وآمالهم وطموحاتهم، ثمّ تنهي لقبها الثاني بامتياز، لتحصل فيما بعد على درجة الدكتوراة، وتعمل محاضرة في نفس الجامعة، وتشارك فيما بعد في المؤتمر السنويّ الذي رتّبته الجامعة حول الإعلام الغربيّ، فتشير في كلمتها إلى محاولة سارة قتل حلمها قبل عقد من الظلم، مؤكّدة قولها: "لن تسقط الأحلام أبدا، ولن يقتل اليأسُ ربيعَنا القادم، ربيعنا الآتي لا محالة ولو طال الانتظار"، ثمّ تنهي مداخلتها، فيقف لها الجميع وسط عاصفة من التصفيق، ما عدا بروفيسور سارة التي بقيت مشدوهة بما رأت وسمعت من خطاب ناريّ، وحماس شامل.
تشكّل مقولة فنكلشتاين بالنسبة لميار محفّزا كبيرا لمواصلة دراستها متحدّية إيّاها، ولتثبت أنّ مقولتها لم تصدر إلّا بدافع عنجهيّتها وعنصريّتها، لتؤكّد فكرة بقاء العرب في وطنهم المسلوب مجرّد حطّابين وسقاة ماء، وتظهر تلك المقولة كرمز عامّ لما تقوم به السلطة والمجتمع الإسرائيليّ من تضييق على الإنسان الفلسطينيّ، وحرمانه من الدراسة، إلّا أنّ هدفها لا يتحقّق أمام إصرار وتحدّي ميار، لتحقّقَ ما تريد وتثبتَ سقوطَ تلك السياسة التي تنتهجها السلطة تجاه الإنسان الفلسطينيّ، مؤزّرةً بمقولة صديق العائلة "أبو سامي" الذي يخاطبها قائلًا: "العلم هو كلّ ما تبقّى لنا هنا في هذه البلاد، هو الأمر الذي طالما أقلق نوم المؤسّسة الحاكمة وشكّل صفعة للمؤسّسات الصهيونيّة"(الرواية: 39)، وهكذا تبدو ميار معادلًا موضوعيًّا لكل فلسطينيّ في البلاد، فمعركة ميار هي بمثابة "نضال مشروع لدحر الظلم عن جبين شعب يرزح تحت احتلالين؛ احتلال الأرض واحتلال المستحيل، مستحيل طمس الهويّة والثقافة واللغة، ومستحيل سلب مسمّيات المكان وانتحال الزمان"(الرواية: 41).
توظّف الكاتبة قصّة ميار فتجعلها قصّة إطار تتولّد عنها حكايات وقصص كثيرة تظهر فيها ميار شخصيّةً فاعلةً ومؤثّرةً، وهذا ما يسمّى التناسل الحكائيّ بلغة النقّاد، ومن ذلك حكاية صديقتها الفنّانة الدمشقيّة حلا التي تعرّفت إليها في معرض للرسم، وهي تتأمّل لوحة حلا وقد أخذت من نفسها كلّ مأخذ، فربطت بينهما علاقة حميميّة إلّا أنّ القدر وقف لهما بالمرصاد، فغيّب حلا عن الحياة تاركا ميار ريشة في مهبّ الريح تتنازعها الأحزان، الأوهام، والخيالات. لقد جمع بينهما الوطن الواحد والمصير المشترك فعاشتا "كتوأمين سياميّين لا يمكنهما الانفصال، فكلتاهما كانت وحيدة والديها، وكلتاهما عاشت غربة بل غربتين بملء ما حمل قلباهما من حبّ وصبر، أنصتت الواحدة منهما لوجع الأخرى، لصقيع غربتها، لهمس روحها، لشوق الحنين إنْ داهمهما. اقتسمتا آهاتِ الاشتياق ولقمةَ الطعام وفرح النجاح، وإن حدث وأطلقت إحداهما آه اشتياق لبلادها وأهلها، كانت الأخرى تركض إليها فزعة حاضنة بكاء غربتها وأنين وحدتها بكلّ حبّ وحرص"(الرواية: 60).
تنبري الرواية لترصد علاقة ميار بحبيبها نديم الذي انفصلت عنه لتحقّق حلمها المستقبليّ، كانت مهمّة إعلامه بقرارها صعبة، فهي تحبّه وتدرك أنّها تقوم بدور كاذب ومخادع، وتتساءل: "كيف استطعْتُ الدوسَ على قلبي وأنا أخبرك بنيّتي في السفر والرحيل؟ كيف تجرّأت وتطاولت على ممالك الحبّ والعشق عندما قرّرت أنّني لن أستطيع الاستمرار في علاقة تعاكسها الظروف ويعاكسها القدر؟"(الرواية: 34). وفي موضع سابق تسترجع حكاية عروس البحر التي التي أمتعت طفولتها وأبكت قلبها وعينيها، تلك العروس التي أطاعت حوريّة البحر الشريرة، وتنازلت عن ذيلها ومن ثمّ موطنها لتحظى بحبّ الأمير الذي افتتنت به، فلم تعد قادرة على العودة إلى موطنها الأصليّ، البحر، بعد أن خذلها ذلك الحبّ؛ لذلك رفضت ميار في أثناء غربتها أيّ علاقة حبّ، ظلّت نهايةُ عروسها الأثيرةِ ناقوسَ خطر يدقّ طوال الوقت في حجرات قلبها محذّرًا من حبّ لها خارج الوطن(الرواية: 32 – 33). أمّا نديم فلم يخذلها، فقد ردّ على رسالتها بشغف وشوق شديدين، ولم يتخلّ عنها رغم انقطاع علاقتهما، ليتواصل معها فيما بعد، ويرافقها من بعيد في تحضيرها للمؤتمر، ويسعد بتفوّقها ونجاحها، منتظرًا إيّاها ومستقبلًا لها في المطار بعد عودتها إلى البلاد وتجديد علاقتهما.
تُفرد الكاتبة مساحة واسعة لتصوير رحلة ميار إلى إسبانيا والأندلس مع صديقيها حلا وحسام، تُضمّن خلالها وصفا رائعا وأخّاذًا للبحر والمدن التي مرّوا بها، وتبدُّدَ حلمهم في زيارة مدينة طنجة كما وعدهم المرشد السياحيّ المغربيّ، بسبب جواز السفر الإسرائيليّ الذي يحمله كلّ من ميار وحسام، الأمر الذي اضطرّهم للعودة من حيث جاءوا.
من علاقات ميار البارزة علاقتُها بهاشم عبد الكريم، "صحافيّ يعمل في تحرير إحدى الصحف الفلسطينيّة الإلكترونيّة الصادرة في غزّة، تعرّفت إليه عبر الفيسبوك، فأصبحا صديقين افتراضيّين لواقع أليم جمعهما، تقاسما فيه هموم الأمّة والوطن والمهنة"(الرواية: 142)، وقد عُنيت ميار بإيصال صوته وغيره من المعذّبين المقهورين القابعين وراء الحلم والبحر إلى كلّ مكان تواجدت فيه، وجعلت من قضيّة غزّة رسالة حمّلت المجتمع الدوليّ مسؤوليّتها.
تكاد مدينة يافا لا تغرب عن فكر ميار ولا عن أحداث الرواية، ففيها ولدت وترعرعت، ولها هناك أهل، معارف، وأصدقاء، وأحبّة ابتعدت عنهم رغبة في تحقيق حلمها المستقبليّ، لكنّها تستحضرهم كلّما هاجها الشوق إليهم، وتفرد جزءا كبيرا للحديث عنهم كحديثها عن "أبو شاهين" وقهوته العربيّة السمراء المهيّلة التي دأبت على شرائها من دكّانه الصغير المنتصب بشموخ تاريخه وحكاياته وسط حيّ "العجمي" في يافا، وتستمع لحكاياته عن تاريخ يافا، أسواقها القديمة، الحركات الأدبيّة والفنّيّة والثقافيّة، النكبة والاحتلال وقصص التهجير، أملاكها وبيّاراتها، الحضارات القديمة التي شهدتها المدينة، فأسهمت في تطوّرها، عائلاتها والأماكن التي وفدت منها، ناهيك بمعالم المدينة الرائعة كالميناء، الكنائس، الأديرة، المساجد، المصانع، الفنادق، المقاهي وغير ذلك من المعالم التي عجّت بهذه المدينة الجميلة، والفِرَقِ الغنائيّةِ التي شغلت مسارحها فاستقطبت جماهيرَ غفيرةً من أهل فلسطين، ويستطرد "أبو شاهين" في الحديث عن تشويه مدينة يافا وأحيائها بيد الاحتلال، إذْ حوّل حيّ العجمي مثلًا من حيّ عربيّ عريق، إلى حيّ يهوديّ يتلاءم وروحهم اليهوديّة والصهيونيّة، حتّى أصبح العرب أقلّيّة محاصرة داخل غيتو ملأه العنف وأثقلته الجريمة(الرواية:155 – 157). بذلك تظهر الرواية خير وثيقة تحفظ تاريخ يافا القديم، وشاهدا على ما اقترف الاحتلال من تشويه المدينة وتهجير أهلها كغيرها من المدن والقرى الفلسطينيّة.
خطابات متفرّقة
تنفتح الرواية على خطابات أخرى أرّقت ميار كالغربة التي تخصّها الكاتبة بحديث طويل لما تُحْدِثُه من آثار سلبيّة في نفس المغترب، وعن ذلك يقول الراوي: "غرباء نحن كغربة التاريخ في هذه المدن. نمرّ عبرها كما مرّت جيوش وداستها طوابير أمم. ريشة في مهبّ الريح نأتي ونغادر، نتلاشى كغبار في قعر صحنها، وكأنّا لم نطأ يومًا أرضها" (الرواية: 12). وفي حديثه عن والد حلا بعدما سافر إلى ألمانيا يقول الراوي: " إنّ الغربة تصغر ومساحة الوطن تكبر عندما تجد في الغربة روحا تشبه روحك، ولسانًا ينطق بلغتك، وقلبًا يخاف عليك"(الرواية: 69). ويستطرد الراوي في حديثه عن الغربة عندما تعرّف حسام وميار على الطالب العراقيّ البغدادي عليّ الذي يعمل نادلًا في أحد المقاهي، فيقول: "في الغربة يشتدّ الحنين. فلا تلبث أن ترى روحك وهي تشرع في البحث عن وجوه لها شكل الأماكن والروائح وخرائط الوطن كي تسافر عبرها إلى البعيد الذي تشتاقه الروح"(الرواية: 109). أمّا ميار فقد حملت لها الغربة في برلين السعد والحظ الجميل بشهادة الراوي الذي يقول: "وبرلين كانت جزءًا من قدر، لكنّه قدر أبيض أحاط ميار بهالة من الرعاية والحبّ، جاعلا من رياح المدن الغريبة نسمة لطيفة حملت لها السعد والحظّ الجميل"(الرواية: 13).
تتناول الرواية مسألة الصراع الحضاري بين الشرق والغرب واستحالة اللقاء بينهما من خلال علاقة والد حلا السوريّ بوالدتها الألمانيّة، فقد تزوّجا بعد أربع سنوات من الحبّ، وأنجبا حلا، لكنّهما انفصلا بعد نحو تسع سنين كغيرهما، وفي ذلك تقول عمّة حلا وهي تحدّثها عن والديها "لكنّ العاصفة أدركتهما ككثيرين عاشوا اختلاف البيئة ووجع الاغتراب ورجع الحنين، فتر الحبّ الذي بدا للوهلة الأولى سيظلّ أبديًّا، افترس الزمن علاقتهما بثقل أوقاته واستحالة تأقلمهما للظروف، وحنّ القلب إلى من تركهم والدك في بلاده، فرزم أشياءه وعاد"(الرواية: 69)، ثمّ يضيف الراوي قائلًا: "عاد مصطحبًا معه طفلته الصغيرة، وحقيبة سفره، ومشوارًا طويلًا من ذكريات عمرها تسع سنوات في غربة بات استمرارها في برلين مستحيلًا(الرواية: 70).
تتّخذ الكاتبة روايتها بوقا لنشر أفكارها أو نقد ما لا تستسيغه من أمور الحياة، ومن ذلك نقد الراوي لحال الأمّة العربيّة اليوم، وعدم تصديقه لما يُروى من أمجادهم، إذ يتساءل في أثناء الرحلة إلى الأندلس: "هل حقًّا كنّا هنا ذات حياة نصول ونجول أرض هذه البلاد منشئين من طوبها وطينها قاعدة راسخة لحضارة وارفة الظلال أبديّة التطويب؟ أهي لوثة أصابت أعضاءنا التناسليّة واستأثرت بأرحامنا الأبيّة فأورثتنا ما نحن عليه اليوم من قبح وبئس مصير؟ أم هو خلل جينيّ عبث بخلايانا ونال من عقولنا فأقعدنا وشلّ أدمغتنا عن العمل والتفكير؟ أو لربّما هو داء عقيم الشفاء ابتُلِينا به ولّد هذا النسل العاجز المهزوم؟ عراة نحن إلّا من تاريخ قديم نباهي به، ننشد فيه أشعار الأوّلين، نقف أمامه مهانين مهزومين نتّكئ على دعوات مهترئة وصلوات بالية نمضي بها إلى الجحيم ويا بئس هذا الجحيم!"(الرواية: 24). وفي موضع آخر وميار تتمتّع بمناظر الطبيعة في الأندلس، ويتراءى لها طارق بن زياد، تتمنّى لو يقذفه البحر ليكون مخلّصا للأمّة العربيّة من الذلّ الذي قتلها، يقول الراوي: "بإصرار مميت ترنو بنظرها ثانية نحو ذلك الأزرق العميق محاولةً البحث عنه بين ثنايا أمواجه العاتية وخبايا أسراره المجهولة، علّ موجة تحنو عليها وتقذفه إليها مخلّصًا أبديًّا تهديه لأمّة قتلها الذلّ وهيمن عليها اليأس والقنوط"(الرواية: 55). كما تسخط الكاتبة على لسان الراوي من تواكل الإنسان العربيّ لا من توكّله على الله، فالتوكّل هو الاستعانة بالله مع حضور فعل، نشاط، واهتمام للإنسان وهي صفة إيجابيّة، بينما يشير التواكل إلى غياب الفعل عن الإنسان والاتّكال على الله، وكأنّ الله هو الموكّل في القيام بذلك العمل، كقول جدّة ميار الذي تستحضره، وفيه تقول: "دعي الله والزمن يفعلان ذلك، فهما كفيلان بذلك، والله خير منتقم"، إنّها جملة انهزاميّة استسلمت لها الجدّة، لا تعني ميار ولا تقنعها، يقول الراوي: "تُبعد طيف جدّتها عنها، مستأصلة بانفعال شديد جملة جدّتها رافضة أسلوب الخنوع الذي نشأت وترعرعت عليه هي وكثيرون"(الرواية: 125). يلتقي القارئ بمثل هذا النقد في مواضع أخرى كنقد مناهج التدريس، (درس التعبير الجافّ، ودرس الرياضيّات) التي يقول عنها الراوي: "جمهور وأهداف وموادّ تعليميّة هادرة للوقت قاتلة للإبداع. أيّ هراء هذا الذي أثقلوا به النفوس فأرغموا العقول على استيعابه؟ لا أفهم ما الجدوى من هذا كلّه ونحن نبحر اليوم عبر عصر تكنولوجيّ يستطيع أن يوفّر لنا كلّ ما نرغب في معرفته من علم ومعلومات؟ أيّ مضيعة لأوقاتنا وأيّ فساد لأرواحنا كانت تلك الدروس؟"(الرواية: 103). (يتبع حلقة ثانية وأخيرة)



.png)

.png)






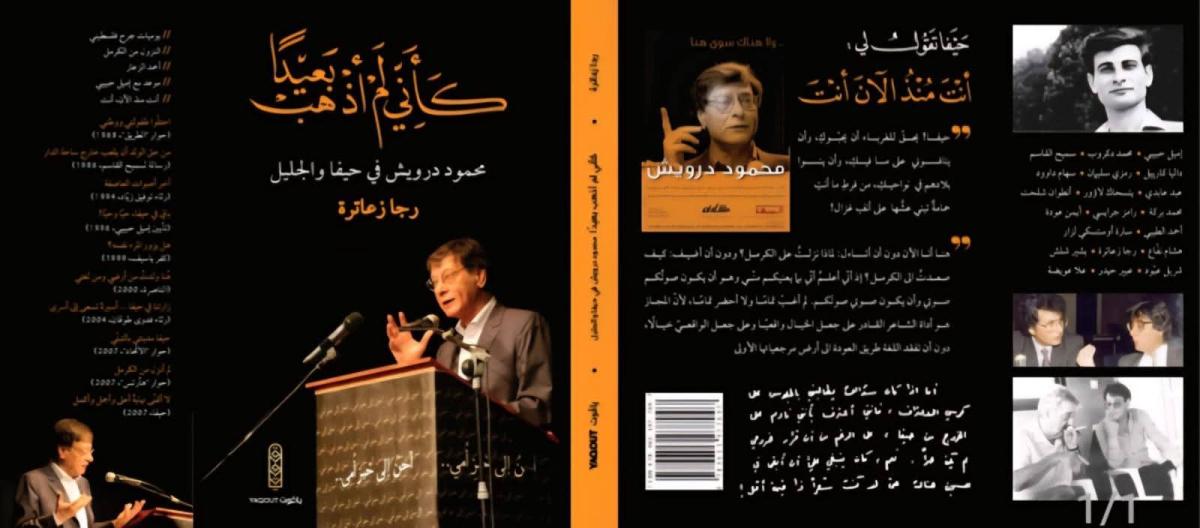
.png)


