حين كان الكاتب مئير شليف، يتلوّى ألماً تحت وطأة داء السّرطان الذي ألَمَّ به، قبل رحيله في الأسبوع الماضي، فتح له مّلفّاً في صفحة حاسوبه، وبمشاركة أبناء أسْرته، لتدوين ساعاته الأخيرة، من ألم وداء ودواء ووصفات طبّيّة وصفوها له، هو نفسه اختار العنوان: الأب يصنع الفضائح، مُشيراً لما يُعانيه ويُكابده في خريف عمره، طالباً من أبناء أسرته ألاّ يُؤاخذوه عمّا يبدر منه، مُمْلِياً عليهم ترتيب أمور جنازته كما يُريد هو، وما يودّ أن يُكْتبَ على قبره بعد رحيله، رَثَتتْهُ ابنته، لتستبدل عنوانه بعنوان آخر هو: الأب صانع النّصائح/المفاخر! وطقوس تشييع الجنازة عند العلمانيّين منهم، تختلف عن طقوسنا، نحن نكتفي بكلمة واحدة للعائلة، في حين أنّه عندهم، يقف أبناء الأسْرة معاً ويتبادلون المراثي، لكلّ منهم مَرْثِيّةٌ ودَوْره.
أتذكّر المجموعة القصصيّة: المُعذَّبون في الأرض لعميد الأدب العربي: طه حسين والمفارقة الدّراميّة الكبيرة مع السّعداء في الأرض ومنهم مئير شليف، كاتب جنّة بَرّ عام 2017.
إذا حاولنا ترجمة اسمه، فأقرب ترجمة هي: مُنير مُطْمَئِن/مرتاح البال! وفعلاَ أضاء وأنار الطّريق المُعْتِم الموحِش للكثيرين من قُرّائه اليهود، وأنا على ثقة تامّة بِأنّه لم يِكُن مُطْمئناً في أيّامه الأخيرة، ليس من حالته الصّحّيّة وحسب، بل الأنكى من هذا، أنّه كان قلقاً على الوضع المأساوي الذي ألَمَّ بالبلاد بعد محاولات الانقلاب على الجهاز القضائي، وحالة الّلغة العبريّة، عشيّة عيد الفصح العبري، حيث تَعِجُّ اللغة بمفردات دخيلة صعبة، كما أشار هو في أخر مقال له، نشره في صحيفة يديعوت أحرونوت7 /4 /2023، في زاويته الأسبوعيّة في هذه الصّحيفة، منذ إثنَين وثلاثين عاماً مَضَتْ.
كُتِب عنه الكثير، ووسائل الإعلام المحلّيّة أفردتْ له مساحات فسيحة، ليس في سيرة حياته فقط، بل تناولت أعماله الأدبيّة الهامّة في أدب الأطفال، ورواياته العديدة، وكُتب الإثراء والمطالعة، أسلوبه الشّائق المُرَصّع بأقوال التّوراة وتوابل اللغة التي أجادها بحذافيرها، فأبواهُ كانا مُعَلِّمَيْن في مسقط رأسه نهلال في مرج ابن عامر، ثمّ انتقلوا ألى كيبوتس جينوسار على ضفاف بحيرة طبريّة، ثمّ القدس، حتى استقرّ هو في بلدة (ألوني آبا)، وإن شِئنا ترجمة اسم البلدة فهو، سنديانات الأب. عدا عن سنديانات الباشان في هضبة الجولان.
حَظيتُ بالتّعرّف عليه شخصيّا، حين زارني في بيتي برفقة الكاتب العبري الكبير دافيد غروسمان ومعهما كُتّابٌ آخرون عام 2006، في أوج الحرب العدوانيّة الثّانية على لبنان، وقد زاروا قريتنا آنذاك متضامنين معنا، لكوننا قرية حدوديّة مُعَرَّضة للخطر.
دعوني أرَكِّزُ على واحد من إبداعاته وهو: (جينات بَر) وأترجمها جَنّةُ بَرٍّ، وليس حديقة، لتكون ألأقرب بين اللغتَين الشّقيقتَين، شاء من شاء، وأبى مَن أبى.
في الأمورُ والنّصوص تواردُ خواطرَ، مشاركاتٌ وجدانيّةٌ بيننا، وعشق للطبيعة القرويّة، قبل أن نلتقي ونتعارف، كُلّْ صُدْفة خير مِن ميعاد! حين أنهيتُ مطالعة كتابه بِتَمَعُّن وَلَهْفَةٍ، خِلتُ أنّني أتجوّل في حديقتي البيتيّة، أستمع إلى الإخوة المُهتَمّين بنباتات بلادنا وأرْشفتها، على التوالي: سلمان أبو ركن/عسفيا، أسامة ملحم/كفر ياسيف، صالح عقل خطيب/المغار، محمد نفّاع وصالح أسعد/بيت جن، شكري عرّاف/معليا، فوزي ناصر/إقرث/النّاصرة، والمرحوم الشّيخ أبو حمد سعيد رباح/ حرفيش، والقائمة طويلة.
عند القراءة تشعر كأنّك في قرانا ومدننا، نفس النّباتات والأشجار، نعود إلى ماضي أجدادنا وأسلافنا، تجد أنّ حضارتهم، معرفتهم والتصاقهم بالأرض وما عليها قد تُرجمتْ للعبريّة ومالَحَنا بها وبخيراتها جيراننا الجُدد، نفس الشّخْصيّة مع تغيير الطّاقيّة، تعود إلى العاشقين الفلسطينيّين، جَفْرا، يا غْزَيِّل، لَاكْاتبْ على جبين الوطن موّال... يا عين ياعين هِلِّي بالدَّمع وْجودي...
أتذكّر قصيدة الشّاعر العبري الرّاحل(نتان يونتان):
بُؤَرُ الصّبرِ مُغْبَرَّةٌ في طريقكَ إلى البُقيعة/
صُعوداً إلى حرفيش، سَقايِلُ تَبْغٍ مُسْوَدّة/
أكاليلُ التّين المُحْمَرّة في الجِشّ على السّطوح/
ألْعُلّيق في مُنحدرات ترشيحا/
بين المجاري والسّنديان والدّردار الشّائِك/
أرْجُلُنا تجذبُنا شرقاً، والقَلْبُ غرباً/
الكتاب مزدان برسومات بالألوان الطّبيعيّة، بريشة الفنّانة (رفائيلة شير)، شقيقة الكاتب، يُحدّثك عن أطلال القرى العربيّة في ضواحي القدس: لفتا، الشّيخ بدر، عين البيضا وينتقل إلى مرج ابن عامر، حيث الصّبّار الجدار، كيفيّة قطفه بالصّنارة، دردغته بأغصان الطّيّون وتقشيره بالسّكين بمهارة وحرفيّة، تتذكّر تُجّار الصبر عندنا، يبيعون السّطل بقيمة... نظراً لعملهم ألشّاق لكسب لقمة العيش، وفي الحقيقة هو لا يُجدّد لنا شيئاً، بل يجدّد للقارئ اليهودي الذي لا يُلِمّ بهذه البديهيّات المألوفة عندنا، نحن نُجيد أكل النّباتات الشّائكة بعد تصنيعها وتشذيبها، سيّانَ أكانت من العكّوب، الخرفيش، السّنّيرة، الدّردار، القرصعنّة، القُرّيص، دمّ الغزال، العليق، السُّوّيد والحاحوم وأخواتها، وكلّ هذه تعتبر ثروة غذائيّة مجّانيّة وهبتها لنا الطّبيعة المعطاءة دون مِنّة.
مئر شليف نقل هذه النّباتات البرّيّة إلى حديقته البيتيّة، واعتنى بها حتى لفتت أنظار الجميع، وأصبحت قِبْلة للزّائرين، ويشير إلى مصطلحات لغويّة مشحونة بين اللّغتَين: أرض الآباء والأجداد، دمّ، آدم، أديم/أدَمَة، الفعل: كَبَسَ/كَبَش/ بمعانيه المختلفة: كبس الزّيتون، الخيار، الجبنة وغيرها، بمعنى خلَّلها وحمّضها وبهّرها، وكبس الأرض: مهّدها أو احتلّها وانتهك حرّيّة أصحابها، والأرض العذراء/البور/ العزيب وغيرها، هو يلفتُ انتباهنا إلى أنّه كثيراً ما يعمل حافياً في جَنّته، ليكون أكثر التصاقا بالأرض، ألا يُذَكِّرُنا هذا بلوحة الفنان سليمان منصور: جَمل المحامل الذي يحمل على ظهره القدس برمّتها وعظمتها وقدسيّتها، وهو حافٍ!... ولا ينسى مئير أن يُطَعِّم عبريته ببعض المصطلحات العربيّة، صحتين، يالله، كما يُطَعّم شجرة الخشخاش الحامض بأصناف عديدة من الحمضيّات، فتصبح الشجرة الواحدة بيّارة كاملة، وثمرها رأساً من البيّارة للسيّارة، كما يهتف الباعة عندنا! ويُعرّج على أرض حرفيش في الوادي، ليستأذن في أخذ نبتة الملع التي تتسلّق على جيرانها من الأشجار، لِتُخَيِّمَ عليها وتكسوها زهراً أبيضَ شذيّاً وعطراً بنوعيه: الملع المنثور والملع الكأسي، ويشير إلى أنّ الصّبّار والتين والزّيتون والكرمة هي زراعة عربيّة، أمّا الكينا والصّنوبر البرّي والسّرو فهي زراعة عبريّة.
كبار الكتّاب العبريّين ورجال السّياسة أشادوا بقلمه السّيّال ونبعه الذي لا ينضب، ومواقفه السّياسيّة الجريئة لنقد نهج الحكومات المتعاقبة في هذه الدّيار، كما حدّثنا عن الحرائق المفتعلة في التّوراة في سِفْرَي القضاة وعاموس، وإحضار ثلاث مئة ثعلب، إشعال ذيولها وتركها لتلوذ في حقول الأغيار في موسم الحصاد، بعد الخصام بين شمشون الجبّار ودليلة.
أمّا في سفر عاموس فجاء: إنّ الرّبَ يُزمجر من صهيون، ويعطي صوته من أورشليم، فتنوح مراعي وَيَيْبَسُ رأس الكرمل، ناهيك عن الوعيد والتّهديد بحرق كل من :دمشق، غزّة، صور، آدوم، عمون وَمُؤب. نودّ أن نُقدّم تعازينا الحارّة لأسرته الكريمة: الزوجة رينة، الابن ميخائيل، الابنة زوهر وذويهم معاً، وله الرّحمة بين أزهاره وأشجاره البرّيّة.
.png)


.png)

.png)






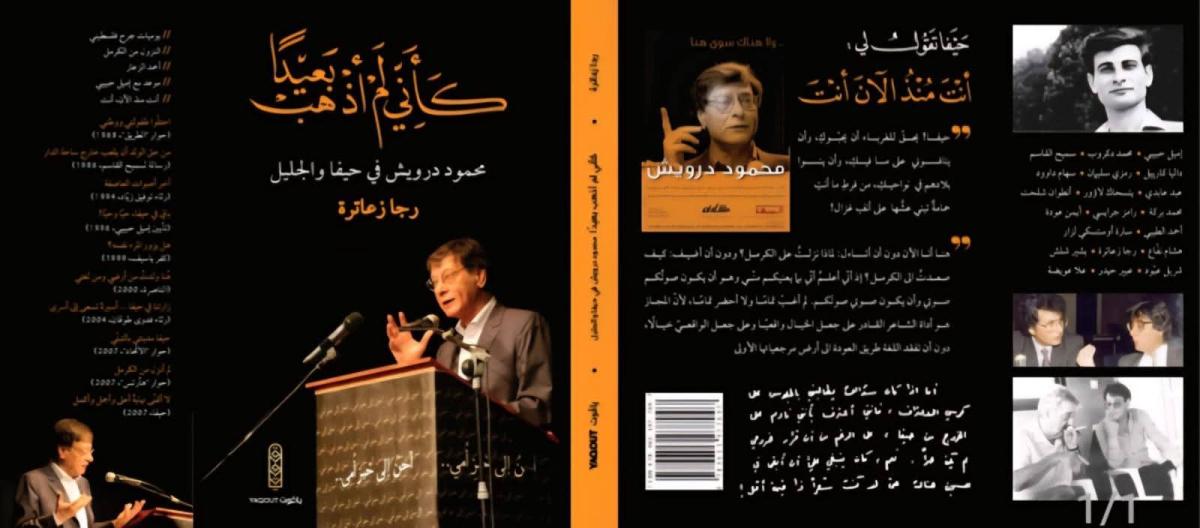
.png)


