خُضت منذ أكثر من عامٍ في بحرِ مساقٍ جامعيّ، تجربة إبداعية تراوح اللّغة العربيّة إلى المسرح، هي لا تتغاضاها بالفعل بقدر ما تمثّلها بصورةٍ فريدة، حيث تمتزج الرّسالة الأدبيّة الحرّة بفنّ جماليّ حرّ ورحب أيضًا. وفي غمار هذا المساق قدّمت وظيفةً نهائية تشرح تمثّلات حبيبنا المتشائل في النظرية الكرنفاليّة المرفعيّة للناقد الروسي ميخائيل باختين التي يستند إليها المساق، أينما تجتمع الأيديولوجية اللغوية بعمقها السّياسي والاجتماعي على ذلك المرعى المحدود شكلًا والواسع أفقًا، أينما يشهد المُعاين آلامه بسخريةٍ تخفّف من وطأة الواقع المُعاش، رغم أنّها تعرّيه تمامًا بتفاعل طبقيّ مثير ولا مثيل له.
قرأت مرّةً قولًا للمسرحي العالمي بريت بيلي، إذ يقول: "أينما كان هناك مُجتمعٌ إنساني، تتجلّى روح المسرح الّتي لا يُمكن كبتها"، ومذ طرقت هذه الجملة شوارع ذهني وأنا أشعر أن علّةً كهذه كانت سببًا مرجّحًا لأختار مساقًا بلغة عربيّة تمثّل كياني الّذي يلهث وراء تصوير الهويّة والدفاع عنها بشتّى الوسائل، لتكون ممزوجة بروح المسرح. والحقيقة أنّني ظننتُ بدايةً أنّنا سنعالج مسرحًا أقل تشعّبًا ممّا عاينت، ولكن هذه الرحلة الشيّقة ما بين العالمي حتّى الإقليمي والمحلي في أعمال الثنائي دريد لحّام والماغوط وبعض الأعمال الأخرى، أعطت نكهةً خاصّة أكثر لذّة، فيها أدركت كيف يرتقي المحلّي القريب إلى عوالم إبداعية تضاهي أعمال كبرى كان لها الحظ أنها انبثقت في مكانٍ لم يكبتها إنّما صقلها وطوّرها وقام بتصديرها إلى شرقنا هذا، بخفوت معين مع استيعاب أنماط غربية دون التمايل بأنامل إبداعية تستطيع بالفعل أن تصير يومًا ما تريد، أن تصيرَ فكرةً بل وطائرًا تسلّ من العدم الوجود كما قال درويشنا محمود.
ولعلّ أبرز ما جعلني أختار رائعة اميل حبيبي، المتشائل، كان الانحياز التّام لهذا المحليّ الراقي الذي اجتاح العالم العربي بسلاسة، وكان له الأثر في خطّ رواية حقيقية وصادقة وشفافة، تنبعث منها الروح الأدبيّة الكامنة، مع ما قدّمه الفنان محمّد بكري، الذي كان يرى بحبيبي نبيًّا للأدب العربي وللإبداع الّذي يتعسّر على كثيرين منافسته. وبخلاف المسارح المعروفة، فإن لمسةً ما يجابه فيها الإنسان هاهنا نفسه، يطهّره من ذاته حتّى يصل مرحلة الكاثارسيز، حينما يصبح المسرح فينا أساسيًا كالهواء مثلًا، ليصطفي كل شيء معنى، أو كمبادئنا التي ما لبثت أن أصبحت هشّة في وجه الصراع تحت الاحتلال ومؤسسته وعقليته الكولونيالية الطامعة والجشعة التي تسلب كينونة الفلسطيني وتحاول بشتّى الطرق أن تدفن وتزيّف ماضيه، تعبث وتسرق حاضره، ثمّ تجعل مستقبله مركّبًا ومتشعّبًا ومحفوفًا بالمخاطر، النفسية منها قبل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الّتي اعترتها أنفاس التطبيع الرسميّ، ليبقى العمل الفنّي والابداعي رسالة سامية وجوهرية في وجه المتآمرين المتخاذلين أصحاب الشعارات الطنانة الرنانة التي طمرت معاناة شعبٍ بأكمله وحوّلته إلى منديل أخرق يتداوله المتاجرون من يدٍ لأخرى في أسواق النّخاسة، أينما تقف القضية الفلسطينية عارية في أسرها بلا ظهر. هذه كانت المقدّمة الّتي لم أتنازل عن ذكرها بحذافيرها هنا.
وبالولوج للمسرح، يصفه إدوار الخراط في مقدمة كتابه "فجر المسرح"، على أنه "باحة للتلاقي وميدان للمشاركة، بل عملية جمعية للتآلف، وتحطيم للانفصالية والوحدة"، أي أنه وفقًا لرأيه هذا ليس طريقًا فرديًا للخلاص لأنّ أبرز ما يميّزه هو صيغته الجماعية. ولا شك أن هذه الصيغة تتمثّل في أشكال المسرحية المختلفة، كالمأساة أو التراجيديا، الملهاة أو الكوميديا، الميلودراما، السوسيودراما والسيكودراما وغيرها. كما يعتقد بأن "المسرح لا يكشف حقيقة ذات أنفسنا فقط، ولا يعمل عمل المفرّج عن التوترات العضوية أو النفسية، وهو ليس عزاء عن العلاقات التي تقيد الناس بدلًا من تحريرهم، أو مجرد مخفّف ساحق لعوامل الغربة، وليس فقط امتاعًا بالتناسق ولذة جمالية تأتي من الصلات المتكافلة بين جوانبه بعضها بعضًا وبين العمل الفني والواقع النفسي العميق، وبينه وبين الموضوعية الخارجية للأمور، وليس هو راحة للتواصل الإنساني بين الأفراد فقط، أو ما يؤمن التكافل الاجتماعي في القبيلة البشرية"، هو كلّ هذه الأمور مجتمعة "حتّى أنه تطوير للحياة نفسها على مجرى نسق الحياة ذاته، أي تعميق من مبدأ الحياة والمساهمة في المضي بها إلى قيم هي جمالية من الدرجة الأولى ولكنها خلقية أيضًا".
وهذا ما أظهره الإنسان القديم، الذي أجمع بعض الباحثين الأنثروبولوجيين أنه "كان يرقص وذلك من خلال الرسومات على جدران الكهوف، اذ أن كان في محاولته الرقص، يعبّر عن الذات الاجتماعية أو النفسية أو الحضارية أو في محاولة لعرض المشاعر الأكثر تأصلًا في روح الجماعة، في عدة مناسبات كالفرح بالانتصار، الحزن، الحاجة للمطر، الغذاء، او الفرح بالاكتفاء والامتلاك، بحيث يظن الباحثون أن الرقص بحد ذاته هو الأم الكبرى للفنون المسرحية"، وفقًا لغسان غنيم في "ظاهرة المسرح عند العرب".
وبخلاف ما ظنه البعض فقد قال غنيم، انه وفي خضم التطرق إلى المسرح لدى العرب، "فإنّ المساجلات الشعرية هي نوع من أنوع المسرح، والقصّاص أو الحكواتي، الممثل الوحيد الذي يحكي حكاية الأشخاص جميعًا في الرواية أو الملحمة التي ينشدها داخل الساحات والأسواق أينما يجتمع الناس، هو أيضًا يشكّل في فنّه مسرحًا انتشر في الأقاليم العربية، وأضيف إلى ذلك أيضًا فن الأراجوز، الذي تقوم فيه الدمى مقام الممثلين في حين يحكي محرّكها قصة تراثية تحاكي الواقع، والذي تطور لاحقًا ليسمّى مسرح العرائس أو مسرح خيال الظلّ الذي امتلك سمات المسرح الحقيقية وكثير من الفنون الأخرى". ولكن الضروري هاهنا أن نعاين التطور في الجانب العربي ونثبت أن فيه نوعًا من المسرح الّذي ليس بالضرورة يجب أن يتطابق مع المسرح الأوروبي كما أسس له في اليونان.
وهناك من ذهب إلى أبعد من ذلك، في حداثة التعبير عن اللحظات المسرحية، اذ انه بحسب "نظرية المسرح" لمحمد كامل الخطيب، فإنّ كل فرد يستطيع أن ينظر في ذاته دون خوف، وأن يسخر منها وان يتحرر من خوفه الدائب عليها ويصبح أكثر حرية، بل وان الأشكال المسرحية تحدث في حياتنا اليومية، في الأفراح، المناسبات الدينية، الأعياد، المآتم، التجمعات التلقائية في الأسواق والحانات والنوادي. وان لم تبد رسمية بالتعريف المسرحي، ولكنها مع مرور الوقت تطورت وأصبح لها تقليد وتراث، كما تطورت صلاة الاغريقيين الى ان أصبحت مسرحًا ثم انتشر. ولكن هذا لا يعني ان الشعب العربي لم يملك مسرحًا أدى وظائف اجتماعية متفاوتة كذلك.
وبالغوص في الكرنفالية أو المرفع، نرى أنه وبحسب باختين (ت. 1975م)، هو مسرحية بلا خشبة، وما يطرحه هو ان المسرح ذلك الشيء الذي يشبه الانصهار بين الممثلين والجمهور. فدورة المرفع تخرج عن مسارها الروتيني، بمعنى أنها الحياة في جهتها المقلوبة، اذ تلغى فيها القوانين والحواجز وتذوب فيها الهرمية وتتلاشى فيها كل أشكال الخشية والرهبة والذعر.
وأكّد باختين، أن فكر الفرد أو الجماعة في الأجواء المرفعية الاحتفالية المسرحية، يتحرّر من القيود والفروض الاجتماعية، كون هذه الأجواء تعتبر الفضاء الذي يعكس حقيقة الثقافة والفكر، وهذا صنف حتمي وأبدي للحضارة الإنسانية تتجلى فيه الثقافة الشعبية. ويُعتقد من خلال الدلالات اللغوية أن كلمة الاحتفال يمكن اختزالها في دلالتين وهما الاجتماع وأيضًا التزيين. فالحفل في لسان العرب يعني اجتماع الماء في محفله، وحفل القوم أي اجتمعوا واحتشدوا، والتحفل يعني التزين والتحفيل التزيين. وهكذا لا يمكن تصور الاحتفال بلا جمع من الناس يقيمونه ويشاركون فيه، يتخلله عنصر الزينة الذي يظهر عليهم وعلى المكان نفسه الذي يقام فيه الحفل (الديكور والمسرح نفسه).
وكلمة الاحتفال وفقًا "للمعجم المسرحي: مفاهيم ومصطلحات المسرح وفنون العرض"، مأخوذة من اللاتينية وتعني الصفة المقدسة، وهو فعل فيه وقار وجدية تصل حد تكريس العبادات، او احياء المناسبات الاجتماعية أو الأعياد. وقد يكون الحفل قريبًا من ممارسات اليونانيين القدامى الذين كانوا يحتفلون بالآلهة مثل إله الخمر، ليجمعوا في هذا اللقاء، الطقوس الدينية التي يهتمون بها مع المظاهر الاجتماعية لتتلاشى همومهم وأحزانهم ولينصهروا في الحدث جماعةً.
وذهبت الباحثة الجزائرية نورة بعيو، في تصورات باختين إلى أبعاد أكثر عمقًا، حلّلت من خلالها روايات عدّة خاصّة لكتّاب من شرقنا، وأوردت في " الاحتفالية بين الخطاب السردي والخطاب المسرحي"، تعريفًا غارقًا بتفاصيل الاحتفالية عن ساحر الاحتفالية في الوطن العربيّ ألا وهو المسرحي عبد الكريم برشيد، اذ تشير إلى أنها "فلسفة ذات بعد شمولي عام متجذّر في أعماق الأصل الإنساني الأول، تتميز بالتعدد والتنوع، هي الأصوات والأجساد والأرواح الحيّة في تفاعلها وتواصلها، هي العقل والانفعال، وهي التلاقي وهي المظهر الذي ينطق بلسان المضمر، هي المقنّع الذي يتكلم بلسان المقْنع. فالاحتفالية كالحوارية تؤمن بالتغير والاختلاف والتعدد والروح الجماعية ومعطيات الراهن وفضائه، تنطلق من الحاضر الكائن إلى كل الجهات الممكنة متجهة نحو العمق، تكفر بالعتاقة والقداسة والماضوية، لأنّه من غير المعقول أن نفرح اليوم، ونقيم الحفل بعد سنة".
وأصرت بعيو في ابراز الاحتفالية كتمرد حقيقي أو أنه الاختلاف بعينه، الذي يعارض المألوف والساكن والسائد بحيث ان الاختلاف يولد الفعل ورد الفعل، الموقف والمغاير له، الفكرة ونقيضها، لذا يتم على سبيل المثال تحدي استعباد الانسان للإنسان، ما يستحيل رؤيته في قالب النظام الشمولي القائم بجوهره على ثنائية العبد والسيد. ومن هنا تقول بعيو ان الاحتفالية تصرّ على حق الإنسان في الحرية على الأرض، والكفر بالقداسة وعدم الاعتراف بزعامة الزعيم مثلًا أو بمشيخة الشيوخ. وهذا ما يبقي المسرح جدليًا نقديًا يحيا بحركة متواصلة وهو غير تابع لأي سلطة.
هذا الاحتفال الثوري، يتطلب انسلاخًا ولو بشكل مؤقت من الفوضوية الدنيوية والسفر إلى زمن يعيد الاستقرار والنظام، فتذوب الاختلافات التمييزية والفروقات الاجتماعية بين الناس، وترى أنه من الطبيعي أن يصبح السيد عبدًا والعبد سيدًا. وما يفجّر الاحتفال هو فكرة الهدم والانقلاب، ذلك الهدف الذي تحاول السلطة مسك زمامه والتحكم به. هذا الفضاء الحرّ يصبح المحكمة التي تتم فيها مساءلة السلطات على اختلافها، السياسية كانت ام الدينية، تمرّ برسائل غير مباشرة عن طريق السخرية.
هنا يتحرّر ليس فقط المجتمع نفسه من السلطات الخارجية، بل حتى من المؤلف والمخرج زمكانيًا وفعليًا، اذ يتلاعب الفنان على حدود الخشبة المسرحية، ولكنه ينتقل بين الأزمنة بسلاسة مطلقة ليحقق الفعل بخطاب الجمهور، وتصبح هناك مشاركة فعليّة بين المبدع ذاته والمشاهدين، وهنا يتم هدم الجدار الرابع الذي تحدّث عنه باختين.
وأهم ما أرفقه باختين كان ما يسمّى بالثنائية الصوتية أو تعدد اللغات، وكان قد اكتشفها لدى دراسته أعمال دوستويفسكي. اذ يرفض باختين مفهوم الأحادية، التي تمثل أيديولوجيا واحدة سائدة وهذا ينسجم مع كل التعريفات السابقة في كسر الرتابة، هناك تكافؤ ومساواة بين الشخصيات بإبراز كل جوانبها. والباروديا هاهنا تشكل نقلة نوعيّة في تحقيق هذا العنصر، بل وتعطيه مصداقية أكبر، لأنّ المشاهد يخيل له ان الشخصية التي امامه حقيقية خاصة ان الكاتب انتقى لها كلمات تعكس ثقافة معينة. ومن هنا خلص الباحثون إلى أن الرواية الهزلية تطرح التعددية بشكل ظاهر أكثر، فيطمس صوت الكاتب نفسه لتسرح الشخصية داخل مجتمعها الحاضن.
وبالحديث عن المسرح العربي، أعود إلى برشيد المغربيّ الذي قال في مقابلة له على "موقع أصوات": "المسرح الاحتفالي هو مسرحنا العربي بكل تأكيد، مسرحنا العربي لا يمكن إلا أن يكون احتفاليًا انطلاقًا من أننا نعيش بشكل مختلف، جمهورنا وتراثنا واحتفالاتنا وأزياؤنا بالطبع تشير إلى هذا الاختلاف. المسرح الاحتفالي هو ذلك الذي يشبهنا ويليق بنا ويرتبط بتاريخنا وتراثنا، الذي يحتاج دوما قراءة ورؤية جديدة نخاطب بها الجمهور ويشاركنا فيها، فالمتفرج هو من نكتب له ونخرج له، وعلينا أن نخاطبه بلغته التي يفهمها". وأردف قائلًا: "الاحتفالية هي روح الإنسان العربي واللحظة التاريخية، والثقافة هي ما نبدعه وما أبدعه الآخرون، والمسرح الاحتفالي موجود منذ الأزل بدءًا من المصري القديم وصولًا إلى الحكواتي. ومشاركة الجمهور تبدأ بإعطائه فنا يتذوقه ويتجاوب معه".
من هنا أعرج لقول إميل حبيبي في حوار أجري معه نُشر في "مجلة الدراسات الفلسطينية": "قدمت في رواية "المتشائل"، ومن دون أي تخطيط مسبق، أسوأ خلق الله مثالًا للصمود واستيعاب الظلم، ولاستمرار الحياة في أسوأ الأوضاع. وأعتقد أن الذي جعل هذه الرواية ناجحة، وجعل الشعب يألفها، هو أنني خفّفت عنه عبء المستويات غير الأخلاقية التي وضعناها. فمن غير الممكن أن يحمل الشخص الواحد بطيختين في يد واحدة: بطيخة العمل السياسي اليومي والتفرغ السياسي، وبطيخة الإبداع الفردي. وقد توصلت إلى هذه النتيجة بعد عناء شديد ومراجعة"، ولعلّ هذه الرأي بحدّ ذاته كان مفتاحًا للخلط بين النظرية وبين فحوى الرواية، كونها تتجاوز الهم الفلسطيني وتتراقص بها روح التهكم الشعبي، أو لنقل هي تستعرض واقعًا رديئًا ولكن يُشهد له بمفارقاته وتناحراته وهذا ما يؤسس لهذا القلب المرفعي فيها.
بهذا الحزن السّاخن، الرافض للاملاءات الخارجية، والذي يكسر المسلمات البائدة، تم الاتكاء على مفهوم الضحك الأسود، كما قال حبيبي لئلا تحمل الذاكرة مأساة مفجعة وقعت على الشعب الفلسطيني. هنا استلهم حبيبي البطل الطريف، اسمًا، شكلًا ولغةً وضحكًا، والذي يشبه في جوهره كنديد بطل فولتير. فيتم استعراض الأضداد والمفارقات وهذا ما يعيدنا الى فكره واستناده على جدلية الأضداد اذ لا بدّ لكلّ مرحلة أن تكون لها اسقاطاتها ودلالاتها، بحيث يمكن مناقشتها بالحجج التاريخية والاجتماعية والسياسية، تمامًا كما حاول أن يستعرض لنا في الرواية المتغيرات بين السلطة والشعب خلال ما يقارب الـ 25 عامًا.
لم تخلُ رواية المتشائل من العناصر المرفعية، بل يمكن القول أنّها ازدحمت بها بشكل يأبى النكران. وقد يعجز البعض إيجاد هذا التواصل في الرواية ذاتها، لأن المتحكم فيها ذكي جدًّا وله اختيارات حكيمة، إلّا أن المسرح يعبث فيه بشكل كبير وجليّ وواضح. وان كانت بعض الفروقات التي تستوجب العمل بطريقة مغايرة في نطاق المساحة التي تتلاعب فيها العناصر المرفعية الاحتفالية، والتي غالبًا ما ترى حريّةً أكبر، إلّا أنها كانت مرآة للمشاهد وخيط تواصله مع الشخصيّة في المسرح، كما النّص الذي يكشر عن الكوميديا السوداء بديكور متواضع.. المكنسة ترافق محمد بكري وحيدًا على خشبة المسرح، ليصوّر بذاته هذه التناقضات مجتمعةً، الأضداد التي يعنى فيها المرفع بمضمونه، القوة والضعف، التفاعل والسكون، الأمل واليأس. وهذا ما يطرح معاناة الفلسطيني الذي يعشش بداخله، بل وكلّ فلسطيني يقبع تحت وطأة الاحتلال الغاشم، في حالة معلّقة ساحرة.
هذه الصورة القائمة على توحيد الأضداد، تبدأ من اللحظة الأولى، اذ اقتبس اميل حبيبي مستهلًا رائعة الشاعر سميح القاسم "مسك الختام"، من ديوانه قرآن الموت والياسمين. فكيف يتصدر الاقتباس البداية، أي كيف يكون هذا الختام بدايةً؟ وكيف يجتمع الموت والياسمين سوية؟ وكيف تكون هذه النهاية بمسكها الغريب مفتاح بابٍ لرواية طويلة؟
لا شكّ أنها هذا الخلط ذكي، هنا تخرج جدليّة واسعة قائمة على توحيد الأضداد ابتداءً من الاسم سعيد النّحس، والكلمة المنحوتة المتشائل التّي تجمع التفاؤل والتشاؤم في إطار واحد حيث يقول في الرواية: "فإنني لا اميز التشاؤم عن التفاؤل فأسأل نفسي من أنا؟ أمتشائم أم متفائل؟"، هذا بالإضافة الى العلاقة المركبة القائمة بين نقيضين بين المضطهد والمضطهد في منصة واحدة. ينتج الوضع الساخر من العلاقة القائمة بين نموذجين متضادين من عالمين مختلفين، فيركل الجدية بعيدًا ويرحب بالهزلية.
العنوان بحد ذاته يجمع عالمًا من التناقضات، الممكنة وغير الممكنة، التي تصدق والتي لا تصدق. نحت حبيبي كلمة "المتشائل"، بل وجمع أيضًا سعيد مع النحس، ولكنه أيضًا يشير إلى "وقائع" وهي تعني الحقيقة في لجوئه مع "الغريبة" وهي غيبيات غير واقعية، اذ نلاحظ كيف لجأ إليها لحل أزماته منتظرًا من القوى الاعجازية ان تبدل الحياة التي يعيشها. هذا بالإضافة إلى التناقض القائم بين صورة المتشائل الضعيف وصمود زوجته والمفارقة التي تظهر في خوف الحاكم العسكري من المرأة وطفلها رغم انه المنتصر صاحب السطوة.
أما عن الحميمية، فقد أذابت كل الفروقات الممكنة، وهي غاية تلعب في مسرح مرفعي بامتياز، وذلك في اعتبار سعيد النحس حياته أنها ما هي الا فضلة حمار، اذ يخلط فيها ما بين التنحية والحميميّة، وهذا يعود كذلك في الاقتباس الذي يقول "هكذا حالي، عشرون عامًا أهر وأموء حتى أصبح هذا الحلول يقينًا في خاطري، فاذا رأيت هرّة توسوست لعلها والدتي رحمها الله، فأهش لها وأبشّ لها وكنا نتموأ أحيانًا". وفي قوله "استشهد والدي على قارعة الطريق وأنقذني الحمار..."، يجمع بين عالمين مختلفين، يذيب عن طريقهما كل الفروقات الممكنة، ينصهر الحيوان بالإنسان، ويُرى ذلك نصًا ومشاهدةً كيف يعبر عنه حبيبي من جهة وبكري من جهة أخرى (في نص المسرحية ذاتها). كما يمتزج بالنقطة السابقة كلّ قضية القلب، الثورة الكاملة على السائد المصبوب في قوالب جاهزة، فسعيد الذي لم يكن سعيدًا بالفعل حكى عن تشرده بسخرية تامّة، تحدّث عن النجاة والهلاك والهزيمة.
فكرة الانبعاث عن طريق وصف الولادة، بعد الولادة يتم استقبال الوليد وبعد التسلل الى أرض الوطن يبدأ الضحك الأسود في عالم مقلوب ومشتبك. وعن طريق إعادة التسمية لسعيد الفدائي ويُعاد الثانية وكأنّه يريد ان يولّد شعورًا لدى القارئ أنّه يتم التحدث عن نفس الشخصية مولودة من جديد.
كانت هناك عدة سمات للتتويج والتنحية وانتهاك قدسية الرفيع، من منطلق العلاقة التي كانت تجمع المتشائل مع "سيّده"، وفي هذا الاقتباس دليلًا على المشادة التي كانت بين الحاكم العسكري وبينه وفيها محاولة تقليل من شأن العظيم ومحاولة لإطلاق الذات: " لما نزلت عن الحمار رأيتني أطول قامةً من الحاكم العسكري...حتّى بدون قوائم الدابة"، يقلّل من شأن هذا الحاكم الكبير ذو القدسية، ولو حتّى شكليًا، ليعبر أنّه أقوى ومتوّج بشكل واضح ناسفًا قدسية الرفيع، محتفلًا بذاته، بكيانه الأطول حتّى من مصدر التهديد والوعيد، ألا وهو الحاكم العسكري المضطّهِد.
وهناك ما أشار إليه الباحث فاروق وادي، "المبالغة في تضخيم أهمية الذات"، وهو الأمر الذي يعبر عنه المسرح المرفعي بأنّه تتويج الذات مقابل تنحية الآخر، اذ يظهر ذلك أيضًا في الاقتباس "اني انسان فذ. فلا تستطيع صحيفة ذات اطلاع، وذات مصادر، وذات إعلانات، وذات ذوات، وذات قرون، أن تهملني"، هذا الاعلاء الوهمي يفجر سخرية أعمق، وهي تتجلى في هذا "لم يشأ الرجل الكبير إلا أن يصحبني إلى بيت خالتي فيسلمني إلى مدير السجن تسليم اليد باليد. فنحن الذين ورثنا الدولة عن آبائنا، تظل مراتبنا عالية ولو في قاووش السجن..."، هنا نرى كيف يجمع حبيبي الرجل الكبير وبتلاعب لغوي يقضي عليه، ليكون اللا بطل هذا هو السيد الذي له مراتب عالية حتّى في مكان وضيع، لا بل ويعطي هذا النحس سعيد ميزة حميمية ليجمع يده بيد مدير السجن مرّة واحدة، فأي شأن هذا وما أعلاه؟
والمتشائل كان بطلًا متحامقًا أمام الجند المدججين بالسلاح حينما أصر على مقابلة سفارشك ممازحًا. من الخارج كان سعيد غبيًا، لكن هذا الغباء يثير الضحك الذي يفجر ما حوله، وهنا تتحول السخرية من الشخصية لذاتها إلى السلطة برمّتها، وهذا يتضح على سبيل المثال عندما رفع سعيد علم الاستسلام لفهمه الخاطئ فأذهبته الخطوة إلى السجن، واعتبرت الدولة ذلك عملية انفصال عنها. وسعيد لا يفصح مباشرة عن هذا التغابي انما يجعله سليقةً مموهة في قوله: "ومضيت إلى يعقوب بهذه البشارة.. ولكن لم احسبها بشارة بل أردت له أن يتوهم أنني أحسبها بشارة". كما يتباسط أكثر مع الحاكم العسكري، مدير المدرسة والحارس. منح الكاتب هذه الشخصية سمات متناقضة تفجر شخصًا متحامقًا ولكن بحنكة تجعله غير مفهوم ولكنه طريف. ويظهر هذا البله عندما أراد رجل المخابرات الإسرائيلي ان يوصله الى سفسارشك (الضابط صديق والده): "قال أنا أبو اسحق فاتبعني، فتبعته الى سيارة جيب أوقفوها بقرب العتبة، وحماري يتخمط إلى جانبه. قال: لتركب، فاعتلى سيارته واعتليت جحشي، فزعق، فانتفضنا، فوقعت عن ظهر الحمار فوجدتني بقربه، أي بقرب الحاكم العسكري". ولا بد الإشارة أن لهذا السلوك تحديدًا هنالك هدف أسمى وأكبر بين طياته، لأنّ بغيته الدفاع عن النفس ويعتبره سعيد بين خلجات قلبه شرطًا للبقاء.
أما عن خلط الأجناس والثنائية الصوتية واللغة، فقد استخدم حبيبي كلمات منحوتة تثري القاموس الأدبي مثل المتشائل، شكسبرني، استبطخنا مستخدمًا كذلك التعبيرات الشعبية "ثم إذا بوالدتي تستشيط وتضرب كفًّا بكف وتبح قائلة: مليح ان صار هكذا وما صار غير شكل". هذا بالإضافة الى ان اللغة تتراوح ما بين الحديث المباشر والآخر الرمزي لتعبر عن الواقع المبهم الغامض، وهذا بالطبع مع استخدام كلمات باللغة العبرية مثل أدون، كيبوتسات، مدينا، وارفاق الشرح في الهوامش للقارئ العربي الذي يريد أن ينكشف على الواقع الفلسطيني في تلك الفترة بواسطة الرواية. والثنائية واضحة ليس فقط بالخلط القائم على اللغة، العامية، الفصحى وبعض العبرية بفعل وجوده تحت حكم احتلالي، بل من خلال علاقة الراوي بالبطل ووجود الصوتين، لأنّ سعيد في النهاية يكتب للراوي مخبرًا إياه ان يروي عنه ولكن البطل يعلق كلّ مرّة.
ومن علامات هذه الثنائية هي وجود تنويع بالضمائر، الغائب، المخاطب والمتكلم وهو ما يلائم كل حالة شعورية بلحظتها. ولا شك ان استخدام المتكلم يبين الوضوح والرؤية الواقعية للشخصية، وكان واضحًا أكثر في الحديث عن المؤسسة الحاكمة وعسكرها، فيحكي عن آلياتها باسمه هو، ليسخر من قربه لهذه المؤسسة بطريقة ملتوية. وهنا لم يفرق حبيبي بين الأصوات، انما أعطى لكل منها المساحة الكافية، ليبرز تعدد الإيديولوجيات في الرواية ويكسر الرتابة قدر الإمكان.
وعن تحطيم الجدار الرابع هو أمر جلي في المسرحيات التي قدمها بكري، فنرى تعاملًا وديًّا عفويًا مع الجمهور المشاهد، بلغة تعكس ثقافته ينصهر مع النّاس ويسائلهم عن حاله، الأمر الّي يصعب ملاحظته في النّص المكتوب، مستخدمًا اللعبة الفنيّة التي تتجاوز جدارية الرواية إلى المسرح، فنرى في المسرحية تفاعلًا رهيبًا بين الممثل وجمهور الحاضرين، يهدم هذا الجدار وكأن المساحة التي أمام الشخصية كلّها مسرحًا تتفاعل فيه كل المكونات، الديكور البسيط، الأضواء الخافتة، الجمهور والمكان برمّته.



.png)

.png)






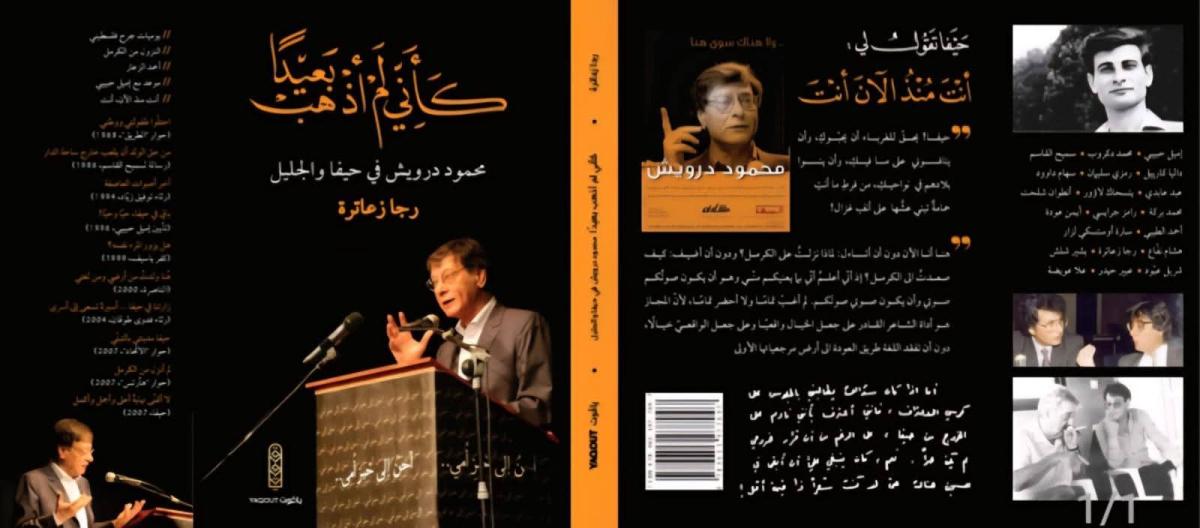
.png)

