ثمَّة قصَّة بعنوان «بيَّاع الفول»*، مِنْ تأليف الكاتب الرّوسيّ «فلاديسلاف بخريفسكي»؛ لكنَّها أشبه ما تكون بـ«قصَّة عربيَّة» منها بقصَّة روسيَّة؛ إذ أنَّها تتحدَّث عن أجواء عربيَّة وبيئة عربيَّة وهموم عربيَّة ونظرة عربيَّة إلى الَّذات وإلى الشّعوب الأخرى، كما أنَّها مشبعة بالتَّعاطف والفهم والتَّفهّم لهموم وأشجان وطموحات وعواطف الإنسان العربيّ، وتُشارِكه، خصوصاً، في العداء لـ«إسرائيل» والحلم باستعادة الأراضي العربيَّة الَّتي احتلّتها.
ومع ذلك فهي، مِنْ ناحية أخرى، قصَّة روسيَّة إلى حدٍّ بعيد؛ ذلك لأنَّها تنطلق، بالأساس، مِنْ خلفيَّة ثقافيَّة واجتماعيَّة وسياسيَّة روسيَّة، وتعكس بصورة غير مباشرة موقفاً محدَّداً يندرج في إطار الصِّراع الَّذي كان دائراً في روسيا (وعلى روسيا) في وقت كتابة تلك القصّة ونشرها في أواخر تسعينيّات القرن الماضي.
وكما هو معروف، فمعظم ذلك الصِّراع كان يدور بشكلٍ خاصّ على هويَّة روسيا وعلى مستقبلها. وهو صراع قديم يتجدَّد ويحتدم مع كلّ منعطفٍ هامّ مِنْ منعطفات التَّاريخ الرّوسيّ القَلِق. لقد كانت هويَّة روسيا قديماً محدَّدة بانتمائها الشَّرقيّ الواضح، وفي القرن الثَّامن عشر انعطف بها بطرس الأكبر قسراً نحو الغرب، ومنذ ذاك أصبحت هويَّتها موضع جدلٍ دائم.
وقد تشكَّلتْ عبر الزَّمن والصِّراع تيَّاراتٌ ثلاثة في هذا المجال هي:
التَّيَّار الشَّرقيّ الَّذي ينظر إلى هويَّة روسيا بوصفها شرقيَّة؛
التَّيَّار الغربيّ الَّذي ينظر إلى روسيا باعتبارها غربيَّة الانتماء؛
التَّيَّار الأوروآسيويّ الَّذي يرى أنَّ روسيا لا هي شرقيَّة خالصة ولا هي غربيَّة خالصة، وإنَّما هي مزيجٌ مِنْ هذا وذاك.
وعندما جاء الشّيوعيُّون إلى الحكم، بدوا في مطلع عهدهم كما لو أنَّهم سيسيرون على خطى بطرس الأكبر في سياسة التَّغريب نفسها، خصوصاً وقد كان من الواضح أنَّ رهاناتهم في البداية كانت منصبَّة بشكلٍ أساسيّ على ما كانوا يتوقَّعونه من اندلاع الثَّورة العماليَّة في الغرب، إلا أنَّ هذه الرهانات ما لبثتْ أنْ تلاشت بعد فشل المحاولات الثَّوريَّة الَّتي جرتْ في الغرب (وفي مقدِّمتها ثورة جماعة سبارتاغوس في ألمانيا، بقيادة كارل ليبينيخت وروزا لكسمبورغ). وبعدئذٍ، توجَّه الشّيوعيُّون إلى الشَّرق، خصوصاً مع اتِّضاح معالم نهوض حركة التَّحرُّر من الاستعمار في الصِّين والهند وفي البلدان العربيَّة وعدد مِنْ بلدان آسيا وإفريقيا. ولقد مثَّل نداء لينين الشَّهير إلى شعوب الشَّرق للثَّورة على الاستعمار، علامة فارقة في تحوّل اتِّجاه الشّيوعيّين بروسيا نحو الشَّرق.
وبعد انهيار الاتِّحاد السّوفييتيّ، طغى لفترة الاتِّجاه التَّغريبيّ على الإعلام وعلى السّلطة في روسيا، خصوصاً في عهد يلتسين الَّذي كان محاطاً بمجموعة من الليبراليين المتغرِّبين ومن الأثرياء اليهود (الصَّهاينة) الَّذين هبطتْ عليهم فجأة ثرواتٌ طائلة.
والقصَّة الَّتي نحن بصددها مكتوبة تحديداً في هذه الفترة، ولذلك فإنَّها تمثِّل خليطاً من التَّوجُّهات الرّوسيَّة المعترضة على الوضع الَّذي كان قائماً آنذاك؛ فمن الحنين إلى الدَّولة السّوفييتيَّة القويَّة، إلى رفض واقع روسيا البائس حينها، وإلى التَّعبير عن النَّزعة القوميَّة الرّوسيَّة المفعمة بالقلق على مستقبل مكانة روسيا الدَّوليَّة ووحدتها وتقدّمها؛ وهو ما كان يدفع الإنسان الرّوسيّ إلى البحث عن حلفاء موضوعيين، له ولدولته، في الشَّرق، وخصوصاً في العالم العربيّ. ولذلك فإنَّ هذه القصَّة تُماهي تقريباً بطريقة غير مباشرة ما بين الأوضاع الصَّعبة للإنسان العربيّ وبين الأوضاع الصَّعبة للإنسان الرّوسيّ، وتؤكِّد على الأعداء المشتركين لهؤلاء وأولئك.
تدور أحداث القصَّة على وجه التَّحديد في مدينة حلب في سوريا. ويبدأ تسلسلها من لحظة استيقاظ الفتى «عمر»، العامل في أحد المطاعم الشَّعبيَّة الصَّغيرة المتخصِّصة بتقديم الفول والحمّص. ويستغلّ الكاتب لحظة الاستيقاظ تلك للإشارة بصورة عابرة إلى بعض الفوارق الطَّبقيَّة المتمثِّلة بنوعيَّة ظروف حياة عمر ونوعيَّة ظروف حياة بعض أقرانه الآخرين: «يستيقظ عمر قبل الأذان بهنيهة، فيما نجوم الفجر تشعشع ذائبة في جمالها. إنَّه راضٍ عن نفسه، لا يحتاج إلى منبِّه، ينظر إلى النَّوافذ الداكنة الَّتي يغفو خلفها أقرانه. إنَّهم سيتنعَّمون بالنَّوم حتَّى الصَّباح، وحتَّى عندما يكبرون أيضاً، وسيعيشون حياتهم دون أنْ يعرفوا أنَّ أبدع الأوقات هو وقت تذوب النّجوم».
وبعد ذلك، ينتقل الكاتب إلى وصف مسير عمر إلى مكان عمله، كما يصف أيضاً «الأزقَّة الضَّيِّقة في حلب القديمة» الَّتي «تشبه مجاري الماء والأنهار الجافَّة». ويتوقَّف عمر في هذا الطَّريق اليوميّ المعتاد وقفةً ذات مغزى عند «صديقه الجذع اليابس!»: «هو ذا صديقه الجذع اليابس! لقد تغلغل في أزمنة سحيقة عبر الجدار الطِّينيّ حتَّى غدا متعذِّراً أنْ نعرف الآن مَنْ منهما يسند الآخر».
ويتابع الرَّاوي قائلاً: «كثيراً ما كان الجدّ عبد القادر يتوقَّف بالقرب مِنْ هذا الجذع اليابس وينظر إلى القلعة. ولذلك فإنَّ الحفيد يتوقَّف، ولو نصف دقيقة، حيث كان يتوقَّف الجدّ.
القلعة كبيرة حتَّى عن بعد. على جدرانها الطِّينيَّة غبار العصور، ودماء العصور. هكذا كان يقول الجدّ».
وعمر وجدّه، رغم أحوالهما الصَّعبة، كانا يفخران باستنادهما إلى جذرٍ حضاريٍّ عريقٍ وراسخ: «كان وجه الجدّ يشعّ كلَّما نظر إلى القلعة والجذع اليابس، وعمر يبتسم أيضاً..». وهذا ينطبق كذلك على وضع الإنسان الرُّوسيّ آنذاك.
ثمَّ ينتقل الكاتب بعد ذلك إلى وصف الأجواء في المطعم في لحظة دخول عمر إليه: «حيث يخيِّم الهدوء، والجميع يتحرَّكون ببطء، بل ويتكلَّمون ببطء أيضاً. يتنهَّد سعيد ويتثاءب، وهو لا يفتأ يخلط الحمّص المدقوق، أمَّا التّركمانيّ يغمور فمشغول بالفرن والخبز..».
وفي سياق تذكّره لحلمٍ رآه في منامه في الليلة الماضية، نعرف عن عمر أنَّ أمَّه قد ماتت في أثناء ولادته، وأنَّ أباه قد هاجر منذ ذاك ولم يعد.
يتناول عمر فطوره؛ صحناً من الحمّص وخبزاً، وبعد ذلك: «يمسح الصَّحن، وينظِّف الطَّاولة ويضع الأواني في المغسلة، ثمَّ يعقد صدريَّته فيغدو مستعدّاً لعمل النهار».
ولا تلبث الأجواء أنْ تتغيَّر في المطعم؛ فتزداد الحركة، وتنتشر الضَّوضاء، و«يؤسفه (عمر) أنَّه لا يستطيع تجهيز الطَّاولة بشكل أفضل للزَّبائن القادمين، فهم مستعجلون دائماً لشغل المكان الخالي..».
ثمَّ «ينتهي الصَّباح بالنِّسبة لعمر عند الظُّهر. فالنَّاس يفقدون الشَّهيَّة بسبب الحرارة المدوّخة».
وفي فترة الاستراحة القصيرة الَّتي يحاول أنْ يختلسها، وبينما هو يراوح بين الإغفاء وبين اليقظة، «يحلِّق فوق حلب فيرى أرضاً منبسطة، ليس فيها مدينة ولا حقول، ولا شجر، ولا أحجار. الأرض وجه، وفي أقصى الأفق طيف إنسانٍ مِنْ ضباب. إنَّه وجه أمّه، فتلفّه فرحة تجعل عينيه تترقرقان بالدّموع قبل أنْ يُتاح له أنْ يتفحَّص عينيها وشفتيها والحاجبين...».
وبعد الغداء، حيث تُخصَّص لعمر ثلاث دقائق ليتناول خلالها غداءه، يتبدَّل شكل الحياة مرَّةً أخرى في المطعم؛ «فيقلّ عدد المستعجلين، وتصبح الأحاديث أكثر إمتاعاً».
ومِنْ باب هذه «الأحاديث الأكثر إمتاعاً»، ندخل إلى أجواء الحياة العامَّة المحيطة بعمر: «ما أكثر ما يسمع عمر في المطعم عن أسعار البضائع الرَّخيصة، وأين تباع، عن الجميلات، وعن صلاح الدِّين، عن الجنّ الملعونين والمباركين، وعن وسائل السِّحر العجيبة، عن النَّاس كيف يموتون وكيف يعيشون....».
ومِنْ بين المشاركين في تلك «الأحاديث الأكثر إمتاعاً» نتعرَّف على «العمّ عليّ»، صديق الجدّ (جدّ عمر)، والَّذي يقول عنه «بأنَّه شهيد، لأنَّه مات مثخناً بالجراح، ففي أثناء الحرب ضدّ إسرائيل تسلَّل جنديّ الاحتياط المسنّ عبد القادر إلى بطاريَّة يهوديَّة وانهال عليها بالقنابل».
«جدّك أنقذ حياة كثيرين! – قال العمّ عليّ العجوز لعمر – حياتي وحياة آخرين. كانت البطاريَّة تحتلّ هضبة وكتيبتنا تحتها مثل هدف رماية للتَّدريب.. ماذا أقول؟ لأمثال جدّك (جنَّات عدنٍ تجري مِنْ تحتها الأنهار)».
وفي سياق هذه «الأحاديث الأكثر إمتاعاً»، نلتقي أيضاً بالرَّأي السَّائد لدى الإنسان العربيّ (والرّوسيّ أيضاً) في تفسير ما حدث لروسيا بعد انهيار الاتِّحاد السّوفييتيّ؛ فأحدهم يتحدَّث عن ابن شقيقه الَّذي أصيب بالصَّمم قبل بلوغه العام الأوَّل مِنْ عمره. وحيث أنَّ شقيقه (والد الطِّفل الأصمّ) يعمل في روسيا، فقد أخذه إلى هناك «قالوا له إنَّ الولد بحاجة إلى عمليَّة، ولكن بعد أنْ يكبر قليلاً، ووعدوه بأنْ يوجِّهوا له دعوة».
إلا أنَّ هذا الطِّفل كان على موعد دائم مع سوء الحظّ، كما يبدو؛ فقد «وقع انقلاب في روسيا، وأصبحت السّلطة في يد اليهود الَّذين يعيشون على النَّهب... كلّ شيء هناك صار يتطلَّب مبالغ طائلة وعائلتنا لا تتوفَّر على هذه الأموال..».
وفي سياق تلك الأحاديث، نفسها، نعرف أنَّ عمر و«العمّ عليّ»، إنَّما هما أصلاً مِنْ قرية خشب المجاورة لشواطئ طبريَّا، وإنْ كان عمر قد وُلِدَ في حلب. يثير الحديث أشجان العمّ عليّ؛ فيتذكَّر بلده المحتلّ: «يا الله، ما أروع السَّماء هناك وما أجمل الورود في الماء عند الفجر، وكم يتراقص فيه من الذَّهب وقت الغروب! الله، الله، يا للرِّقَّة! وتلك الزّرقة المشوبة بالحمرة! تلك العذوبة، حين تخاف أنْ تتنفَّس فتزعزع السَّكينة، يا للرِّياح، ويا للأمواج وهي تتقلَّب على صفحة البحيرة! يا لرائحة الماء! حين أحلم برائحة الماء أستيقظ ووجهي مبلَّل بالدّموع...».
لكنّ العمّ عليّ لا يلبث أنْ يؤكِّد، في مرحلة تالية من الحديث، قائلاً: «إنَّنا، على ما يبدو، الشَّعب الجمل. إنَّنا قافلة. وهذه القافلة تسير عبر الأزمنة، عبر الممالك والإمبراطوريَّات. لذلك سيأتي زمنٌ تصبح فيه أرضنا كلّها لنا».
ويمتدّ الحديث بعد ذلك إلى صفات الشّعوب المختلفة، ومِنْ هذا المدخل يعود المتحاورون إلى تناول موضوع روسيا: «أنا كنت في روسيا، ـ قال الرَّجل الصَّامت طوال الوقت. لقد أنهيت هناك دراستي الجامعيَّة والدّكتوراه. إنَّ روسيا هي الفيضان. ليس عندنا ظاهرة مِنْ هذا النَّوع، عندنا تهدر الأنهار حين تذوب ثلوج الجبال، أمَّا هناك فلا تهدر، بل تفيض، فتغمر الأرض وتجعلها كالبحر..
لكن الأميركان ينهشون روسيا الآن مِنْ جميع الجهات. قال تاجر التَّمر.
إذاً، هناك جفاف، كارثة، وبعدئذٍ سيأتي فيضان جديد، فتفيض روسيا وتنتشر ربَّما أوسع ممَّا كانت..».
وبهذه النّبوءة الرّوسيّة الَّتي رأيناها تتحقّق في أوائل العشريّة الثَّانية من القرن الواحد والعشرين، ينتهي يوم عمل عمر في المطعم، ولكنَّ قصَّته لا تنتهي. وبعد ذلك، بينما هو في طريق عودته إلى البيت، «يتوقَّف الصَّبيّ عند الجذع اليابس في الجدار وينظر إلى القلعة. القمر بمحاذاة الجدار، يرفع عمر يديه، يكوِّرهما بحجمه تماماً، إنَّه يمسك القمر، وشدَّ ما يعجبه ذلك».
تُرى، أكان سيمسك القمر ويعجبه ذلك لو كانت أحداث هذه القصّة تدور في الفترة الممتدَّة منذ العام 2011 وحتَّى الآن (العام 2021)؟
ــــــــــــــــ
* هذه القصَّة منشورة في «الكتاب السَّابع» مِنْ سلسلة كُتُب دوريَّة بعنوان «رمال» كانت تصدر بالعربيَّة في موسكو. وكان يصدرها بعض المثقَّفين العرب، الَّذين كانوا يعيشون في روسيا، بالتَّعاون مع بعض الرّوس المتخصِّصين بالشّؤون العربيَّة والمتعاطفين مع الشّعوب العربيَّة، ابتداءً مِنْ أواخر تسعينيَّات القرن الماضي؛ ولكنَّهم لم يستمروا في ذلك طويلاً مع الأسف!
والقصَّة التي تناولناها أعلاه، منشورة في الكتاب في نهاية العام 2000، ضمن ملف خاصّ عن الأدب الرّوسيّ، قام الدكتور نوفل نيوف باختيار موادّه وترجمتها.



.png)

.png)






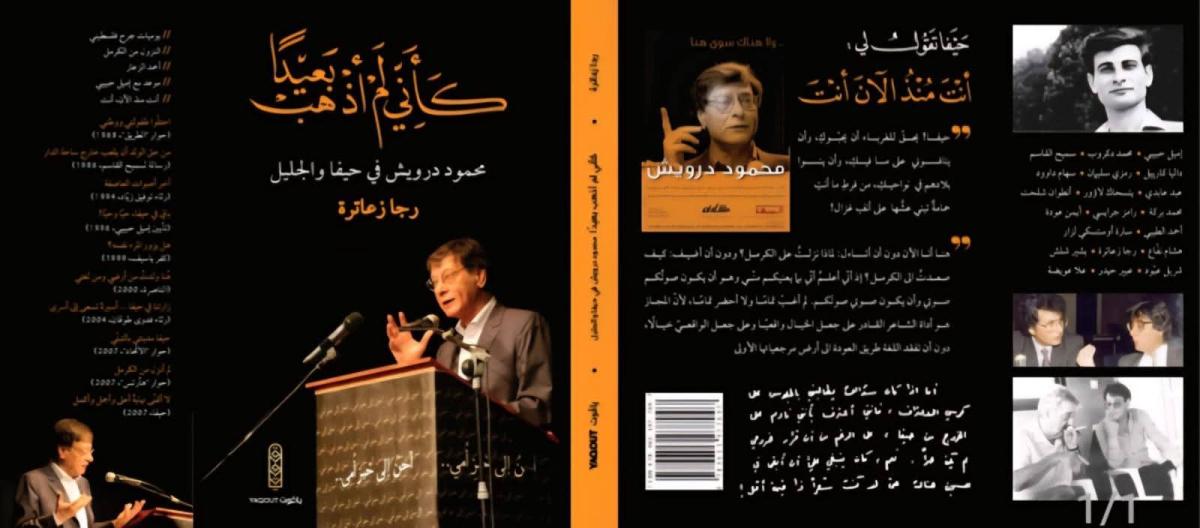
.png)

