لا يخفى خليط الإحباط والخشية والتوجّس لدى كثيرين أمام واقع يقوم فيه أفراد عرب فلسطينيون (قلائل جدًا) من مجتمعنا وجماهيرنا وأهلنا بعمليات قتل بالرصاص أو بغيره تحت مسمّى "داعش". ردّ الفعل الأولي الأول التلقائي هو التبرّؤ من المنفّذين. هذا مفهوم، ردّ طبيعي لمن يحاصره الخوف. ليس فقط الخوف من القولبة العنصرية الإسرائيلية المعهودة لكل من هو عربي في فلسطين التاريخية بأنه مُدان ملزم بالإدانة، بل ربما الخوف من أن في بلداتنا وحاراتنا دواعش.
روى الصحفي يوسي فيرتر، كاتب الشؤون الحزبية-السياسية في "هآرتس" امس الأول الأربعاء أن أحد الوزراء تنفّس الصعداء حين تبيّن أن منفذ إطلاق النار في بني براك لم يكن مواطنًا إسرائيليًا. "ليس من جماعتنا" كما اقتبس الصحفيُّ الوزيرَ. السؤال: لماذا، لماذا أسهل على الحكومات ان يكون المنفذ من الضفة أو غزة المحتلتين؟
ربما لأن منظومة الدعاية هنا جاهزة ولدى المؤسسة برامج إعداد مسبق للوعي العام الإسرائيلي عن "الإرهاب" ويكفي إخراج الادعاءات من صناديقها وإطلاقها كمفرقعات في سماء الجدل العام، حتى يقتنع معظم الإسرائيليين بأنهم ضحايا. بعدها ستقوم حكومة وجيش الاحتلال ببعض الخطوات المصوّرة المتلفزة لإظهار قبضتها الحديدية وسيشعر الجميع بالرضى عن الردّ ويُشفى شيء من غليل الانتقام. أما لو كان المنفذون من "داعش" فكيف سيكون التفسير، والأنكى، كيف سيتم العثور على ردّ مصوّر متلفز يعلو منه الدخان والضجيج وصرير الفولاذ كي ينسكب – ويا للمفارقة - ماء باردًا على الرؤوس الساخنة المشتعلة بالغضب والنقمة؟
في مقال عنوانه [داعش و"الحلول الأمنية"] نشرْته في أيلول 2014 كتبتُ ملاحظات ربما لا تزال ملائمة للسياق والزمان والمكان:
[لا يتألف داعش من شياطين ولا من مخلوقات فضائية. كل سياسي يصوّرهم استثنائيين لدرجات أسطورية، له مصلحة في هذا. فالطريقة الأفضل لقطع الطريق على الفهم، ما بين الظاهرة وما بين منابعها، هي تصوير الظاهرة عجيبة، واستثنائية. والقول إن داعش مؤلّف من بشر لا يعني شرعنة ممارساته ومنطلقاته وأفكاره. (...) هناك ادعاءات وتخمينات شائعة ترى أن زعامات داعش قد تكون عميلة، وقد تكون مخترقة، وقد تكون مؤلفة من ممثلين ماهرين. على سبيل الافتراض لنقـُل: ممكن. لا شيء بأيدينا بعد يثبت هذا ولا عكسه. ولكن ماذا بشأن آلاف الشباب العرب والمسلمين صغار سن، أبناء العشرينات وما تحت، الآتين من جميع قارات الأرض للحرب في المشرق العربي؟ أهؤلاء جميعاً تكفيريون بالولادة ويحملون صفات الارهاب كما يحمل الجسم جينات وصفات مولودة؟ إن من يفكر بهذه الطريقة لا يقل أصولية عن داعش. لأنه يقول بوجود جوهر سابق على التجربة يحدّد مواقع البشر ومواقفهم ومنفصل عن الظرف الاجتماعي الذي يبلور الأفراد والجماعات].
هذا ملائم جدًا لإسرائيل التي يتصرف حكّامها ونخبها وكأنهم مصعوقون من أن داعش يضرب في عمق المدن الإسرائيلية. ولماذا الاستغراب؟ محترفو وهواة نظريات المؤامرة يقولون إنهم مستغربون لأنهم كانوا يدركون عميقًا أن هذا التنظيم شُكّل لأغراض أخرى وأهداف مختلفة، لا تشمل إسرائيل. بينما أصحاب عدّة التحليل المتواضعة يقولون: هؤلاء الحكّام والنخب تزكم الغطرسة أنوفهم فلا يفكرون أبعد منها ولا يتوقعون أن ما صفقوا له في دول الجوار سيرتدّ عليهم – بل علينا كلنا – هنا. وها هو يرتدّ.
لاحقا في تشرين الثاني 2015 نشرتُ مقالا بعنوان ["داعش في بيتنا؟ وفي بيتكم"]. مما جاء فيه: [سيقول شخص ما هنا أو وهناك لنفسه التالي: كيف ظننتَ يا ساذج أن الأمر بعيدٌ عنك؟ لماذا؟ أصلا كيف لا يفكر الناس أن ما يحدث هناك هو جوهريًا، وبعد فترة عمليا، هنا؟ فهنا وهناك هما كل مكان محتمل، ويغطيان كل المواقع المأهولة على هذا الكوكب. لأن حدود الفصل الجغرافي بين هناك وهنا وهميّة، سيّالة، بل مائعة من الأساس، فكم بالحري اليوم في "القرية الصغيرة"، في كوكبنا المريض الذي لملمته شركات وسلطات العولمة الرأسمالية، خنقته، كبّلته ثم حشرته في بقعة مادية وذهنية مقفلة؟ أليس ساذجًا التفكير بأن ما يحدث في شمال الشام مثلا ليس محتملا جدا أن يصل جنوبها؟ أو غربها – بل غربها البعيد – حتى باريس؟].
لم يتحلَّ حكّام هذه الدولة بأية حكمة تُذكر حين كانوا في مقدّمة المحتفلين بتخريج أفواج المسلحين من "أكاديميات" الـ سي آي إيه على أرض أفغانستان الثمانينيات، بدعم ومال نظام السعودية ومخابرات نظام باكستان. ولم يُظهروا أي اكتراث حين واصلت متحوّرات خرّيجي "أكاديميات" الـ سي آي إيه زرع الخراب في العراق. اما في سوريا فوقفوا إلى جانبهم، ومعم أنظمة قطر وتركيا والسعودية، وفوقهم إدارة البيت الأبيض. وكان الوقت متاخرًا ليكتشف كل هؤلاء أن ما زرعوه سيقطفون ثمره السام. وكم من أبرياء راحوا ضحايا. وكم سيروحون بعد. يشمل إسرائيل، كما يبدو.
جاء في ذاك المقال المُشار إليه: [من أجل سلامة مَن هنا ومَن هناك، يجب قلب الأسطوانة. إن داعش في تدمُر ليست بعيدة عن أحد. إنها هناك، قريبة، وكثيرا، من هنا. وكلُّ هنا هو كل مكان محتمل. بيروت، باريس، سيناء، بروكسل وقريبًا ربما نيويورك. من لا تهمّه تدمر سيخسر في لندن. من لا تعنيه حياة أهل الموصل سيأسف على أعزاء له في بوسطن أو سدني. من يحتقر الدم الشرقي الأسمر والأسود إنما يستقدم القتل الى الدم الغربي الأبيض. هذا هو درس سوريا والعراق وليبيا. هذا درس مطلع القرن الحادي والعشرين. هذا هو نتاج وتاج السياسات الامبريالية: تضخّم الرأسمالية من حدودها القومية والاقليمية واقتحامها كلّ الحدود ومراكمة المزيد والمزيد من الأرباح، الجرائم والأحقاد.]
هنا والآن أيضًا: من أجل سلامة مَن هنا ومَن هناك، يجب قلب الأسطوانة. من لا تهمّه جنين سيخسر في تل أبيب. من لا تعنيه حياة أهل أم الفحم سيأسف على أعزاء له في الخضيرة. (لقد اعترف رئيس الشاباك الأسبق وعضو الكنيست الليكودي آفي دختر خلال مقابلة، أمس الأول الأربعاء، مع إذاعة "كان بيت" العبرية، أن انتشار السلاح بكميات كبيرة بأيدي عصابات وجهات إجرامية يجعل من السهل على من يريد القيام بعمليات الحصول على سلاح، وكان يتحدث في سياق منفذين منتمين أو يعلنون أنهم مرتبطون بتنظيم داعش). إن من يحتقر الدم الفلسطيني إنما يستقدم القتل الى الدم اليهودي.
كما كُتب هناك: [هؤلاء الشباب المحرومون من فرصة العمل الكريم ليسوا منظّري تكفير ولا وهابية ولا "إخوان". أخوتنا هؤلاء هم "وقود للحرب". ضحايا يحرقهم "قوّادو الحرب". الكبار منهم والأدوات. مشعلو الحروب ومنتفعوها وتجّارها والوكلاء].
هذا ينطبق الآن على إسرائيل 2022 تمامًا. في اذار 2016 كتبتُ مقالا عنوانه ["من بروكسل لسخنين"] بعد جرائم لداعش في العاصمة البلجيكية. [كوطنيّ وأمميّ، أرفض المسّ بشعبي أو أيّ شعب. مع أنني سأظلّ آمل، وأتمنى وأناشد وأطالب، أن تتحمّل الشعوب مسؤولية. على الأقلّ مسؤولية عن سلامتها ومصلحتها، على أولادها ومستقبلهم (...) بخصوص الشعوب، من أجل مصلحتها الحقيقية بالسلام والعدل والتقدّم، يجب التأكيد بأن السذاجة ليست حجّة دفاعيّة كافية؛ ولا الجهل، ولا الهرب إلى حيّز الخاص الأناني. من يواصل شرب نبيذه بينما يُسفك دم السوري أو الفلسطيني على مدار سنين، فإنه يرفع من أسهمه في بورصة سفك دم أحبائه في مترو أو مقهى أو مطار. لا يمكن لأحد حماية مؤخرته بواسطة إنزال غلالة قاتمة غبية على ناظريه. أهل أوروبا المنعَمون المحظوظون بسِعة العيش، العقلاء العقلانيون – افتراضاً- المتعلمون الذين يحظون بإمكانية وحيّز التدقيق والتأمّل في وقائع الأيام وتراكماتها، ملزمون بأخذ مسؤولية عما يجري لهم، كنتاج لما تركوه يقع لغيرهم. إنّ مَن ينظر بعينين زجاجيّتين إلى تدمير وقتل وإذلال أهل سوريا والعراق وليبيا واليمن وفلسطين. إن من يسلك كذلك، يجب أن يساعده عقله التحليليّ الشهير على إدراك أن زجاجيّة بصره ستنعكس في دمّ يُراق بمراكز حضارة أوروباه البيضاء. فقد انتهى عصر إعدام المشرق فوق منصّة لا يرشق الدم المسفوك فيها الملابس الرسميّة لسادة الغرب الأبيض. انتهى بعدما قرّر سادة التجارة والرأسمالية وأنصار السوق المنفلتة فتحَ الحدود على مصراعيها لحركة الربح. أردتموها وسمحتم بها قرية صغيرة لتناكُح أرباب المال؟ تفضّلوا نتائجها].
من لا يرى في العربي سوى عبء ولا يريد العربي سوى عامل للشغل الأسود، ومن لا يرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 سوى مستودع احتياط للأرض والماء والثروات، وسوق لاستقدام العمل الرخيص وللتسويق والاستهلاك ومراكمة الربح في جيوب أثرياء إسرائيل، ومن يرفض احترام وجود الفلسطيني وحقوقه وتكافئه الإنساني، ويصرّ على امتيازاته وفوقيّته القومية – إنما يستقدم على نفسه وعلينا (نحن الفلسطينيين) هذه الأفعال الدمويّة. قيل سابقًا ويُقال اليوم وسيظلّ: سلام الشعوب، كل الشعوب، فقط بحق الشعوب والعدل للشعوب، كل الشعوب.
.png)


.png)

.png)






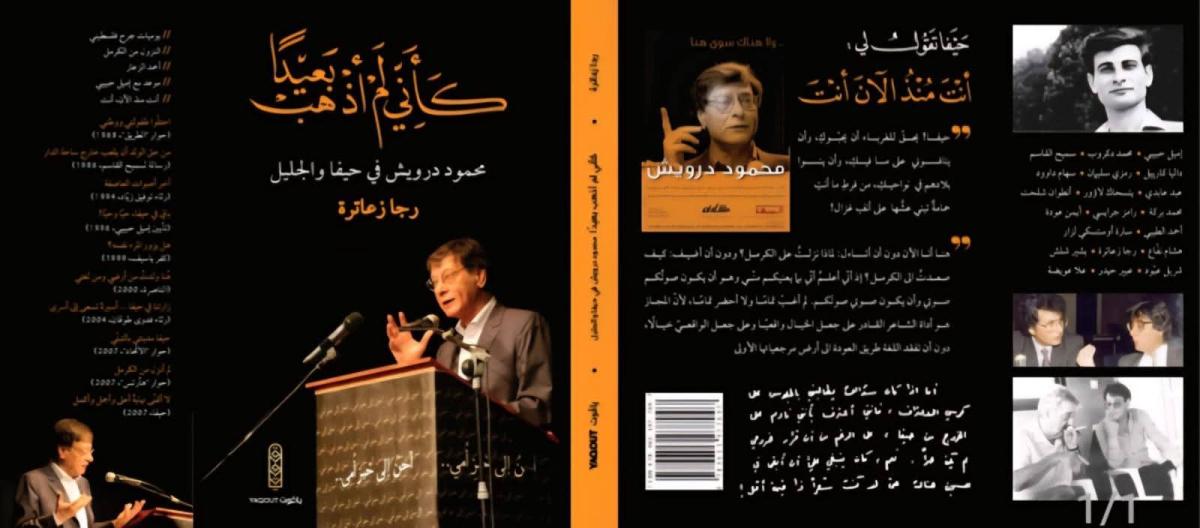
.png)


