أبا شفيق، أيّها الرفيق الصديق الصادق الأمين، لماذا عجَّلتَ الرحيل؟ وكانت جُعْبَتُك ما زالت قادرة على ضخِّ ما يبقى في الأرض ولا يذهب هباء. وهل نَظَّمتَ رِحلتك الأخيرة هذه كما كنتَ تًنَظِّمُ الرحلات الدنيوية إلى شتّى بقاع العالم بدقةٍ ومَعرفةٍ تامّتين! بحيث تجمعُ بين الرفاهية والمعلومات والأمل كذلك! ألم يبقَ في هذا العالم ما يُغري بالبقاء فيه؟ وَقدْ أكَّدَ محمود درويش أنَّ "على هذه الأرض ما يستحقّ الحياة"
رحلتَ يا أبا شفيق ورصيدك طافحٌ بما يجعل مكانك هناك كما كان هنا، إذا كان ثمَّةَ عدل هناك بعكس ههنا. وسامحني بهذا التشكّك الذي عَرَفتَه فِيَّ.
منذ الصِّغَر تزاملنا وترافقنا واتفقنا في مدرسة قريتنا الابتدائية. كنا عشرين تلميذًا في الصف الثامن، منهم غازي أبو صالح وحسين خليل بدارنة أطال الله بعمريهما والمرحوم حمد فاعور طربيه وكاتب هذه السطور. لكنك وحدك نجحتَ في امتحانات الثوامن التي تُعْفي الناجح من رسوم التعليم الثانوي.
في تلك الفترة لم يكن في الناصرة بعد، من يلوّن سماءها بمبادئ الشيوعية والإنسانية والشعر الوطني الأصيل، والأمل في غدٍ زاهر. وبرغم ذلك كانت هذه المدينة تجذبنا إليها، وحين توجّهنا للتسجيل في مدرستها الثانوية، وجدنا أبوابها موصدة في وجوهنا إذ كانت قد استوعبت فوق طاقتها. اضطُرِرنا للتَّوَجُّهِ شمالا. في الرامة النيِّرة الوادعة استأجرنا -أنتَ وأنا- غرفة في بناية قيدَ البناء. مما جعلنا نتقي رياحَ تشارين العاتية ببطانيات وأغطية أخرى. كنّا نصل إلى قرية الزيت والزيتون أوَّل الأسبوع مشيًا على الأقدام، لنعود آخرَه إلى سخنين على الأقدام نفسها.
يدور شريط الذاكرة الآن، يسترجع بعضَ تاريخٍ مضى، وبقايا ذكريات ما تزال ترفرف كالسنونو، فإذا بفتَيَين غضَّين يجوبان طُرق الرامة المبلّطة، يلمحان عن كثبٍ حقلاً مزروعًا يغريهما بحبّاته اليانعة، لا يتردّدان، يقتحمان الحقل ويسرعان في العمل. وإذا بصاحب الحقل يطلُّ عليهما من نافذة منزله متسائلا مؤنبًا بأدبٍ: "وِلكو شو هي فوشطة يا اولاد؟" وكطائري سنونو يلوذان بالفرار لكن ليس قبل أن "يحلِشا" إضمامتين من ذلك الحمص الأخضر.
أنهينا الصف التاسع معًا في الرامة، لكن أنظارنا كانت لا تزال تنشدّ إلى الناصرة، فُتِحَت المصاريع هذه المرة، فأنهينا المرحلة الثانوية في مدرستها البلدية.
والآن، دعني يا أبا شفيق أجتهد في تحديد بعض خصالك التي يطمح الكثيرون إلى أن يتّصِفوا ببعضها، أولاً، العطاء التطوّعي: ودعني يا أبا شفيق أؤكّد لك بأنه كلما اغتسل مواطنٌ من سخنين التي أحبَبتَ، أو كلّما أطفأ ظمأه أو توضَّأ، تذكّرك. فقد كنتَ من أوائل الساعين والمبادرين إلى إقامة هذه الجمعية، جمعية المياه -المُنى- التي سحبت هذه السلعة الحيوية عبر الأنابيب إلى كل بيت، تطوعتَ لإسقاء العطشى، لا تطلبُ راتبًا ولا منصبًا ولا حتى شكورًا، بل خدمة ومحبة لشعبك ولوجه الله.
ثانيًا، التديّن الحقيقي: صائمًا مُصلِّيا الخمس لأوقاتها كنتَ، من غير رُتوش ولا شعارات، بلا تعصب أو تبجّح. تعتبرُ الدينَ -أيّ دين- وسيلةً للتقارب والتعارف والتنافس في عمل الخير. عرفتَ الحديث النبويّ الشريف وطبّقته مضمونًا لا شكلاً: "لا فضل لعربيّ على أعجميّ إلاّ بالتقوى". لا بل كان يغيظك ويغيظ رفيقةَ دربك الزوجة الفاضلة أم شفيق (وهي ابنة المرحوم الشيخ علي صالح أبو ريا)، يغيظُكما التبجّح والتباهي كأنَّ أصحابَه اكتشفوا الإسلام للتوّ، وكأن لم يكن آباؤنا وأجدادُنا، أمهاتُنا وجداتُنا يعرفونه!
ذات رحلة إلى أرض الكنانة أقنعتَني بالمشاركة فيها. وكان زعيم الأمة العربية قد رحل، وكأنه كان يدرك ما سيُفعل خلفه في هذا البلد العظيم. وصلنا في تلك الرحلة، التي كانت من أمتع الرحل في حياتي، إلى السدّ الذي أنشأه جمال عبد الناصر، وأفاضت مياهه على كل العِزَبِ والأرياف، يدَ وفكرَ ذلك القائد... تنطلق بنا الحافلة يوميًا قاطعةً المسافات البعيدة، وإذا بصوت يناديك: "أبو شفيق فش جامع هون نصلي فيه؟" تبتسم وتواصل إثراءنا بالمعلومات. وفي مرة أخرى يزعق صوت آخر سائلا أياك: "صارت الدنيا الظهر!" مع أن الساعة الذهبية التي تلمع في يده تحت شمس مصر الساطعة لا تقدم ثانية ولا تؤخر أخرى، تبتسم مرة أخرى ابتسامتك تلك. ناديتك بدوري ورجوتك ألا تتذكرني إذا ضمّت الرحلة متبجّحًا واحدًا. ابتسمتَ لي أيضًا وردَدْتَ عليَّ ردَّ عارفٍ لي: "يا ويلك من الله!"
في تلك الرحلة أقمنا بضع ليال في فندق في مدينة الغردقة الجميلة، على ضفاف بحرها الساحر وتحت سمائها التي ازدادت زرقة. قيَّلنا على عشب خميلة الفندق التي بدتْ هي الأخرى أشدّ خضرةً، تسرح في جنَباتِها طيورٌ مغرّدة وحيواناتٌ جميلة من شتى الأصناف، وتتقلّب فوق موجات بحرها الحسناوات من كل الأصقاع. يومَها فاجأتُك بالسؤال: "ألا تقول لي يا أبا شفيق ما الذي يمكن أن يكون في جنة الله غيرَ ما في هذه الجنة الأرضية؟" كنتُ متأكّدا من أنّ سؤالي لم يفاجئْك ولن يغيظَك. ومرّة أخرى، بالصبر والتسامح والابتسامة اللمّاحة أعدتَ على مسامعي ما درجتَ على مداعبتي، الإجابة ذاتها: "يا ويلك من الله." أليس هذا هو التدين الحقيقي.
ثالثًا: سياسة بدون انتساب. لم تكن منتسبًا لأي حزب سياسي، ولكنك لم تكن محايدًا ولم تختبئ وراء الشعارات، ولم تخفِ مشاعرَك الوطنيّة، فقد شبَبْنا على الطوق بعد يوم الأرض الخالد. ولطالما كان صوتك في نادي الجبهة يجلجل بآرائك السديدة والمفيدة، سواء السياسية، الاجتماعية أو الدينية. تقول كلمتَك وتمشي، كما يفعل خليل السكاكيني. لا تخشى في الحق لومة لائم أو مستبدٍّ أو ظالم. ففي القضايا الوطنية لا حياد، بل انحياز إلى مصالح الشعب. هكذا عرفتك يا أبا شفيق أمينا صادقًا وطنيًا إنسانيًا مضحيًا مربيًا. ولا يمكن لعدالة السماء إلا أن يكون مكانك بين الصدّيقين والأبرار.
أبا شفيق، إذا كانت الحياة تقاس بطولها فأنت عشتَها عرْضًا وعمقًا. أبا شفيق سنفتقدك كثيرًا.



.png)

.png)






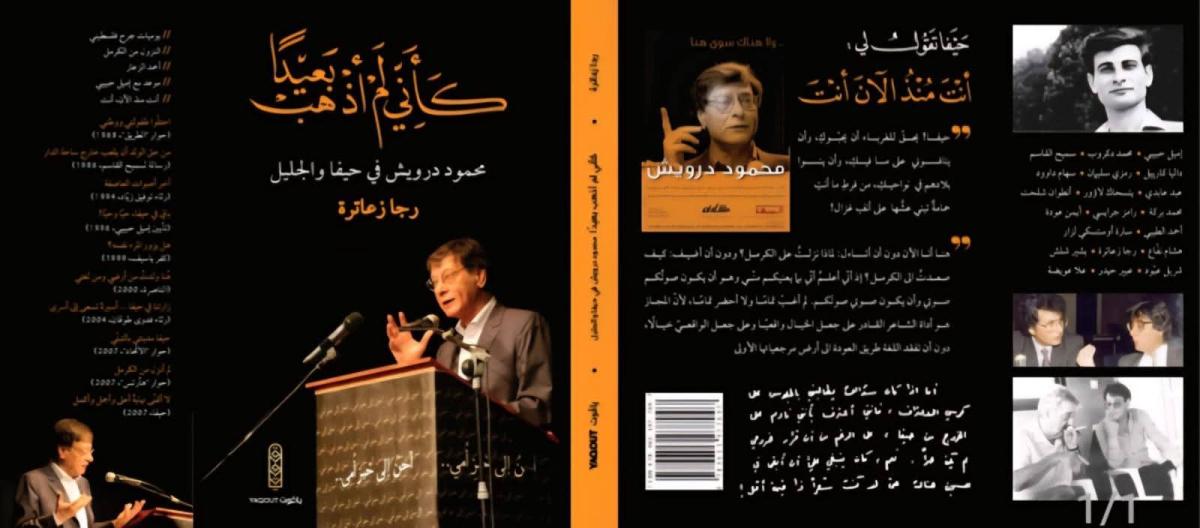
.png)

