لا أدري كيفَ ولكنْ هذا ما جرى؛ فلم أعلم بذهابك إلّا بعد أن فات على رحيلك الفَواتِ ثلاثون أصيلًا، وقد كنتُ، أصيلًا قبلها، أحكي لأحبابي عن رجل أصيل من بلادي كُنيتُه أبو هشام، واسمُه الثّلاثيّ كرسمه وقوله وفعله؛ محمّد وحُسين ونفّاع، عُروبيّ أَمَويّ وثوريّ أُمميّ، ومبدع أدبيّ محلّيّ وعالميّ بامتياز، وقائد سياسيّ وطنيّ لا يُشقّ له غبار، كان ولمّا يزَلْ ولن يزال في صفّ الدّفاع الأوّل لحُماة الدّيار. وهو فلّاح أيّ فلّاح، وهبته الأرض سَمارها وجمالها وجلالها، وحميميّتها ودَفاها، وألهمته تقواها وأظلّته بسَماها، وحكت له أسرارها وشدّت عليه إزارها، قندولًا ونَعناعًا وجُلّنارًا. كنتُ أحكي عنه بصيغة الحاضر وسأحكي عنه في أربعينه الآن، وسأظلّ، بصيغة الحاضر، أيضًا، رغم أنف حضور الغياب. آهٍ! أفمِن فَرط تواضعك كان أنْ لم أعلم بما علمتْ به الدّنيا وجاءتك تَتْرى لتودّعك؟ أم مِن فَرط ما فيّ ممّا ليس فيّ لأودّعك؟ أم لفَرطهما معًا؟ أيا ليت شِعري!
بات اسم محمّد نفّاع – مُذ كان – كناية عن أصالة هذا المكان، وكناية عن نُبل الإنسان في هذه البقعة الفريدة الخريدة الخضراء الرَّوّاء من أرض غنّاء، جليل فِلَسطين؛ فأدبه الأخضر ["Green Literature"] الطّالع من أعماق طبقات تراب بيت جنّ والزّابود لينبت عشبًا ريّانًا على صخور الجرمق، ويعلو خلف أسوارنا أعواد نَدٍّ وأشجار رَنْد، ويتعمشق جدران بيوتنا دواليَ عنب معتّق، ليعالج طبقيّة الأُمم من عُربٍ ومن عَجم؛ أدبه السّابق للتّنظير والتّرويج والتّطبيل له نوعًا أدبيًّا في شِمال الغرب وأبراج العاج؛ سرعان ما يلحظ المطّلع عليه أنّه أمام أرشيف مَلحميّ أدبيّ إبداعيّ نابض حيّ، يتكلّم فيه الشّجر والحجر والبشر بأبجديّة فِلَسطينيّة حيّة تنبض بلغة متفرّدة، في مستوى الصّياغة القصصيّة التّأريخيّة الأدبيّة الإبداعيّة الدّلاليّة الفذّة، وفي مستوى المعجميّة اللّغويّة التّخليديّة الّتي تحفظ للمكان، بكلّيّته، طبيعته وهُوُيّته وذاكرته وعروبته وهَيبته ورَونقه، تحفظ له ماضيه فحاضره فمستقبله. هذا مثلما بات اسم محمّد نفّاع – مُذ كان – كناية عن ردم البَوْن الشّاسع بين السّياسة والأخلاق؛ فمن مثل محمّد نفّاع مارس السّياسة بأخلاق ومارس الأخلاق بسياسة؟ ومن مثل محمّد نفّاع كان خطّ التّماسّ التّامّ بين الخاصّ والعامّ؟ ومن مثل محمّد نفّاع كان شِمال البوصلة عند أيّ التباس؟ هذا ومثلما بات اسم محمّد نفّاع – مُذ كان – كناية عن البحث والتّنقيب الدّائميْن عن التّليد في الجديد وعن الفريد في العديد، وعن الموروث الثّقافيّ الحضاريّ العُروبيّ في الثّوريّ الأُمميّ، وكم كان أبو هشام يُصوّبُ ويُصوّبُ فيُصيب.
ولا أُغالي إذ أقول إنّ أبا هشام، وعَدِيّ ومروان والوليد، إنّ أبا هذه الكتيبة الأَمَويّة الأُمميّة الأبيّة العصيّة، الشّجاعة المبدعة الذّكيّة الزّكيّة، الّتي رَبأت بنفسها عن غيرها من البزّات العسكريّة، الّذي التصق بالأرض أيّما التصاق والتحم بالطّبيعة من حوله أيّما التحام، والّذي كنتُ أراه حين أراه جنّة من سنديان أو كرم زيتون صُورِيّ ["سوريّ"] أصلُه ثابت في التّراب وفرُعه مَرماه السّحاب، قد أدرك بحسّه الإنسانيّ وضميره الحيّ ما تذهب إليه اليوم أرقى وأدقّ وأعمق النّظريّات العلميّة الّتي تتحدّث عن التّكافل الاجتماعيّ الحاصل بين المخلوقات من حيوان ومن نبات، وهي بذلك تنسف الكثير من داروينيّة النّشوء والارتقاء وصراع البقاء؛ فبسط الإنسان الفلّاح يده كلّ البسط، بسجيّته وحُسن طويّته وعلى طريقته وطبيعته ومِنواله، وبما تربّى وربّى، وما قعد مَلومًا مَحسورًا بل مطمئنًّا ومَغبوطًا ومسرورًا.
ستظلّ معنا يا أبا هشام برجولتك وشجاعتك وإنسانيّتك ومواقفك، بحرّيّتك وشرفك وتواضعك، بعلمك وثقافتك، بأدبك ودماثة خُلُقك، وببصيرتك الّتي تُبصر أبعدَ من عَينَيْ صَقْر، وستظلّ معنا بلغتك التّرابيّة الذّكيّة الزّكيّة، الرّشيقة الصّبيّة الفتيّة، الآسرة السّاحرة، الّتي مَن مِنّا لا يغار مِنها ولا يَغبطك عليها؛ نلمّ حبقًا ونشمّ عبقًا ونَعِفّ شَبَقًا ونسير أنَقًا ونحكي ألَقًا عن "العودة إلى الأرض" وعن "الأصيلة" وعن "ودّيّة" وعن "ريح الشِّمال" وعن "كوشان" وعن "الذّئاب" وعن "مرج الغزلان" وعن "وادي اليمام" وعن "خُفّاش على اللّون الأبيض" وعن "أنفاس الجليل" وعن "التّفّاحة النّهريّة" وعن "فاطمة" وعن "غبار الثّلج" و"جبال الرّيح"، وعن وعن، وعمّا أراك مُكِبًّا على كتابته الآن في غير مكان وزمان.
نَم قرير العين مثلَج الصّدر يا أبا هشام؛ وقد عُدتَ إلى غِمدك، إلى أرضِ وعدك وميعادك، إلى رحم أمّك الرّؤوم، سيفًا أَمَويًّا أُمميًّا مُصْلَتًا أبدًا، عتيقًا من عقيق؛ إذ "شرفُ السّواقي أنّها تَفنى فِدى النّهر العميق".
ولِي عودة منكم إليكم أيّها الأعزّة – إن شاء ربّ العزّة – للحديث، أبدًا، عن لُغتنا ونحْن.
الكبابير / حيفا



.png)

.png)






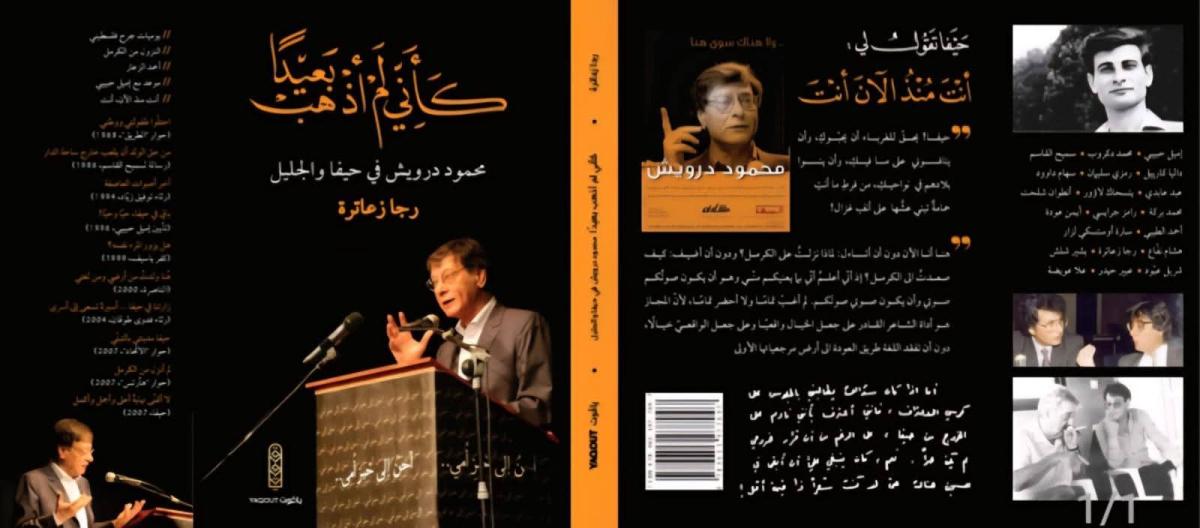
.png)


