ليس الحوار كمتن نوعيّ لسؤالات وإجابات هو ما يلفتُ في حوار د.محمّد طروس للرّوائي والإعلامي اللّامع ياسين عدنان. هو ليس السّبب الّذي يجعلنا أيضا نهتمّ بنشرهِ، بل الأجواء، خاطفة المخيّلة الّتي تتّسعُ كلّما غُصتَ في عوالم الشّاشة الصّغيرة الّتي نُعرّفها على أنّها مرناة وحسب، شاشة تصلُحُ لكلّ فُرجَةُ من كلِّ نوع. هنا يُسلّطُ الضَوء على الأشياء الصّغيرة بتفاصيلها، الأشياء الّتي تؤثِّثُ لثقافة الفُرجَة، ولغة التّواصل الشَّغِف بالفنّ وأهل الفنّ، الفنّ النّوعي الّذي يشملُ الأدب، المسرح، والفكر عموما عبر برنامج "بيت ياسين" الّذي أسّسَ لزوايا دفئهِ عدنان نفسُهُ بكلّ ما اكتسبهُ من لباقةٍ وفكر في بناء مسرح نوعيّ لثقافة متفرّدة تسطو على المُشاهد بجاذبيّة نادرة. نحنُ إذن إِزاءَ ظاهرة وليس أيّ طقس عابر لمواسم الفُرجًة، وتحليقٍ شاهق المسافة بينَ الرّؤية والرّؤيا بينهما الشّغفُ، فَراشٌ يثرثرُ ويتلوّن..
(رجاء بكريّة)
***
- ياسين عدنان، أنت تشتغل في التلفزيون منذ زمن، وتقدم البرامج الثقافية بوتيرة أسبوعية منذ 2006. حدثني عن دهشة البداية، ثم حدثني أيضا عن المسافة التي قطعتها لتتحول من منشط إلى نجم؟
أولا لنتفق على ألا نجومية هناك. في البرنامج الثقافي، النجم الحقيقي هو السؤال. السؤال والفكرة وأسلوب بناء الحلقة هم نجوم البرنامج. أمَّا الصحافي المذيع والمنشط فليس أكثر من وسيط. نجاحُه يُقاس في نظري بمدى توفُّقه في طرح الأسئلة الحقيقية وصياغتها بلغة صافية تجعل السؤال يصل واضحًا للضيف والمتفرج على حد سواء، وتجعل القلق الفكري الكامن وراء السؤال يتسرَّب إلى عقل المشاهد ووجدانه. هذا من حيث المبدأ. أما بالنسبة لدهشة البداية، فمرة أخرى، لا دهشة هناك. فأنا ابن الساحة الثقافية والأدبية، وكان لي على الدوام ذلك الشعور بالمرارة الذي يحسُّه غيري من الأدباء والكتّاب تجاه التلفزيون الذي لم ينفتح بما يكفي على الأفق الثقافي. بل وتكرَّس هناك وَهْم لدى البعض بأن طبيعة التلفزيون الترفيهية تجعله بالضرورة بعيدا عن الأفق الذي تنشده الثقافة. وكنت على الدوام متحفظا على هذا التصور ببساطة لأنني أعتقد أن للتلفزيون، خاصة حينما يكون عموميا ووطنيا، دورا تربويا تثقيفيا لا يجب التخلي عنه. لذا حينما وجدت نفسي مع بداية 2006 أمام مسؤولية إعداد وتقديم برنامج "مشارف" على القناة المغربية "الأولى" بوتيرة أسبوعية، وجدت الفرصة مواتية للمساهمة في تجسير ما كنت أتصوره هوة قائمة بين الثقافة والتلفزيون. وهكذا حرصت على امتداد 12 سنة عبر "مشارف" على إتاحة الفرصة لجمهور المتعلمين الواسع بمن فيهم أولئك الذين استقالوا من القراءة وتوقفوا عن اقتناء الكتاب لجعلهم قريبين مع ذلك من الجديد الثقافي والأدبي وجعلهم يتقاسمون مع المثقفين والأدباء المغاربة أسئلتهم وقلقهم الثقافي. كان سؤالي المركزي هو: كيف نحوِّل السؤال الثقافي إلى شأن عام لا يخص النخبة المثقفة وحدها، بل يمكن أن يشاركهم فيه عموم المواطنين - المشاهدين؟ هذا هو السؤال الذي اتخذته رهانًا لي واشتغلت لسنوات في أفقه.
- ومع ذلك، اسمح لي بأن أراجعك. فحينما أتحدث عن النجم وعن النجومية فأنا أتحدث هنا لغة التلفزيون، وأفكر بمنطق التلفزيون. التلفزيون صناعة، وهو صانع للنجوم. لهذا أكرر: كيف تحولت أثناء ممارستك للعمل التلفزيوني من منشط إلى نجم له حضور وقادر على ممارسة نوع من التأثير على جمهورك، ما أمّن لبرنامجك الأول "مشارف" الاستمرار لأكثر من عقد من الزمن قبل أن يقودك إلى تجربة أرحب في "بيت ياسين"؟
هناك أكيد أمور لها علاقة بالقبول. لحسن الحظ أن الكاميرا قابلتني بحدبٍ منذ البداية، ولم تصددني. ربما تلقائية الحوار، وأنا حريص على ألا يُفقدني الإعداد تلقائيتي وتلقائية الحوار الذي أديره. فرغم أن برنامجي ليس مباشرا إلا أنني كنت على الدوام حريصا على الاشتغال في ظروف المباشر. هكذا أضمن للحلقة تلقائيتها وطراوتها. حتى الارتباكات الصغيرة، التلعثم، أحرص عليه وأغتني به وأحوِّله إلى عنصر مُعزِّز لمصداقية الحوار. ثم هناك الإعداد الجيد الذي أشرت إليه قبل قليل. لا يمكنني أن أناقش كاتبا في كتاب لم أقرأه شخصيا. وهذا يمنحني فرصة توليد الأسئلة. والأسئلة المُولّدة التي تنبعُ من صلب الحوار أو التي تُستلُّ طرية من جواب الضيف، انطلاقا من معرفتك المسبقة به واطلاعك القبلي على إنتاجه واستيعابك لفكره ولمضامين كتابه أو كتبه، هي التي تعطي للحوار حيويته وتُخلف أثرا طيبا في نفسية المتلقي. هل يمكن اعتبار هذه العناصر مؤثرة فيما أسميتَه "صناعة النجم"؟ لست متأكدًا. إنما دعني أُضف أيضا أن هذه الصناعة تتمُّ في الغالب خارج الورشة الإعلامية حيث تُنتج المادة التلفزيونية، بل في منطقة أخرى هي منطقة التسويق والترويج والماركوتينغ. أنت فقط توفر لهم بعض الأسباب والضَّمانات. وهنا أعطي مثالا بالبرنامج الجديد "بيت ياسين"، لنتوقف عند عنوانه. فحينما اقترح عليّ المنتج الفني للبرنامج الأستاذ مشهور أبو الفتوح "بيت ياسين" عنوانًا، تهيبتُ في البداية ولم أتحمس. بل بدأت أحشدُ له ولإدارة القناة البدائل وأقترح عليهم العنوان تلو العنوان. لكن المنتج كان على العكس مني متحمسًا لهذا العنوان بالذات. كانت قناة الغد قد تعاقدت مع منشط تلفزيوني له تجربة لا بأس بها في الميدان، وهي تريد استثمار هذه التجربة بدءا بالاسم الشخصي وانطلاقا منه. إصرار المنتج الفني على هذا العنوان بالذات يعود ربما إلى كونه ابن منطق التلفزيون فيما أنا رغم كل هذه السنوات من العمل التلفزيوني أحرص على أن تظل قدماي على الدوام فوق أرض الثقافة لا تبرحُها.
- ومع ذلك، فقد برحتَ أرض الثقافة، وإلا ما كنت لتنجح في التلفزيون. لأن النجاح في العمل التلفزيوني وهو ما يوصل بالضرورة إلى "النجومية" يقوم ليس فقط على الصناعة كما ذكرت. لكن يجب أن تكون للمنشط استعدادات. طبعًا شخصية المنشط حاسمة. لكن هناك تفاصيل أخرى مثل كيف يتحكم هذا الأخير في أدائه الجسدي، الهندمة، والإيتوس بشكل عام. المؤكد أنك بذلت مجهودًا في هذا الصدد؟
هذا طبيعي. لكن المؤكد أيضا هو أنني كنت في حالة تفاوض وتجاذب دائمة ما بين المرجعيتين والخلفيتين. حينما انطلق برنامج مشارف في 2006 عشت منذ البداية قلق الهندام. لا تنس أنني كنت قادمًا من تجربة شعرية متمردة اسمها "الغارة الشعرية" التي أطلقناها في مراكش مع بداية التسعينيات من القرن الماضي. لذلك لم أكن أتخيل نفسي أطل على الناس وأنا أرتدي بذلة وربطة عنق. ما زلت أذكر مقالة مضيئة للشاعر الصديق قاسم حداد نشرها تحت عنوان "الذهاب إلى الشعر بعنق حرة". وحكى عن أول ملتقى شعري عربي يشارك فيه خارج البحرين سنة 1970، وكيف جاء إلى بيروت بربطة عنق لم يعرف كيف يرتديها، وفيما هو يبحث عمن يعينه على ذلك، نصحه شاعر سوداني بأن يترك ربطة عنقه جانبًا. فالأفضل أن يذهب المرء إلى الشعر بعنق حرة. كذلك، وجدت نفسي محرجًا وأنا ألج استوديوهات القناة الأولى الرسمية. ارتديت ربطة العنق خلال أول أيام التصوير فقط، ثم نبذتُها تمامًا. وفضّلت بدوري الذهاب إلى السؤال الثقافي بعنق حرة. هكذا بقيت وفيا لأسلوبي البسيط في اللباس: قميص فوقه سترة (جاكيت)، وسروال جينز في الغالب. أحيانًا أرتدي بذلة، لكن دائما بلا ربطة عنق. خلال 12 سنة كنت أسجل حلقات "مشارف" بملابسي الخاصة. لم يحدث أن اقترحوا عليّ في القناة جهة تتكلف بأمر الملابس كما حصل مع برامج أخرى. وهذا بقدر ما كلفني أن أجدد دولاب ملابسي باستمرار، بقدر ما حرَّرني وجعلني أحافظ على أسلوبي لا أغيره. أما الحركة، خصوصا حركة اليدين، فكان تدبير أمرها صعبا عليَّ في البداية. فأنا من النوع الذي ينخرط في النقاش بكل جوارحه، وهذا يجعلني أستعمل يدي وجسدي بكثافة خلال النقاش. عادة اكتسبناها من حلقات الاتحاد الوطني لطلبة المغرب أيام النضال الطلابي بالجامعة، ومن نقاشاتنا الثقافية المطوّلة في دور الشباب. هذا الأمر أتعبني جدا في البداية. كيف تُحيّد جسدك ويديك أثناء الحوار؟ تمرين قاس أخضعت نفسي له في السنوات الأولى كمن يُخضع نفسه لحِمْيةٍ مضطرا. ولعلي توفقت نسبيا في لجم يديَّ والحدّ من انفلات حركتي أمام الكاميرا.
- ونحن نتحدث عن استعدادات المنشط وشخصيته، يجب ألا ننسى لغة هذا الأخير ودورها في تجسير الهوة مع المشاهد خصوصا إذا كان يحمل رهان تحويل السؤال الثقافي إلى شأن عام لا يخص النخبة المثقفة وحدها. كيف أمكنك تحقيق مثل هذا الرهان في وقت نعرف فيه أن لغة الثقافة ليست دائما في متناول المشاهد العادي؟
كنتُ على الدوام مشغولا بهاجس اللغة. أردتها منذ البداية لغةً حيّةً تتيح الحوار السلس مع الجميع. رغم تخصّصي الجامعي في الأدب الإنجليزي فأنا مرتبطٌ بالعربية وآدابها قارئا وكاتبا منذ اليفاع. إنما في البرنامج كان عليَّ أن أقدِّم مُقترحي الخاص: بلورة لغة إعلامية رشيقة لا تتنازل عن فصاحتها ولا تتعالى مُتفاصحةً على المشاهدين.
لذا كنت على الدوام أدافع عن العربية بأسلوبي، دون مزايدة ولا ادّعاء. لست أصوليًّا لغويًّا، وأنبذ الانغلاق. أؤمن أنّ اللغات حيّة، وأعتبر التفاعل بينها أمرا طبيعيا بل ومطلوبا. فهناك أكثر من 1600 مفردة فارسية دخلت إلى قاموس اللغة العربية، بل حتى القرآن الكريم الذي نزل بلسان عربي مبين يتضمن أكثر من أربعين كلمة فارسية. مما يعني أن الصفاء اللغوي الخالصَ محضُ وهمٍ ومجرّدُ أسطورة. لذا لا أعرف شخصيا كيف أغلق على "عربيتي الفصحى" النوافذ، ولا أريد حمايتها من لغتي المغربية الدارجة، حيث التلاقي أهلٌ والتساكن سهلٌ بين الأمازيغية والضّاد ولغات الجوار.
لكن لنتفق مع ذلك على أن المعركة الحقيقية التي تبقى أشقَّ وأكثر تعقيدًا هي كيف نؤمِّن للمثقفين - من حملة الأقلام ومنتجي الأفكار وصُنّاع الوجدان - حقّهم المشروع في التواصل مع قرّائهم، الذين لا يقرؤون، عبر الوسيط المتاح والأكثر ديمقراطية: التلفزيون؟ كيف تساهم برامجنا في بلورة لغةٍ قادرةٍ على النفاذ إلى قلوب الناس وعقولهم؟ لغة تختلف عن لغة الكتب والأطاريح الجامعية. لغة رشيقة لا تتعالى على المشاهدين. خصوصا وأنني مقتنع تماما بأنه عبر التلفزيون لا الكتب والندوات يمكننا أن نحوِّل الشأن الثقافي اليوم إلى شأن عام، وعبر التلفزيون والإذاعة قبل الصحف والمجلات يمكن للمثقف أن يساهم في خلق نقاش عمومي حقيقي في المجتمع. لكن، لتحقيق هذا الهدف، يجب أولًا تحرير الخطاب من الأجهزة المفاهيمية ولغة التخصص والمرجعيات والإحالات والأسماء الطنانة التي يتغيّى منها البعض إبهار المشاهدين فيما هم في الواقع يعرقلون التواصل معهم ويدفعونهم دفعا إلى تغيير القناة. نوقف التسجيل أحيانًا حينما نحس بأننا ابتعدنا عن الفكرة وبدأنا نؤثث لحظة النقاش بالمفاهيم والإحالات وأسماء المفكرين. الجمهور العام يريد أفكارًا واضحة. هو مستعد لأن يبذل مجهودًا، لكن لا يجب أن نطرده خارج مدار النقاش بالإغراق في اللغة الأكاديمية أو بالانغلاق داخل لغة بالغة الجزالة. من المهم أن نترك النوافذ مفتوحة على عربيتنا لكي يجدها الجمهور قريبة في المتناول. إن اللغة الوسطى التي بلورتها نشرات الأخبار الإذاعية والتلفزيونية هي مكسبٌ علينا المحافظة عليه. هذه اللغة العصرية البسيطة الرشيقة المُيسَّرة التي بلورها الإعلام تبقى لغة أصيلة خرجت من رحم العربية الفصحى لكنها تطوّرت عبر الاحتكاك بالسجلات الشفهية واللغات الأجنبية المتداولة في بلداننا. وطبعًا، لا ضرر في أن يسترسل الكلام الفصيح ما لم يكن الاسترسال مفتعلا، ولا بأس من الاستطراد بلسان عامّي، فقد يُسعِف القول الدّارج بما لا تستطيعه المعاجم والقواميس. لكن، لنتفق على أن الدّارجة والفصحى والعربية الوسطى التي بينهما تبقى تنويعات داخل مكوّن واحد، ذاك أن لغة الشعب تبقى امتدادا للفصحى، فلا قطيعة هناك. وكل تجريم لمثل هذا التفاعل يبقى مصادرةً على المطلوب ومعاندةً للطبيعة: طبيعة اللغة ذاتها.
- طبعا، هناك وعي نظري واضح بالمسألة اللغوية، وفعلا قوة برامجك تتجلى أيضا في تلك اللغة الأنيقة غير المتعالية كما وصفتها. لكن اللغة بالنهاية معطى ثقافي. والتلفزيون في رأي البعض وسيلة ترفيه لا أداة تثقيف. كيف دبّرت هذا التباعد بين الثقافة والتلفزيون أنت المنشغل بالثقافة المشتغل في التلفزيون؟
صحيح أن العلاقة بين الثقافة والتلفزيون ملتبسة، وتجسير الهوة بينهما ليس مسألة سهلة بسيطة. لكن مع ذلك يجب الانطلاق من مفارقة أكثر غرابة في مجتمعنا العربي. وهي أنه بقدر ما تُسرف شعوبنا في استهلاك الصور وبشراهة، تتعامل النخبة المثقفة لدينا مع الصورة ووسائطها بالكثير من الحيطة والحذر، وأحيانا بتجاهل. وإذا كان البعض يتفادى التلفزيون، خصوصا القنوات الوطنية، بسبب شُبهة تماهيها مع الخطابات الرسمية، فإن من مثقفينا العرب من يرى أن التواصل عبر التلفزيون من حيث المبدأ يشكل إساءة إلى نُبل الكلمة ونيلا من شرف الثقافة. هكذا تحافظ هذه الفئة من المثقفين على نقائها باتقاء الظهور على الشاشة دون أن تطرح للتفكير إمكانية المراهنة على هذا الوسيط الحيوي في معركتها الأساسية، معركة دعم دينامية التثقيف والتحديث داخل المجتمعات العربية.
لقد انتقلت شعوبنا العربية مع الأسف من الشفاهية إلى استهلاك الصورة قبل أن تكتسب عادة استهلاك الصحيفة والمجلة والكتاب. لأجل ذلك سرعان ما اكتسح التلفزيون المشهد ليصير المرجع الأول لدينا، بل والوحيد بالنسبة للفئات الأمية من مجتمعنا العربي. وحينما يغيب المثقف عن هذا المعترك، فإن الجوّ سيخلو طبعا لغيره، وكلنا يعرف من يصول ويجول على شاشاتنا العربية اليوم ومَن اكتسح المشهد.
وإذا كانت فئة من المثقفين تتحاشى الظهور التلفزيوني، فإن المثقف الذي اقتنع بأهمية هذا الوسيط وأولوية التواصل مع الناس عبره لا يجد الطريق معبّدة نحو عقول المشاهدين. فزمن الثقافة في التلفزيون محدود أصلا، ومقصي إلى فترة الجزء الثاني من السهرة وأحيانا إلى منتصف الليل بعيدًا عن فترات الذروة التي ينذرها التلفزيون لفئات أخرى محظية عادة ما تستفيد من الزمن التلفزيوني بحاتمية لافتة: ممثلين وفكاهيين حتى ولو كانوا مبتدئين، مطربين ومطربات حتى ولو كانوا من الدرجة الثانية، سياسيين وحزبيين حتى ولو كانوا مجرد تجار انتخابات. لكن منطق التلفزيونات العربية قدَّر أن هؤلاء أقرب إلى الوجدان العربي وأقدر على مخاطبته من نخبة ثقافية وأدبية وفكرية "متحذلقة" تدّعي أنها هي من يصنع الوجدان. هكذا يخصِّص التلفزيون العربي لمحظيِّيه مساحة البث الكافية ليتواصلوا مع مشاهديهم الأعزاء في أوقات الذروة، وهو أمر بقدر ما يحبط الأدباء والمفكرين والفاعلين الثقافيين في بلادنا العربية يعكس توجيهًا للمشاهدة وتبخيسا لصُنّاع الوجدان من أدباء ومبدعين ومثقفين.
وعموما التلفزيون اليوم سلطة حقيقية وسط مجتمعات يجب أن نعترف بأن حسّها النقدي ضعيف. لذا فالنماذج التي تسوَّق في فترات الذروة هي بالتأكيد، في تقدير العموم، أهمّ من تلك التي لا تظهر إلا في منتصف الليل. بغضِّ النظر عن الفكرة والخطاب والرؤية، فزمن البث ومساحته سلطتان حاسمتان تُرجِّحان الكفة لصالح فئات ضد أخرى.
- لكن، برأيك، من سمح للتلفزيون بأن يُعلي من قيمة المشتغلين بالتمثيل مثلًا ويقلل من شأن المثقفين عبر اختيارات البرمجة والبث؟
طبعا للتلفزيون حساباتُه المشروعة، فالمنافسة على أشدِّها بين القنوات، والمُشاهد ملول متبرِّم وشدُّ انتباهه وضمان ولائه يحتاج إلى مجهود جبار. لأجل ذلك تبذل إدارات التلفزيونات العربية قصارى جهدها لكي تظل دائما عند حسن ظن "مشاهديها الأوفياء". ولأن الوفاء اليوم صار قابلا للقياس، فللمتابعة نِسَبٌ معلومة والمُعلِنون يتعاملون مع المحطات التلفزيونية بناء على هذه النسب لتتطور الأمور باتجاه مقاربة تشاركية صار معها المعلنون ينتجون برامجهم أحيانا أو يفرضون نجومهم خصوصا في الدراما والكوميديا الرمضانية، وكل ذلك في سياق عربي نعرف أعطابه السياسية والاقتصادية وتردِّي وضعه التربوي والاختلالات التي طالت منظومة القيم لديه.
إن التلفزيونات التي نحكي عنها عمومية في الغالب ويسري عليها ما يسري على المرفق العمومي، لذا فهي مطالبة بما نطالب به باقي المرافق العمومية من خدمات يجب تقديمها للمواطنين لتبرير وجودها وتسويغ ما تحصل عليه من دعم مالي حكومي مموَّل من جيوب دافعي الضرائب. لذلك نتجرّأ على طرح السؤال التالي: ماذا عن دور الوسيط التلفزيوني في بلدان تحتاج إلى تأهيل حضاري وتنمية بشرية كبلداننا؟ أوليس مطالبا بالاضطلاع بمهام الإعلام والتربية والتثقيف، إلى جانب الترفيه طبعا؟ السؤال مزعج والتحدي صعب، لذلك فضلَتْ أغلب القنوات العربية التعامل معه بمنطق "كم من حاجة قضيناها بتركها". هكذا تحوَّلت الشعوب والمجتمعات إلى "مشاهدين أعزاء" الكل يخطب ودهم بالحق والباطل، وتكرست هيمنة شركات الإعلان وشركات الإنتاج المرتبطة بها مُوَطِّدة حضورها في كواليس المحطات العربية لتفتح إنتاجنا التلفزيوني على أفق تجاري محض. فتغيرت المعايير لتُتوَّج نسبة المشاهدة قيمة القيم، بل هي التي تحدِّد قيمة المنتوج التلفزيوني، ليصير المضمون الجاد والعمق الفكري والوظيفة التربوية مجرد كلام فارغ لا يصمد أمام ديكتاتورية نسبة المشاهدة وحمِيَ وطيس المنافسة بين القنوات وها نحن نلهث جميعا باتجاه المجهول.
وحتى الآن ما زلنا لم ننتبه إلى أن هذه المنافسة تتمُّ أصلًا في المعترك الخطأ. فالتنافس على الرفع من نسب المشاهدة بجميع الوسائل والمواد حتى لو كانت خردة مسلسلات مكسيكية رخيصة أو مجموعة من السيتكومات الملفّقة، والفوز بأكبر نصيب ممكن من كعكة الإعلانات حتى ولو جاء ذلك على حساب هوية القناة والتزاماتها إزاء المجتمع، مثل هذه المنافسة لا نجد فيها رابحًا. لأننا ببساطة قد نكسب المزيد من المشاهدين وبالتالي المزيد من الإعلانات لكننا نخسر الإنسان. وأعتقد أن قنواتنا الوطنية والعربية، خصوصا تلك المُلزَمة بواجب الخدمة العمومية أو المشغولة بهواجس التحديث والتنوير، معنية بمصاحبة المشروع المجتمعي الشامل في مجال التنمية البشرية. إذ لا يمكن للدولة أن تفتح أوراشا اقتصادية وتنموية، خصوصا على مستوى التنمية البشرية، دون أن يساهم الإعلام - والتلفزيون بالخصوص - في مصاحبة هذه الأوراش بمجهود محسوس في مجال تأهيل الإنسان على المستوى الثقافي والتربوي والقيمي. وهنا لا أتصوّر أن بإمكان المسلسلات المكسيكية أن تفي بالغرض مهما علت نسب مشاهدتها. لا بد من إنتاج أصيل أوّلًا، ولا بد من مواد وفقرات أكثر جدية ومسؤولية: دراما وطنية عميقة وذكية تنصت لتحولات المجتمع وتفتح مشاهديها على خيارات هادفة وتُروِّج من خلال أبطالها لقيم إيجابية سواء انتمت إلى المنظومة القيمية الأصيلة كقيم التكافل والتآزر والقناعة، أو إلى المنظومة الحديثة بكل ما تكثفه من قيم المواطنة والحرية والاختلاف واحترام الآخر. برامج إخبارية تقارب مادتَها بموضوعية ومهنية وبروح تحليلية نزيهة. وبرامج ثقافية تصدُر عن اقتناع بأولوية الثقافة في معركة التنمية البشرية وبناء المواطنة الفاعلة وتأخذ بعين الاعتبار أهمية وحساسية دور الوسيط التلفزيوني في تثقيف المجتمع خصوصا مع اكتفاء الغالبية العظمى من مواطنينا بالتلفزيون كوسيط يقدّم الأخبار والمعرفة في ظل ما ذكرناه من تراجع للقراءة التي لا يتجاوز متوسطها لدى الفرد العربي ست دقائق سنويا مقابل 200 ساعة بالنسبة للفرد الأوروبي.
- لأجل ذلك يصير تعزيز البرمجة الثقافية في التلفزيون مطلبا حيويا؟
بالفعل. يجب تعزيز البرمجة الثقافية في كل التلفزيونات العربية الواعية بدورها الحضاري والتربوي. يجب أن تكسب الثقافة مساحات جديدة على الشاشة لأن التلفزيون كوسيط صار يلعب اليوم دورا محوريا في صناعة الرأي العام والوجدان الجمعي. وعلينا أن نختار، هل نريد شعوبا يقظة لها حد أدنى من المعرفة والوعي والقدرة على التمييز؟ أم نريد كائنات استهلاكية هشة لا مناعة لها ومستعدة لابتلاع أي خطاب مهما كان سطحيا وحتى لو كان خطيرا وتتلقى الفرجة السطحية والتفاهات برضى وتسليم؟ عمومًا حاجة التلفزيون إلى الثقافة وأهمية الوسيط التلفزيوني في الترويج للثقافة والخطاب الثقافي يفتحنا على نقاش طويل وجدّي نحن مهزومون فيه إذا ما واجهَنا خبراءُ نسب المتابعة بمنطقهم وحساباتهم وما يبرِّرون به اختياراتهم التجارية المحضة من إكراهات. لذلك نحتاج وباستعجال إلى قرارات سياسية شجاعة من طرف الحكومات إذا كانت لهذه الأخيرة مشاريع مجتمعية حقيقية وكانت تحتاج شعوبها فعلا في معارك المستقبل وفي تحديات بناء الإنسان.
لقد شاهدنا كيف لعبت بعض الفضائيات العربية لعبة الإعلام السياسي التحريضي ونجحت في ذلك سياسيا وتجاريا، وكيف ردت عليها فضائيات أخرى مهمة بالمسلسلات المكسيكية الماراطونية المُدَبلجة وهو ما وجدت فيه بعض الأنظمة السياسية والقنوات الرسمية التابعة لها فرصة لاسترداد المشاهدين خصوصا من النساء وفئة الشباب. لكن، أعتقد أن الوقت قد حان لكي يجرب التلفزيون العربي طريقا ثالثا لا تحريض فيه ولا استبلاد.
إن الثقافة هي عنوان هذا الطريق الثالث. لكنّ جزءا مهما من الإعلام المرئي العربي يعيش في انفصال تام عن أية خلفية ثقافية، وبدأ يبتعد بالتدريج عن مقاربة قضايا السياسة والمجتمع والفن انطلاقا من منظور ثقافي. رغم أن للثقافة دورا جوهريا في تأطير المجتمع وتخليق الحياة العامة وتحصين المجال السياسي من التطرف والمذهبية المنغلقة، وكذا في إضفاء المعنى والروح والدلالة على الإنتاج الفني بمختلف أصنافه. والإحساس بأن بإمكاننا اليوم أن نتطور ونتقدم ونساهم في تحديث الفن والمجتمع والعمران والسياسة بدون حاجة إلى الثقافة وبدون خلفية ثقافية تؤطر ذلك كله أمر يدعو فعلًا إلى القلق.
هناك هوة سحيقة اليوم بين النخبة الثقافية والمجتمع. والتلفزيون العمومي الذي يُفترض فيه أن يضع إمكاناته ومساحات بثه في خدمة المواطنين لا المعلنين مُطالبٌ بفسح المجال أمام المثقفين للمساهمة في تأطير المجتمع وتوعيته فكريا وتحصينه ثقافيا وتفتيح مداركه وتعزيز قدراته على النقد والحوار. هذه مسؤولية التلفزيون العمومي وواجبه كمرفق يقدم خدمة للمجتمع، ومسؤولية المحطات التلفزيونية الخاصة التي ما زالت تؤمن بأن للتلفزيون دورًا في التحديث وبناء الإنسان. فلماذا نجد كل صعوبات الكون في تنبيه التلفزيونات العربية إلى أدوارها البديهية، وفي إقناعها بأنها مطالبة باحتضان مثقفي الأمة وإعطائهم الفرصة ليطلوا عبر شاشتها ويُسمِعوا أصواتهم من خلالها؟
إن الإعلام بشكل عام، وليس التلفزيون فقط، يتحمل مسؤولية كبرى في لعب دور الوساطة ما بين الثقافة والأدب من جهة والمجتمع من جهة أخرى. لكن المشكلة هي أن الإنتاج الرمزي لا يحظى بالاعتبار اللازم في قنواتنا العربية لأن منطق الاستهلاك لا يعترف بما هو رمزي. والإنتاج الثقافي والإبداع الأدبي يدخلان في إطار الإنتاج الرمزي الذي يساهم في صناعة الوجدان العام ويرفع من تحضُّر المجتمعات. والأدب بالخصوص ما زال مظلومًا في مجتمعاتنا العربية. فلا أحد من خبراء نسب المشاهدة يبدو مستعدا لاستيعاب أولوية أن يساهم التلفزيون في دعم الأدب والإنتاج الأدبي وأن يعتبر ذلك جزءا من دوره في بناء مجتمعات متزنة، منفتحة، بل وحالمة أيضًا بالمعنى المنتج الخلاق لهذه الكلمة.
وإذا كان المثقفون العرب اليوم من مختلف الأقطار يطالبون بمضاعفة المادة الثقافية وتعزيزها بمساحات أوسع في خرائط البرمجة وأيضا بتوقيت أفضل يتيح لهم التواصل مع أكبر عدد من مواطنيهم، فإن الحاجة إلى الثقافة في التلفزيونات العربية تتعدّى هذه المطالب إلى تحديات أكثر جوهرية. فما نحتاجه اليوم باستعجال هو توسيع مجال الثقافة أوّلًا لتتجاوز حدود الأدب والإنتاج الفكري والفلسفي. نحتاج فعلا إلى إخراج البرامج الثقافية من شرنقة النظرة الأدبية الضيقة إلى الأفق الثقافي الواسع. فإضافة إلى الانشغال بالأسئلة الأدبية والإبداعية والفكرية، من المهم أن تتحوّل البرامج الثقافية إلى منابر يمارس من خلالها الفاعلون الثقافيون في البلاد العربية حوارهم مع المجتمع وقضاياه. فتبنّي المقاربة الثقافية لقضايا المجتمع يمكنه أن يحتل مكانة محورية في صلب السياسة التحريرية لبرامجنا. نحن في أمس الحاجة إلى صوت المثقف ليدلي بدلوه في الشأن السياسي والديني والاقتصادي والاجتماعي، وليقترح تحليله الخاص لمختلف الظواهر السياسية والاجتماعية. وهناك اليوم العديد من الموضوعات المطروحة للنقاش المجتمعي في العالم العربي نتصوّر أن المقاربة الثقافية قد تُنْصِفها أكثر مما تفعل لغة السياسة وذرائعية السياسيين. بل حتى ونحن نعيش الحراك، وكنا قبل سنوات في قلب حراك ديموقراطي قوي في إطار ما سمي بالربيع العربي، حينها اكتشفنا كم نحن في حاجة ماسَّة إلى صوت المثقف لصناعة رأيٍ عامٍ يعرف ما يريد أيضًا وليس فقط ما لا يريد. إن الديمقراطية أفكار ورؤى ونقاش، وهي تصدر عن الفكر وتأتي من الكتب مهما تغزَّلنا بحيوية الشارع. إن الديمقراطية حوار أفكار وصراع مشاريع مجتمعية وبناء مؤسسات، قبل أن يكون غضبا وشعارات. والتلفزيون الذكي هو الذي يستطيع في مثل هذه الظروف الخاصة وفي لحظات التحول الدقيقة إتاحة المجال أمام النقاش المعرفي بطريقة تخدم إعمال العقل وتعيد للتفكير النقدي موقعه داخل الفضاء التلفزيوني العمومي وداخل المجتمع، والمراهنة على الحوار لكي نذهب به أبعد من الشعار. (يتبع)



.png)

.png)






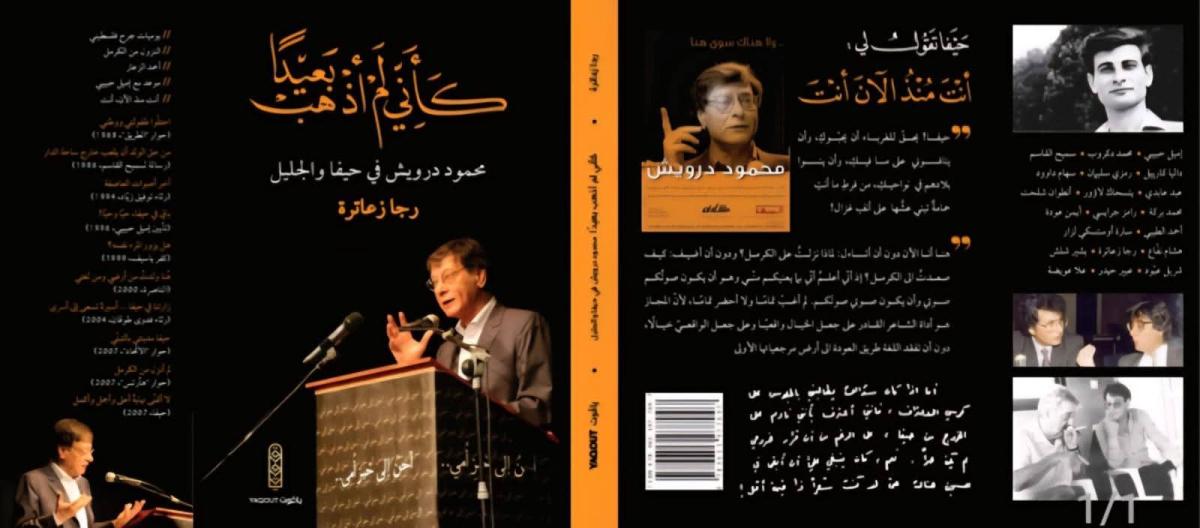
.png)

