ملخص
يتعمّد الكاتب وجيه ضاهر في مجموعته القصصية، "الطيور تعود إلى أعشاشها" (2022) أن يحكي قصة الفلسطيني الذي يواجه المحتلّ يوميا، إذ حيثما تتنقّل الشخصيات فهناك جنود وملاحقات ومواجهات. تمتح القصص أحداثها من هذا الواقع الذي يبدو للقارئ أن لا واقع سواه، حيث الفلسطيني يجترح المعجزات ويسطّر تاريخا خاصا به في قدرته على البقاء فوق تراب أرضه، في ظل ظروف قاسية ومؤلمة وموجعة، أقرب إلى العجائبية منها إلى الواقعية. أو بكلمات أخرى: باتت العجائبية هي الواقع الحقيقي للفلسطيني. أما كل ما يتعلق بحياة الفلسطينيّ وأموره اليومية فهي تسير في ظل هذه المواجهة.
آثر ضاهر أن يكتب بأسلوب يراه الأكثر ملاءمة لهذا الواقع، معاينة الداخل أكثر مما هو معاينة المرئي، فما المرئي من المشاهد التي تُطرح أمام المتلقي سوى آلة تعكس ما يمور في النفس من مشاعر وأحاسيس، ومن أفكار متلاطمة ومتعاركة تدق جدران الرأس لتخط صورة أو مشهدا من واقع مركّب ومعقّد، فيه من الأمل بقدر ما فيه من الألم، وفيه من الانطلاق بقدر ما فيه من سلاسل ومن قيود. فما نراه من تصرفات الشخصيات هو جزء بسيط مما يدور في داخل النفس.
يبدو واضحا ميل الكاتب لاتباع أساليب جديدة مغايرة عن أسلوب كتابة القصة العربية التقليدية، فنراه يميل إلى تهشيم الزمن، وتوظيف أساليب تيار الوعي وتقنياته، والميل نحو الفانتازيا والغرائبية، والتركيز على الداخل أكثر من الخارج.
اختار الكاتب للمجموعة القصصية عنوانا يبدو مباشرا ومألوفا، يوحي بالعودة الطبيعية إلى الدفء، والهدوء والسكينة والاستقرار. لكنّ الفلسطينيّ، كما تكشف المجموعة القصصية، لا يعود إلى عشّه عودة طبيعية، ولا يحظى بهذه الحياة التي تتمتع بها الشعوب الأخرى، ولكنه يتابع الحياة.
مقدمة
تعددت المناهج التي تتناول النص الأدبي بالدرس والتحليل، ما يعنينا منها جميعها هو كشف جماليات النص، والبحث في جديد هذا النص، وما سيقوله وكيف، ومدى تقاطعه مع ما سبقه. يعترف بعض كبار المنظرين مثل أمبرتو إيكو أن تحليل النص الأدبي عملية معقدة وشائكة جدا، قد يعجز كبار الدارسين من التأكد من صحة ما يرونه، فنادى، عبر دراساته، إلى أهمية تعدد القراء التي تتيح لقارئ ما أن يرى ما لا يراه آخرون، وبالعكس، كما تحدَّث عن القارئ النموذجي القادر على أن يكون ندا للمؤلف "... ولهذا يتوقع (المؤلف) قارئا نموذجيا يستطيع أن يتعاون من أجل تحقيق النص بالطريقة التي يفكر بها المؤلف نفسه، ويستطيع أن يتحرك تأويليا كما تحرك المؤلف توليديا". (إيكو، ص35) أما رولان بارت فقد احتار من أي نقطة يبدأ أثناء عملية التحليل؟ وكيف يبدأ؟
لا توجد قوانين راسخة تلزم الباحث أو الناقد كي يسير بحسبها ملتزما بها التزاما "دينيا" متزمتا، وقد يرى أنّ قصة ما لا ترضي ذوقه، فيما يراها غيره قصة ناجحة. فقد تبنّى بعض المنظرين الكبار فكرة معينة ثم قاموا بتغيير رؤيتهم بناء على التجربة، وما فكرة "موت المؤلف" (نظر: Barthes, The Death of the Author, pp. 142-148) سوى خير شاهد على ما نقول. لكني أومن أكثر من أي أمر آخر أنّ هناك أصولا لكل نوع أدبي أو فني، وأن هذه الأصول يمكن تعديلها وطرحها بأساليب مختلفة تحمل من التشابه مع غيرها بقدر ما تختلف. فكلّ نص له ميزة/ميزات معينة تفرض ذاتها أكثر من غيرها.
تحدث بعض الدارسين عن عملية التفاعل التي تنشأ بين المتلقي والنص كدافع هام نحو متابعة القراءة، إذ يرى وولفجانج إيزر في كتابه "فعل القراءة" أنّ العمل الأدبي قائم على قطبين، أطلق على أحدهما القطب الفني وهو نص المؤلِّف، والقطب الجمالي وهو "التحقق" الذي ينجزه القارئ. (إيزر، ص12) فقد يثير مؤلَّفٌ جديد المتلقيَ/الباحث، مما يفرض عليه البحثَ عن مسبّبات هذه الإثارة، ودوافع تفاعله معها، وقراءة النص عبر آليات تتيح له رؤية صلابة النص وترابط الجزء بالكل والكل بالجزء. فالتفاعل الذي تحدَّث عنه إيزر هو تفاعل متبادل، ولا يقتصر على القارئ المتلقي. النص مخلوق قام به مؤلِّف ما، ويبقى هذا النص ميتا حتى يقوم القارئ بإحيائه دون تناسي دور المؤلِّف، من هنا فإني أرى أن ما أقوم به هنا هو عملية "التحقّق" التي ذكرها إيزر، ولم يتأت ذلك إلا من خلال هذه المواجهة بيني وبين النص التي ولّدت شرارة التفاعل، وقد وجدتُ أنّ هذا المنجز جدير بالبحث والدراسة.
كتاب "الطيور تعود إلى أعشاشها" مجموعة قصصية للكاتب الدكتور وجيه ضاهر، المحاضر الجامعي، والباحث في طرق تدريس الرياضيات. بالرغم من أن هذه المعلومة لا تزيد ولا تقلّل من شأن المنتوج الأدبي، إلا أني أعترف أنّ هوية الكاتب وثقافته وعلومه تهمني وتثير لديّ بعض التساؤلات قبل ولوج النص وقراءته. فقد علمتنا التجارب أنّ الكاتب لا بدّ أن يستفيد من علمه ومن ثقافته، فقد نجح الأديب يوسف إدريس، على سبيل المثال، في رسم صورة المرأة التي أجهضت جنينها في رواية "الحرام"، نظرا لكونه طبيبا، ووظف تشيخوف علومه الطبية في رسم الشخصيات، وتمكن توفيق الحكيم من عرض صورة لسكان الريف وهم يواجهون القوانين المجحفة في "يوميات نائب في الأرياف"، نظرا لدراسته "القانون"، لكنهم ما كانوا لينجحوا جميعا لولا قدرتهم على التخييل، والأمثلة على ذلك عديدة. الحقيقة الوحيدة التي أستطيع أن أقولها: إن ضاهر كاتب يتّبع طرقا مغايرة في كتابة القصة القصيرة.
إن الكتابة فعل عاطفة وعقل وخيال، فالعاطفة والخيال عاملان مترابطان جدا لا يمكن الفصل بينهما بحيث تتحرك العاطفة تماثلا وتماهيا مع مشهد أو فكرة، ثم يقوم العقل بهندسة العاطفة ومدها بالعمق وطرحها مدعمة بتخييل يأخذ الفكرة من جذورها ومن منبتها لتخاطب القارئ وتخترق وجدانه. فإن كانت العلوم عامة، والرياضيات خاصة، لها إبداعاتها وإنجازاتها في خدمة حياة البشر فإن وجيه ضاهر الباحث في علم تدريس الرياضيات قد أدرك دور الكلمة الأدبية في خدمة البشرية. فأي أساليب اتبع؟ وهل نجح في ذلك وكيف؟ سنحاول الرد على هذه التساؤلات وعلى التساؤلات التالية التي نراها هامة في كل مرة نتعامل فيها مع نص جديد: هل يجب تناول أي مُنتَج أدبي بناء على ما تقوله النظريات الأدبية؟ أم يجب الاعتماد على الذوق الأدبي الذي يتحلى به الباحث بعد التجريب والمران؟ أم الاعتماد على كليهما معا؟ وربما السؤال الأهم الذي يجب أن يطرح هو: هل عملية تناول نص ما بالدرس والتحليل عملية سهلة؟ وهل تنطبق مقاربة نص ما ومعالجته على كل النصوص؟ إذا كان ذلك كذلك فأين الفرادة؟
تكثيف القصّ وتهشيم الزمن
إن عملية قراءة أي نص تختلف من قارئ لآخر، كما ذكرنا، وذلك وفق ثقافة المتلقي والهدف الذي ينطلق منه، فهناك من يقرأ من أجل المتعة، وهناك من يبحث عن الاستفادة من المعلومات الجديدة التي يزوِّدها به النص، وهناك من يبحث عن فرادته، وعن اللغة ومستوياتها، وعن مدى نجاح الكاتب في جذب القارئ وتفاعله عبر بنائه النص بناء فنيّا محكما، متوقفا عند التقنيّات التي يوظفها الكاتب.
يلفت نظر القارئ أنّ الكاتب وجيه ضاهر لا يلتزم بالمبنى الكلاسيكي، وذلك منذ القصة الأولى، "الصبي والأطفال"، إذ يعمد إلى عملية تهشيم الزمن، وتوظيف تقنيّات حداثية تساهم في ذلك: الذكريات، الفلاش باك، المونولوج، المناجاة، الأحلام، الهلوسات والتداعي، (للتوسع انظر: غنايم، تيار الوعي في الرواية العربية الحديثة) مما يساهم في تغطية مساحة زمنية أوسع، عبر القليل من الكلام والكثير من المعلومات. يساعد في ذلك، أيضا، توظيف أكثر من ضمير وأكثر من زاوية نظر، كما يُبيّن لنا الاقتباس التالي: "الساعة الثامنة مساء من ذلك اليوم نفسه، يتسلق صبي عمود الكهرباء نفسه [...] يؤلمه احتكاك جسده بالعمود. ينرفز بسبب الأعمدة الطويلة. لكن الأعمدة الطويلة أفضل لتعليق الأعلام عليها، يهمس لنفسه، يرفرف عليها عاليا ويُتعب الجندي الذي يصعد العمود لينزله. ترى هل يجبر الجنود عندئذ أحد سكان المخيم على تسلق العمود وإنزال العلم؟ لن يقبل الشباب إنزاله وقد يهاجمون الجنود أو يهربون من وجوههم [...]. ما أجمل الخالة أمينة وهي تتعشبق على عمود الكهرباء في المرة الأخيرة التي ارتفع بها العلم عاليا عاليا". (ص16)
نلاحظ أعلاه أن الكاتب يتنقل بين الضمائر بسلاسة، فضمير المتكلم يتماشى أكثر مع تقنيّات تيار الوعي الذي يساهم في انسياب الأفكار والأحداث وتداعيها، وكشف ما يدور في ذهن الشخصية، عبر الفلاش باك والمونولوج والمونولوج المروي/المسرود (لكن الأعمدة الطويلة أفضل لتعليق الأعلام عليها، يهمس لنفسه، يرفرف عليها عاليا)، وهو مونولوج يمتزج فيه صوتان: صوت السارد وصوت الشخصية، والكلام المباشر وغير المباشر. هذه التقنيات التي أشرنا إليها أعلاه، مجتمعةً، تسهم في التنقل بين الماضي والحاضر، وفي بلورة الفكرة المركزية للقصة، بعيدا عن المباشرة. أما ضمير الغائب فيساعد على كشف الصورة الخارجية عبر السارد الرئيسي، وبالتالي يقف القارئ وجها لوجه أمام صوتين، لا صوت واحد: أحدهما يعبّر عن الداخل والآخر عن الخارج، فتكتمل الصورة، حتى لو حمل الصوتان نفس الرسالة، فإن الواحد منهما يدعم الثاني، في مواجهة الصوت الثالث؛ صوت جنود الاحتلال. (حول تعدد الأصوات انظر: باختين، الخطاب الروائي)
من اللافت، فعلا، أنّ القارئ يتابع الأحداث كلها من أولها حتى نهايتها، ويطّلع على المواجهات مع الجنود، دون أن يكون هناك وجود فعلي لهم، فهم موجودون، حتى أثناء غيابهم، في ذهن الطفل الذي يصرّ على التحدي ورفع العلم وكيد هؤلاء الجنود الذين قد يظهرون في أي لحظة. ولكي يضفي على القصة ثوب الواقعية عمد الكاتب إلى توظيف الأغاني التي ينشدها الأطفال في مناسباتهم لتحمل صوتهم، صوت المستقبل، وهم يواجهون آلام الحزن والفراق، دون أن يفقدوا الأمل، فكانت أناشيدهم أشبه بأناشيد الكوروس في المسرح اليوناني القديم تضيء بعض الزوايا الغامضة، وهي هنا تحمل صوت الناس كل الناس.
ساهمت هذه التقنيّات، في تكثيف الأحداث، وفي تغييب شبه كامل للحوارات المباشرة، من ناحية، وفي الابتعاد عن السرد الكلاسيكي الذي يلتزم بتنظيم الزمن وفق منطق التسلسل من الماضي فالحاضر، من ناحية أخرى، حيث يتولى عادة، ضمير الغائب مهمة السرد ذي الصوت الواحد، فيما يغيب السرد الديالوجي المتعدد الأصوات. (حول المونولوجية والديالوجية يمكننا العودة إلى دور كل من ميخائيل باختين ولوسيان جولدمان وبيير زيما، انظر: كامل، ص183-184) لكنّ هذه التقنيات، هنا، تفسح المجال لعرض وجهات نظر متعددة بعيدا عن المباشرة، وتعمل على تمكين القارئ من مشاركة الشخصية المركزية/الطفل، مخاوفَها ومشاعرها وقلقها وطموحها وجرأتها أثناء عملية تعليق العلم على قمة عمود الكهرباء، وما يتخلل ذلك من مخاطر قد تودي بحياته، في مقابل تحقيق نصر أكبر؛ بقاء ِالعلم مرفرفا في الأعالي.
قام الكاتب بتوزيع قصته إلى ثلاث فقرات وفق إشارات زمنية: "صباح أحد الأيام"، "الساعة الثامنة مساء"، "صباح اليوم التالي" مع بداية كل فقرة بهدف الحفاظ على مبنى ذهني سليم، من ناحية، فلا يتوه المتلقي في خضم الأحداث، من ناحية ثانية. كنت أتمنى على الكاتب ألا يلجأ إلى هذه التقنيّة لأنها تمس بعصب المبنى الفني للقصة التي نجحت في ملامسة عواطف القراء عبر أسلوب تيار الوعي، فكانت الإشارة إلى الزمن أقل فنية من تلك التقنيّات.
يميل وجيه ضاهر، كما أسلفنا، إلى الكتابة المغايرة غير المألوفة، فما يحدث على الأرض غير مألوف وغير طبيعي لدى من يعيش حياة طبيعية. يتابع في قصصه التركيز على الذهن وطرح صور ومشاهد تميل إلى التجريد كما في قصة "الشهادات لم تعد تحتمل ظلمة الأدراج". يبدأ القصة بقطعة أطلق عليها "المدخل" وهي عبارة عن "النص الموجود على أحد الأجداث في غزة الفوقا"، فيه حزن وأسى يلخصان المفارقة التي يعيشها ابن غزة الذي يعمل في داخل إسرائيل، ويقوم ببناء بيوتها ليكون مصيره الموت.
يقسم الكاتب قصته إلى مقطوعات قصيرة، كل مقطوعة عبارة عن فكرة أشبه بكتابة خاطرة تبدو للقارئ، في قراءتها الأولى منفصلة تماما عن بعضها، لكن بعد الدخول في التفاصيل، وإعادة القراءة من جديد يجد المتلقي أن هناك خيطا متينا ذهنيا يربُط بين المقطوعات، رغم الرابط الواهي زمنيا. لم يدخل في خلدي أثناء محاولة فك أسرار النص وتحليله سوى أن الحياة مترابطة بقدر ما هي مفككة، وثمينة بقدر ما هي رخيصة، وجميلة بقدر ما هي بشعة. هذه المفارقات الحياتية وجدَتْ لها ترجمة في هذه القصة؛ في مبناها وفي مضمونها، تماما كما في الجملة التالية: "الاستعداد للموت يجب أن يكون كالاستعداد لكل شيء مهم". (ص35)
يرى الكاتب أن الوصف الخارجي لا يفي بالغرض، ولا يستطيع أن يعكس صورة المعاناة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، فما يتعرضون له من ألم نفسي، ومن عذاب يفوق ما تراه العين بكثير. تتحرك الشخصيات في شبه فراغ، في كثير من الأحيان، وكأنّ المكان قد فقد معالمه رغم وجوده، فلا نكاد نراه، ولا نلمس معالمه، اللهم إلا رائحة الموت. أما أكثر المشاهد التي تتحرك أمام المتلقي فهي كوابيس تعيشها الشخصيات في الحلم وفي اليقظة.
ما كانت لتتحقق عملية التكثيف لولا اعتماد هذه القصة على الذهنية وعلى الفلاش باك والتصوير السريع لأحداث تراكمت، فوق بعضها، كما تراكمت جثث القتلى إثر مجزرة راح ضحيتها عمال فلسطينيون يخرجون قبل بزوغ الفجر للبحث عن لقمة الخبز، فسار السرد سريعا وكثيفا بين الوعي واللاوعي، بين الضياع والصحوة وبين الإدراك والهلوسة. فتكونت لدى القارئ صورة مرعبة تهزه من الأعماق حتى ليشعر أن ما يسرد هو محض واقع لا دور للتخييل فيه، لدرجة تجعله يتمنى أن تتوقف "المشاهد" المؤلمة كي يستعيد قدرته على التنفس والخروج من أجواء القصة.
واقع أم فانتازيا؟
لا يكتفي وجيه ضاهر بتوظيف أساليب وتقنيات تيار الوعي، فنراه يميل إلى الفانتازيا والواقعية السحرية (انظر: انجيلا بيلي) كما ينعكس في قصة "القرنفلة البيضاء". يقع القارئ على صور ومشاهد أشبه بالرسم التجريدي. أنا لست خبيرا بالرسم التجريدي، ولا بفن التصوير، من كان خبيرا بهذين الفنين فسيجد مادة دسمة للتعامل معهما.
يتوه القارئ أمام كثافة المشاهد والصور والحوارات القصيرة الذهنية، ويدخل في مواجهة مباشرة مع السرد منذ السطر الأول منه، هي مواجهة شبيهة بالصدمة تحتاج إلى بعض الوقت لاستيعابها كي يتمكن من متابعة القراءة. تسرد الشخصية المركزية، الزوجة "ثريا"، أحداثا عجائبية غرائبية تدعو المتلقي إلى التفكير والتحليل في محاولة منه لإدراك ما يدور، فتختلط عليه الأمور، لكن الأمر اللافت أنّ المتلقي يتابع القراءة لربط الخيوط، يدرك بعضَ التحركات والإشارات، وقد يعتقد أنه نجح في التقاط بعضها، ويقف عاجزا عن بعضها الآخر، لكنه لا يشعر بالملل. فهل يمكننا أن نتفق مع رولان بارت فيما ذهب إليه في دراسته "لذة النص"؟ (انظر: بارت، لذة النص)
إن مثل هذه القراءة أقرب إلى عناء القراءة منها إلى اللذة، ومع ذلك نتابع القراءة لنلتقي بما يشبه الرؤيا. في خضم القراءة حاولت أن أجد الخيط الذي يربط بين الأحداث والعنوان وأسماء الشخصيات، في محاولة لفك الرموز والدلالات. فالعنوان، عادة، يحمل ملخص الأحداث ورسالتها وقد يتضمن إشارة إلى معنى النص ودلالته، فالقرنفلة البيضاء في إيحائها المباشر تحمل دلالة جميلة في لونها وشكلها ورائحتها، و"ثريا" الشخصية المركزية، هي مصدر النور والإشعاع، وهي الشخصية الوحيدة التي أعطاها الكاتب اسما، ما دفعني إلى البحث عن سر اختيار هذا الاسم بالذات. أما بقية الشخصيات فلم تنل أي اسم، واكتفى الكاتب باختيار كنية تتناسب مع صورتها الخارجية: "الذي وجهه مغطى"، "الذي على وجهه شامة "، و"القصير"، أو عُرفت وفق موقعها من الشخصية المركزية، مثل "الزوج"، "البنات"، "الأبناء" و"النائحات". فهل تأثّر وجيه ضاهر بكافكا؟
إننا نميل إلى الاعتقاد أن ضاهر يذهب إلى التعميم، ليجعل من الشخصيات رموزا تشير إلى العام لا إلى الخاص، فحكاية هذه المرأة وهذا الزوج هي حكاية كثيرين من أبناء هذا الشعب. مثل هذه الكتابات تؤكد أكثر من غيرها على ضرورة قراءة النص أكثر من مرة لعل القارئ يتمكّن من لملمة الخيوط، وتحليل الأحداث وربطها ببعضها. فكل قراءة جديدة تكشف سرا جديدا من أسرار الكتابة لم يكتشف من قبل. ولتيسير ما سنقوله بصدد هذه القصة نقتبس افتتاحيتها: "وضعوا على جسدي قرنفلة بيضاء وغطوه بثوب من الكتان خفيف، وأتى زوجي وخاطبني: يا ثريا قد كنت أمّا لنا كلنا، وكنتِ لي إلفا، يا ثريا إن أولادك الرضّع سيفتقدونك فلا تكوني، وتمتد أيديهم لتمسك بحلمتيك فلا يمسكون إلا الوهم، يا ثريا لولا احتياج الرضّع إلى صدر ينطوون عليه لاصطحبتك في لحظات سكونك كما اصطحبتك في لحظات اضطرابك." (ص20)
تتابع الشخصية المركزية في سرد الأحداث، وتأخذنا معها إلى عوالم عجيبة غريبة، بين الحياة والموت، حيث بكاء الصغار والنائحات على الأم "ثريا"، التي تتابع هي ذاتها في نشر تفاصيل ما تمرّ به. نتوقف معها لنطّلع على مشاهد لا تمتّ إلى الواقع بصلة. يتساءل المتلقي هل نحن أمام مشاهد حقيقية؟ أم هي هلوسات وكوابيس ورؤى ترويها لنا الشخصية المركزية؟ (يتبع)



.png)

.png)






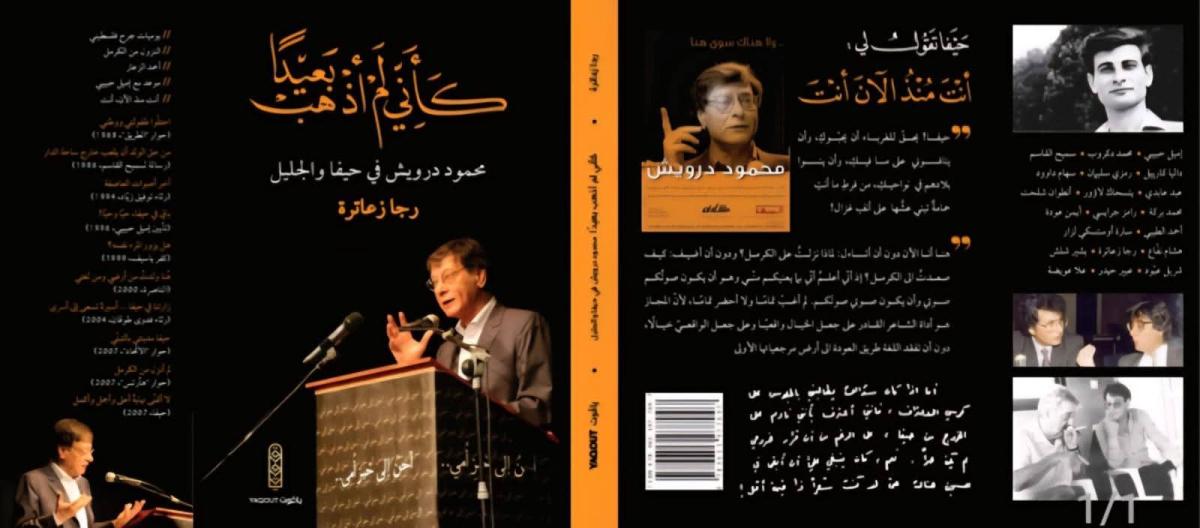
.png)

