قد يتساءل أحدهم، وبحق، هل رمى الكاتب إلى كل هذه المقاصد والغايات حين عمد إلى توظيف هذه الجملة؟ وهل كان يعي مرامي هذا التعبير؟ إنّ هذا هو دور المتلقّي، سواء قصد المبدع ذلك أم لم يقصد. ففي حال الكاتب محمد حمد، سواء نظرنا إليه كابن قرية، أو نظرنا إلى "الأنا الثانية" له، كما يسميها وين بوث، (انظر: وين بوث، ص83-84.) ففي كلتا الحالتين هناك بيئة وهناك زمان يساهمان في خلق عالم تخييليّ منتزع من الواقع أو قريب منه، ف"الأنا الثانية" ليست منفصلة كليا عن الكاتب الحقيقي، و"من الواضح أنّ الصورة التي يحصل عليها القارئ عن حضور الشخصية الثانية للمؤلف هي واحدة من أهم المؤثّرات التي يسوقها المؤلَّف. فمهما حاول أن يكون لا ذاتيا فإنّ قارئه لا بدّ أن يُشكّل صورة عن المؤلف الرسمي [أو المؤلف الثاني أو الضمني] الذي يكتب بمثل هذه الطريقة – وبالطبع فإنّ هذا المؤلف الرسمي سوف لا يكون حياديا في جميع القيم". (انظر: ن. م.، ص84)
لم ترد هذه الجملة في هذا السياق بمعزل عما جاء في مجمل النصّ، فالقصة مرسومة منذ السطر الأول منها كي تصل إلى هذه النتيجة، فالتحمت اللغة بأهلها وناطقيها. فإن كان الأديب الياس خوري يراها لغة إنتاج فإنّ ذلك، برأينا، لا ينفي أنّها لغة إيصال، لكنّ النظر من زاوية الإيصال فقط يجعلها لغة إخباريّة، لا لغة إبداعيّة. وفي هذه الحالة فإنّ لغة الإنتاج هي لغة إبداع، والإبداع هو في اختيار جمل ومفردات، دون غيرها، تخض القارئ وتهزّه، حتى لو كان قارئا عاديّا لا يملك أدوات التحليل الأدبيّ، لمعالجة "أخذتها" في بعدها السوسيولوجي.
إنّ رؤية أدبنا من منظور سوسيولوجيا الأدب لقادر على معاينة اللغة، في أبعادها الفكريّة والاجتماعيّة والثقافيّة. وهو ما يعيدنا إلى جملتين وردتا في القصة: يقول الأخ الأكبر سنّاً، الذي حضر مع من حضر عملية "طهور" محمود الذي كان يصيح مستنجدا مستغيثا: "ولك بهمش، سمعت إمي بتقول هيك أحسن للعروس"، ولم يقل أبي. أما الجملة الثانية فقد جاءت على لسان المطهِّر يردّ على تخوُّف والد محمود الذي شاهد الجرح والدم النازف، فأجاب: "ولا تهتم، بكرة بتطيب لحالها من بوله".
جاءت هذه النهاية لتناقض كل ما جاء في مستهلّ القصة، عن "محمود الكبش"، وقوته الجسدية. فالكبش، هو فحل الضأن، القادر على معاشرة كل إناث القطيع، كما هو في المفهوم الفلاحيّ، يفشل عند التجربة الأولى. وأما صورة محمود التي تحمل كلّ مواصفات الرجولة الفلاحيّة القرويّة، شكلا وفعلا فقد تكسّرت وتهشّمت. فكانت النهاية مناقضة لكل التوقعات، وتحوّلت دلالة كلمة "كبش" من معناها "الفحوليّ" إلى "كبش فداء" يُقدَّم ضحيّةً على مائدة المجتمع يتناوشون "فعلته" بالألسن، ويُعاقب على ذنب اقترفه غيره. وما "غيره" في هذه الحالة سوى أبيه وأمه ومجتمعه، الذي يقبع تحت كارثة الجهل.
تنسجم هذه الخاتمة انسجاما تاما، مع كل عناصر القصّة ومركبّاتها: اللغة بسردها ووصفها، والمكان بكل عناصره، والشخصيات بكل مواصفاتها، التي قد تمّ تأثيثها وتجهيزها لهذه الخاتمة بالذات. يبدو لنا جليا أنّ الكاتب محمد حمد متأثّر جدا من تجربته في النقد والبحث، إذ إنّ هذه التجربة تعني أنّ المنهجيّة تفرض ذاتها على الكتابة الصارمة في شكلها ومبناها. فما جاء في الأسطر الأولى من القصّة يرتبط ارتباطا فكريّا وبنائيّا وسيميائيّا مع خاتمة القصة، يكمل أحدهما الآخر في انكشاف صورة البطل بشكل مغاير عما جاء في المقدمة، وانتهى كل شيء على "فاشوش".
جاءت هذه القصة لتخلخل بعض المفاهيم الاجتماعية، ومن ضمنها مفهوم الرجولة في علاقتها بالأنوثة، فلو قمنا بدراسة الملفوظات "الجنسيّة" و"الشعوريّة" المتداولة لدى شعوب عدة لتمكنّا من كشف أنماط التفكير في مفاهيم الحياة والجنس والتكاثر والإنجاب ودوافعها. علمتنا السميولوجيا ألّا ننظر إلى حدث ما، أو صورة ما، أو قصّة ما نظرة مباشرة، بل النظر باتجاه الدلالات ووظائفها وأبعادها.
ورغم نفوري من عنوان القصّة إلا أنه مرعب ومخيف ومستفز، ويصبح مقلقا ومحفّزا على فعل التغيير وإعادة النظر في مفهوم الرجولة والفحولة ليكون البديل بناء علاقة قائمة على الحب المتبادل وممارسة علاقة زوجيّة فيها طرفان متعادلان في مقابل "ها يما أخذتها". إن عطبا صغيرا في جسد هذا الرجل القويّ البنية سبّب له عقما ومنعه من متعة البنين التي ألمح إليها الراوي في الصفحة الثانية من القصة، وحوّل حياته إلى جحيم على الصعيدين النفسيّ والاجتماعيّ، خاصة وأنه كان ضحية مثل غيره من الضحايا.
//اللغة بين الإخباريّة والإبداعيّة
من أهم أسس نظرية الاستقبال أنّ النصّ لا يكشف ذاته إلا من خلال التفاعل بين المتلقّي وبنية لغة النص. (هذا القارئ هو القارئ النموذجي، حسب تعبير ألبرتو إيكو. "القارئ النموذجي") وبما أنّ للغة دورا هاما جدا في خلق هذا التواصل وهذا التفاعل، فعلى الكاتب تقع مَهمّة توظيف لغة غنيّة قادرة على التشخيص والإثارة والتأثير. فاللغة في العمل الأدبيّ، تؤدي وظيفة جمالية، لا إخباريّة تقريريّة، كما في حقول أخرى، ولها دور تأثيريّ في القارئ، لا مجرّد دور توصيليّ. (Wellek, Warren, pp. 22-23 للمزيد من التوسع انظر: ص20-37) لن ندخل في فلسفة الكاتب الحقيقيّ والكاتب الضمنيّ ولا القارئ الحقيقيّ والقارئ الضمنيّ، رغم أهمية هذه الجوانب، لكنّا نؤمن أن الكاتب الضمنيّ متواجد بشكل فعّال داخل النص تماما كما هو القارئ الضمنيّ، وينوب عنه في الخلق والإبداع وتنظيم الخطاب. (يقول شين دان إن أول من استعمل هذا الاصطلاح، "الكاتب الضمني"، هو الكاتب البريطاني وين بوث في كتابه The Rhetoric Fiction (1961) انظر: Shen, Dan., vol.45, no. 1 Spring (2011), p. 80) فهل تمكنت اللغة من تجنيد القارئ وخلق حالة من التفاعل؟
إن دراسة اللغة الروائيّة تختلف عن دراستها في القصة القصيرة، رغم التشابه الكبير بينهما، حيث إنّ اتّساع حيّز الرواية يتيح للمؤلِّف أن يوظّف مستويات لغوية متعدّدة، كما أنّ تعدّد الشّخصيّات يفسح المجال لتعدّد الأصوات واللغات. (باختين. الخطاب الروائي، ص73-98) وبالتالي فإن الدارس يتحرك في حقل واسع يتيح له التمييز بين مستويات لغويّة متعدّدة تتفاعل مع تعدّد الشخصيّات. نشير في هذا السياق إلى ندرة الدراسات التي تناولت لغة القصة العربية القصيرة وإلى قلة الأبحاث حول القصة العربية القصيرة مقارنة بالدراسات حول الرواية العربية. من أهم الدراسات التي تناولت مشروع القصة العربية نجدها في "وقائع ندوة مكناس" وهي مجموعة من المداخلات الهامة لعدد من الدارسين وأصحاب التجارب، (انصح بقراءة مداخلة الباحثة يمنى العيد، ومداخلة الباحث الروائي الياس خوري. انظر: دراسات في القصة القصيرة، ص21-66)
يوظّف الكاتب اللغة في مستوياتها المتعددة، يستهل الكتابة بلغة شعريّة، يُتبعها بلغة معياريّة، ثم بلغة شعبيّة؛ سواء كانت عاميّة، فصيحة، أو مزيجا منهما، أو مفصّحة. ثم يبعثر هذه المستويات اللغويّة دون التزام بترتيب معين، عدا الالتزام بالموقف الأدبيّ الذي يراعي الأبعاد الاجتماعيّة والفكريّة للشخصيّات وعلاقتها بالمكان والزمان.
- اللغة الشعرية
يستهل الراوي القصّ بالتعريف مباشرة بالشخصية المركزية دون أية مقدمات بلغة شعرية: "محمود الكبش في نخوته وقوّته، شاب أمضى من السيف إذا امتشق من غمده..." ثم يُتبع هذه الفقرة، مباشرة، بفقرة ثانية عمدتها الرئيسيّة اللغة الشعريّة في بعديها الاستعاريّ والتصويريّ: "الشيء المُميَّز عدا ذلك في شخصيته، هو سمرته المائلة إلى الخمرة، بحيث كنتَ ترى فيها ملامح شفق يتداخل في لحظات المغيب مع طلائع خيول الغسق. وفوق جبينه تطارد نسيمات المساء ذؤابتين شاردتين من شعره الجعد، من دون جدوى، وكأنّهما نقوش لضفائر على رأس فرعونيّ".
نميّز في النص أعلاه لغة القاصّ نفسه ينوب عنه بديله الراوي فجاءت، في مستواها اللفظيّ والتركيبيّ والوظيفيّ، لغةً شاعريّة مكثّفة. إنّه وصف برّانيّ لصورة البطل في المواجهة الأولى بين القارئ والنصّ، لكنّ القارئ سرعان ما يدرك البعد الوظيفيّ لهذا التوصيف البرانيّ الذي يؤدّي دورا جوّانيا واضحا. وكأنّي بالكاتب يعمد إلى الدمج، بشكل مقصود، بين التشبيهات الكلاسيكيّة المألوفة، كصورة السيف الذي يُمتشق من غمده، والصورة الرومانسيّة في "ترى فيها ملامح شفق..."، والصورة الفرعونيّة في "نقوش لضفائر على رأس فرعونيّ". إن هذا المزج بين الصور، من عوالم متعددة، في اجتماعها معا، تثير القارئ وتحثّه على معرفة هذا المخلوق "الأسطوريّ"، ومتابعة ما سيحدث له فيما بعد. وتكون المفاجأة في خاتمة القصّة، وفي مواجهة هذه اللغة الشعريّة المكثّفة مع الجملة التي ترد على لسان الأم "ها يما محمود أخذتها". فيحدث التصادم بين نقيضين لغويّين وموقفَين متنافرَين تلعب اللغة فيهما دورا مركزيّا، ويُبرز موقفين متنافرين لصوتين متناقضين هما صوت الراوي وصوت الأم وما يمثله كل من الصوتين.
تتكرّر هذه اللغة الشاعريّة في أكثر من موقع حين يكون السرد مباشرا على لسان الراوي المشرف الكلّيّ المعلّق، دون أن ترد على لسان شخصيات القصّة، سيّما وأنّها كلّها شخصيات شعبية قرويّة تقليديّة. ونراها حين يطلّ الراوي برأسه ليتلصّص على أفكار بعض الشخصيّات، وبالذات شخصيتي محمود ووردة. وبالرغم من أنّ هذه لغة الراوي إلا أنّه حرص على إبقائها تتحرك ضمن بيئتها: "كانت الليالي مسرحا لقوافل من الأفكار المسافرة في صحارى قلبه، تستوقفها واحات النظر إليها وهي تحمل الجرة، فتسقيه ارتواء إلى حد السراب من نيل همسة فجر على شفتيها، وكانت أحاديثه لنفسه أشبه بسهاد نجمة تنتظر القمر في ليلة محاق". إن هذه هي لغة الرومانسية الشرقية، وهي ليست ذاتها لغة الرومانسية الغربية، فكل لغة تنهل من معين بيئتها، فهنا صحراء شرقية، وقمر فلاحيّ، وصبيّة قرويّة تحمل جرّتها.
- اللغة المعيارية
يتحوّل الكاتب من اللغة الشاعريّة إلى اللغة المعياريّة حين ينتقل إلى محيط القرية وأبنائها، فتصبح لغة سرديّة مباشرة: "ثم يصل محمود إلى الحارة حيث جامع النبي لوط، فيقف هناك لبضع دقائق، وربّما خطر في باله هذا النبيّ، وقومه الشاذّين، وكيف أنّه تركهم وأتى، على مفخرة لأهل عيلوط، إلى هذا المكان، فشرب من العين التي سُمّيت على اسمه عين لوط...".
هذه اللغة المعياريّة لا تتوخّى التكثيف في الاستعارات، تصلح للسرد دون المبالغة في الانزياح، قادرة على التشخيص دون زركشة ولا تجعل المجاز عمدتها. (انظر: كامل، ص15) وهي تتغيّا نقل صورة للقارئ بكلمات قليلة، بهدف إضافة معلومة هنا، وأخرى هناك، تجعل صورة الشخصيّة المركزيّة أكثر وضوحا. فنعلم أنّ محمود الكبش ابن قرية عربيّة فلسطينيّة تعود زمنيا حوالي خمسة عقود إلى الخلف، لها معالمها الشكليّة وأسلوب حياتها الخاص. هذه اللغة بالذات هي ذات بعد ديناميكيّ تعمل على تحريك الأحداث والشخصيات في المكان والزمان. وقد تبيّن لنا، منذ الأسطر الأولى، أنّنا بإزاء راعٍ شابّ قويّ البنية ابن قرية عربيّة فلسطينيّة ما زال فيها "عجل شارد من القطيع"، و"صوصأ ابن يومين"، و"السدرة حيث البيادر ومركز البلد".
نعود لنؤكد مرة أخرى أن اللغة المعيارية تُطلّ برأسها هنا وهناك لنقْل الأحداث إلى نقطة جديدة، وموقف آخر ومكان آخر. إن هذا التنويع في المستوى اللغوي يبعد النص عن الرتابة التي تجعل القارئ ينفر فيما لو بقي النص يسير على وتيرة لغوية واحدة. ولذلك يلاحظ القارئ كيف ينتقل الراوي من السرد المباشر إلى الحوار بأنواعه المختلفة: المباشر، المونولوج، والمونولوج المروي، عبر مستويات لغوية متعدّدة.
- اللغة الشعبية
هناك عدة دراسات حول مستويات اللغة في الإبداع العربي، ولم تُذكر هناك "اللغة الشعبية" إلا بارتباطها بالفن الشعبي والفولكلور والتراث واللغة المحكية. هذا الربط باهت وغير واضح. لذلك قمت باستعمال هذا التعبير، هنا، لأني أراه ملائما جدا لجزء هام من الإبداع العربي الفلسطيني في مجالي القصة والرواية. أعلم جيدا أن هذه اللغة بحاجة إلى دراسات لسانية وصوتية جدّيّة، وما استعمالي لها إلا من باب القناعة بوجود لغة شعبية، كما توجد لغة برجوازية ورأسمالية، ولغة فئات اجتماعية عدة.
وهي لغة تصوّر حدثا يدور في أجواء شعبيّة، تعكس بيئة عامة الناس، وتتناسب مع أحوالهم الشخصية، وتجربتهم الحياتية اليومية، بعيداً عن الاستعارات والكنايات الفصيحة المعهودة، وإن تواجدت المحسنات المعنوية فهي منبثقة من البيئة الشعبيّة ومتأثرة بها. هي لغة تصور الحدث عاريا كما هو في بعده الشعبيّ، وقد تتخلّلها تعابير ومفردات عامية، أو لغة عامية محضة، وقد تكون ترجمة مباشرة عن العامية (المفصّحة). وبما أن أحداث الرواية تدور في فضاء قرويّ تقليديّ، فمن الطبيعي أن تعكس اللغة هذا المحيط بكل مركباته، نسوق منها الأمثلة التالية:
- ولحقه مجموعة من شباب القرية الذين تمّ ختانهم بالتأكيد في جولات سابقة [...] واقتادوه أسيرا مكبّلا بعد معركة حامية من العضّ والقرص والخرمشة، ومحاولات الإفلات، والشتائم والمسبات (اللي من قاع الدست، واللي من الزنار وتحت)".
- "قلتلِّك مية مرة هاي الحفّاي بتمزلط، بدكيش تشتري لي حفاي؟ تفضّلي هيّاني اتزحلقت وانكسرت الجرة، وألله ستر ما حداش شاف، وِاللا كان بنات الحارة عملوني جريدة".
- في الحقيقة لم يكن محمود الكبش يريد من كل طلعاته ونزلاته التي يقوم بها يوميا أكثر من أن ينظر إلى وردة وهي تعطيه ظهرها...".
إنّ دراسة اللغة قد تعدّت، منذ زمن بعيد قضيّة المحكيّة والفصحى وبات التركيز ينصبّ أكثر حول دلالة اللغة في أبعادها الاجتماعيّة والثقافيّة وارتباطها بالشخصيّات وبيئتها، ودورها الوظيفيّ في المبنى العام للنصّ. وقد كان للمُنظِّر الروسي ميخائيل باختين الدور الأكبر في دراسة مستويات اللغة داخل الرواية. (لحمداني، ص73) واللغة أهم ما تنهض عليها الرواية، فالشخصيّة تستعمل اللغة، أو توصف بها، أو تصف هي بها، ولا وجود للعناصر الروائيّة بدونها. (مرتاض، ص125) ويرى إدوارد سابير "أن الكلام فعالية إنسانية تختلف بلا حدود من طائفة اجتماعية إلى طائفة اجتماعية أخرى، لأنه الموروث التاريخي للطائفة ونتاج الاستعمال الاجتماعي الطويل المدى". (سابير، ص8)
فلو نظرنا إلى مجمل الأمثلة أعلاه نظرة سوسيولغوية لوجدنا مدى التصاقها بالشخصيات وفضائها الزمكاني. ففي المثال الأول هناك مزيج من اللغة المعياريّة والعامية. يمثّل هذا المزيج، في بُعده القرويّ العام، صوتَ الناس لا صوت الراوي. وفي المثال الثاني حيث اللغة المحكيّة فهو كشف واضح لصوت وردة بما فيه من تحايل على الوالدة، يحمل نبرة "دلع" بنت وحيدة لوالديها تتظاهر بالبراءة، ويشير إلى انتشار النميمة بين أبناء القرية (واللا كان عملوني جريدة). وأما اللغة في المثال الثالث فتبدو للمتلقي في المواجهة الأولى لغة معيارية توصيلية، لكننا لو أعدنا النظر لوجدناها تكاد تكون ترجمة عن اللغة المحكية، وبالذات في "طلعاته" و"نزلاته"، و"تعطيه ظهرها"، وإمكانية قراءتها فصيحة وعامية. لكنّ القارئ المتأنّي يلاحظ اقترابها من العامية أكثر من قربها من الفصيحة خاصة وأن كلمتي "طلعاته" ونزلاته" تكررتا عدة مرات في سياق السرد الشعبي.
يستطيع القارئ أن يميز في القصة بين لغتين رئيسيتين تمثّلان صوتين مختلفين هما: صوت الراوي ودوره الإرشادي، وصوت بقية أبناء القرية، الذين بدوا في القصة شريحة واحدة غير منفصلة، تحمل نفس الفكر ونفس الرؤية. أما ما أسميناها باللغة الشعبية فما هي إلا تأكيد على هويّة أبناء القرية في اجتماعهم حول نفس الآراء. أما صوت محمود فبقي مكبوتا لم تصل صرخته أبعد من حنجرته.
//أنا والنص والمؤلف
أولت نظريّات التلقّي الأهميّة الرئيسيّة للقارئ في تأويل النصّ، كما أسلفنا أعلاه، وكُتبت الكثير من الدراسات حول التلقّي، والاستقبال والاستجابة. نترك الحديث المسهب عنها والتعرف عليها للقراء، بالعودة إلى كتابات ياوس وإيزر ومدرسة كونستانس وأمبرتو إيكو وآخرين. يقف القارئ في مركز هذه الرؤية من خلال دوره في التواصل مع النص وما يحدث من تفاعل وتأثير وتأثّر متبادل. وميّز المنظرون بين القارئ الحقيقي والضمني والقارئ النموذجي أو السوبر الذي يمتاز عن غيره بتجاربه وسعة معلوماته.
يعتبر إيزر من أهم دارسي آلية إنتاج معنى العمل الأدبي، وهو بدوره يوجه نقدا لاذعا للنظريات التقليدية التي لم تول القارئ الدور الأهم في عملية التأويل، فالنص، وفق رؤيته، موجه إليه فهو "مخاطَب النص... وأنّ النص ليس في وسعه أن يمتلك المعنى إلا إذا قرئ". (إيزر، ص11) إذاً، حسب رأيه، "هناك شيء واحد واضح هو أنّ القراءة هي شرط مسبق ضروري لجميع عمليات التأويل الأدبي... وأنّ من المفيد أن نفكّر في ماذا يحدث عندما نفعل ذلك". (ن. م) ويضيف "إنّ الشيء الأساسي في قراءة كل عمل أدبي هو التفاعل بين بنيته ومتلقيه...وأنّ دراسة العمل الأدبي يجب أن تهتم، ليس فقط بالنص الفعليّ بل كذلك وبنفس الدرجة بالأفعال المرتبطة بالتجاوب مع ذلك النص". (ن. م.، ص12) للعمل الأدبي، برأيه، قطبان: "القطب الفنيّ والقطب الجماليّ، الأول هو نصّ المؤلِّف، والثاني هو التحقّق الذي ينجزه القارئ... يجب حتما أن يكون العمل الأدبي فاعلا في طبيعته ما دام لا يمكن اختزاله لا إلى واقع النصّ ولا إلى ذاتية القارئ. وهو يستمد حيويته من هذه الفعالية". (ن. م)
يرى أرباب هذه النظريات أنّ النصّ لا يفصح عن ذاته من القراءة الأولى، إذ يقوم المتلقّي بقراءة النصّ قراءة أولى، دون تحليل أو تأويل، فتحدث عملية التعارف، كما يحدث ذلك بين غريبين يلتقيان لأول مرة. يعتبر هذا اللقاء، في نظرهم، لقاء إيجابيا أوّليا يسفر عن تفاعل بين القارئ والنص. تتبع ذلك عدة قراءات، تكشف كل قراءة طبقة معينة من النصّ. لكن ليس كل قارئ بقادر على القيام بهذه العملية، فالنص بحاجة إلى قارئ حاذق، أسموه السوبر أو النموذجي. كيف يتم اللقاء بين القارئ والنص؟ فهل سيكون اللقاء مجرد لقاء عابر؟ أم سيكون لقاء غنيا يحمل المفاجآت؟ وهل القراءات المتكررة تكشف النص وتضيء خفاياه؟ سأحاول الإجابة على هذه الأسئلة بناء على تجربتي الخاصة مع هذه القصة.
وجدت نفسي، بعد القراءة الأولى، أمام قصة حزينة ومؤلمة لشاب قرويّ يعمل راعيا تحطّمت أحلامه، كما تحطّمت معه أحلام الصبيّة التي بادلته الحبّ، وذلك نتيجة خطأ ارتكبه المطهّر، حين كان طفلا، ونتيجة جهل والديه ومجتمعه. كانت النهاية مفاجئة جدا، خاصة وأنّ الراوي قد مدّ القارئ بمعلومات تبرز القوة الجسديّة مقرونةً بشبق سوف يتحقّق مفعوله، بالذات، في الليلة الأولى. فتولّد غضب وحزن وأسى، وكأنّ القصّة قد حدثت فعلا في القرية في يوم ما قبل فترة زمنية بعيدة.
أما في القراءة الثانية فقد تكشّف الجانب الخياليّ في القصة، من خلال تحديد معالم المكان، وصورته الخارجية، بكامل تفاصيله، وكأنّ الكاتب يستحضر بعضا من وضعية آدم وحواء في الجنّة، بعد أن اكتشفا عورتيهما. وتبيّن أنّ هناك جوانب جنسيّة يحاول الكاتب أن يتعامل معها بحذر شديد من خلال وصف صورة البطلين، وبالذات في التركيز على إبراز ملامح الصبيّة المغرية، في تحركات جسدها من الخلف، والدخول في بعض المشاعر الداخليّة التي تشي بانجذاب الواحد منهما تجاه الآخر. وثارت لدي بعض التساؤلات حول العلاقة بين المكان وبين تحرّكات الشخصيّة المركزيّة، وحول الصور الحميمة بين العاشقين في انجذابهما الجسديّ، دون إحساس بالجانب الروحيّ.
أما في القراءات التالية فقد اتّسعت رقعة القصّة، وتجلّت معالم الشخصيّة بشكل أوضح، وتكشّفت العلاقات بين مركبّات القصّة، وكثرت التساؤلات التي تفرض على القارئ أن يجد لها إجابات شافية. وهي تساؤلات عديدة تخصّ أسباب كتابة القصّة، ودوافع هذا المبنى، وعلاقة المبنى بالشخصيات، وبالمكان والزمان. وتبيّن أنّ إبراز الملامح الجسدية لكلا البطلين جاء خدمة لما سيتلو من أحداث: تهشُّم المشهد الذكوري الفحوليّ كليا عند لقاء الجسدين الأول، وتحطُّم صورة الرّجولة في مفهومها التقليديّ. نتيجة ذلك يزداد التماهي مع محمود الكبش، خاصّة وأنّ الكبش قد تحوّل إلى مجرّد خروف ضعيف، ووردة تحوّلت من وردة متفتّحة إلى وردة ذابلة لم تقطف في تلك الليلة، كما تقطف الوردة الناضجة. وانجلت بعض أبعاد القصة، وتصارعت في الذهن أفكار عدّة حول النهاية وعلاقتها بالبداية، وحول الجنس في مفهومه العربيّ القرويّ التقليديّ. ووجدت نفسي أبحث عمّا هو أبعد من الحدث نفسه، وعما هو أبعد من قصة حب تجمع بين شابين، وسارت الأفكار باتجاه معتقدات مجتمع كامل آيل للضياع نتيجة تمسّكه بالقديم دون الجديد.
أما اللغة فلم تنجل مستوياتها المتعدّدة إلا أثناء عملية التحليل والتأويل، وكأنّ القصّة عبارة عن شكل كرويّ ملفوف بأغلفة عديدة، وكل غلاف تتمّ إزالته يكشف سطحا جديدا للغة، ودورا دلاليا لا يمكن إدراكه في القراءات السابقة. رافقني شعور بالتعب ممزوجا بلذة الاكتشاف وأنا أغور في النص، فتتكشّف دلالاته وأبعاد اللغة في مستوياتها المتعددة، وسرّ بعض الألفاظ وربطها مع محيطها وبيئتها. ووجدت نفسي أبحث عن الفرق المعنويّ بينها وبين ملفوظات أخرى في لغات أخرى، لا أعتقد أن الكاتب قد قصدها أو لمّح إليها مجرد تلميح، وبالذات في الفرق بين مفهوم العلاقة الزوجيّة بين شعوب مختلفة وحضارات متعددة، وكانت جملة "ها يما محمود أخذتها" تلحّ أكثر للقيام بمقارنتها مع مفهوم العلاقة الجنسيّة مع الغرب. (يتبع)



.png)

.png)






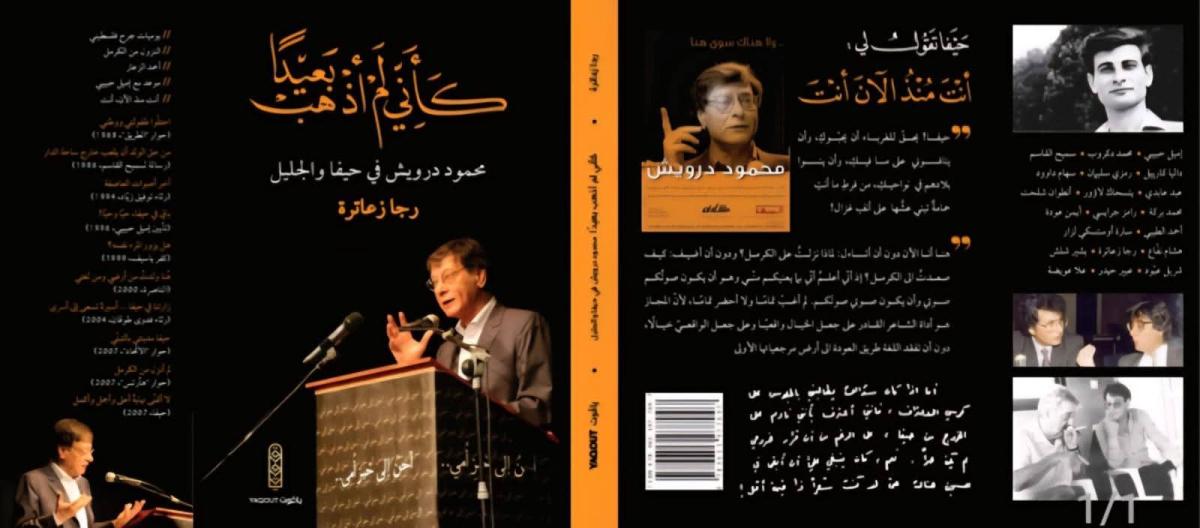
.png)

